دراسة تحليلية لأثر تبني السياسية الاقتصادية والاجتماعية
للاستراتيجيات التنموية في تخفيض معدلات البطالة لدى
الخريجين من الجامعات في الفترة الممتدة (1995-2017)
أ. ربيعي سلاف أ.أحسن صليحة
جامعة الجزائر 3. جامعة محمد بوضياف_ المسيلة
الملخص:
تهدف الدراسة إلى تحليل الواقع التجريبي للاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية كخيار للحد مع القضاء على مشكلة البطالة لدى الخريجين من مختلف الجامعات في الجزائر وهذا خلال دراسة مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ستظهر لنا الصورة الحقيقية ومصداقية هذه الاستراتيجيات التنموية المطبقة.توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن البرامج التنموية قد حققت أهدافها إلى حد بعيد لكن خلقت اللاتوازن بين مناصب العمل المؤقتة والدائمة التي تمتص البطالة بالإضافة إلى التفاوت ما بين القطاعات وكذا التنوع والقلة في النشاطات بالنسبة للولايات.
الكلمات المفتاحية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية ، استراتيجيات تنموية، الخريجين، مناصب عمل، تنمية اقتصادية .
Abstract:
The study aims to analyze the experimental reality of the development strategies adopted by the economic and social policy as an option to reduce the elimination of the problem of unemployment among graduates from different universities in Algeria. This is the study of the various macroeconomic indicators that will show us the real picture and the credibility of these development strategies. The study found a number of results, the most important of which are: Development programs have achieved their objectives to a large extent, but have created a balance between temporary and permanent jobs that absorb unemployment in addition to the disparity between the sectors as well as the diversity and few activities for the states.
Keywords: Economic and Social Policy, Development Strategies, Graduates, Employment, Economic Development.
المقدمة:
يعتبر تخفيض معدلات البطالة لدى فئة الخريجين من مختلف المعاهد و الجامعات أكبر التحديات للاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية الكلية بمختلف ميدانها وذلك لتسجيل معدلات البطالة معتبرة في الجزائر خاصة بالنسبة للخريجين مقارنة بالدول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن قوة العمل تنمو بمعدل ضئيل، هذا ما يستدعي دق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ الوضع، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وناجعة لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر ،خاصة وأن البطالة تتركز بين الخريجين والباحثين عن عمل لأول مرة الذي يترتب عنه متداعيات اجتماعية كالفقر، الانحرافات والآفات الاجتماعية.
تعتبر الحلول المقترحة من طرف الدولة الجزائرية تسطير عدة برامج اجتماعية اقتصادية طويلة المدى وليست مؤقتة من أجل امتصاص هذه الظاهرة حيث تتطلب مبالغ مالية ضخمة في إطار مخططات الخماسية المتبناة، لإيجاد حل حاسم لمشكلة البطالة.
إن صياغة حزمة من البرامج الاجتماعية الاقتصادية النشطة يتم صياغتها في إطار برنامج شامل له أهداف قابلة للقياس باعتبارها قضية مجتمعية ينبغي مشاركة جميع الأطراف فيها (أصحاب الأعمال-البطالين-القطاع العائلي والمجتمع المدني).
إشكالية الدراسة: من خلال هذا الطرح يمكننا صياغة إشكالية الورقة البحثية والمتمثلة فيما يلي:
إلى أي مدى ساهمت الاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تخفيض معدلات البطالة لدى الخريجين من الجامعات في مختلف الاختصاصات؟
أهداف الدراسة: تهدف إلى التطرق إلى الاستراتيجيات التنموية المتبناة، وبيان أهميتها وواقعها الحالي في التخفيض من معدلات البطالة لدى خرجي الجامعات و المعاهد الوطنية خلال فترة الدراسة.
فرضيات الدراسة: تنطلق الدراسة من فرضية أساسية هي:
- تساهم البرامج الاستراتيجية التنموية المسطرة في الجزائر لتخفيض البطالة لدى الخريجين لتحقيق تنمية مستدامة بمختلف مستوياتها( الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية).
أهمية الدراسة: تأتي أهمية هذه الورقة البحثية على التركيز على واقع تطبيق الاستراتيجيات التنموية المسطرة للخرجين و فعاليتها في تخفيض معدلات البطالة و على أهم العوائق التي تقف حائلا من أجل تطبيق و فعالية هذه الاستراتيجيات التنموية وذلك من خلال بالتخطيط الجيد ودراسة ملاءمة لواقع الشغل التي تلائم الاقتصاد و المجتمع الجزائري.
منهجية الدراسة: تم اعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لمعرفة ولدراسة واقع وأثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تخفيض البطالة لدى الخريجين من الجامعات.
محاور الدراسة: بناءا على ما تقدم سابقا، سيتم تقسيم محاور هذه الدراسة كالآتي:
- الاستراتيجيات التنموية كسياسة علاجية لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر.
- دراسة تحليلية لتقييم أثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر.
-
الاستراتيجيات التنموية كسياسة علاجية لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر:
-
مفاهيم نظرية أساسية:
- الإستراتيجية:
- لغة: كلمة مشتقة من اليونانية 'استراتيجوس': وتعني فن القيادة. كانت الإستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون إلى المهارة التي يمارسها كبار القادة، وقد استعملت في الميادين العسكرية، لذلك ارتبط مفهومها بتطور الحروب، ثم امتد ليكون قاسما مشتركا بين كل النشاطات في ميادين العلوم المختلفة. [1]
- اصطلاحا: هي مجموعة الأفكار والمبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات دلالة على وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات مساره، لغرض الوصول إلى أهداف محددة مرتبطة بالمستقبل. [2]
-
2.1.1. التنمية:
- لغة: التنمية من النمو: نمى الشيء تنمية، نما الشيء نماء ونموا، زاد وكثر.[3]
- اصطلاحا: قدمت الأمم المتحدة تعريف التنمية على أنها: العملية التي تستهدف الربط بين جهود الأفراد في المجتمع وجهود السلطات الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية وتمكنها من الإسهام الفعلي في التقدم القومي. [4]
عرفها « Arthur Dunhun »بأنها: أسلوب للعمل الاجتماعي، يركز أساسا على إحداث التغيير الاجتماعي المقصود، من خلال الإعداد والتنفيذ للمشاريع والبرامج كما يمكن إعطاؤها أشكالا عدة مثل اعتبارها:حركة، مدخلا، أداة، عملية أو طريقة.[5]
3.1.1. الاستراتيجيات التنموية:
تعبر عن فن استخدام موارد الدولة وإمكانياتها لتحقيق الأهداف العامة المسطرة لها، الرؤية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الشاملة القادرة على الارتقاء بعملية نشر القيم الحضارية.[6]
4.1.1. البطالة:
-لغة: جاء في لسان العرب: بطل الشيء، يبطل بطلا وبطلانا بمعنى ذهب ضياعا وخسرانا، فهو باطل.
التبطيل: فعل البطالة، وهو إتباع اللهو والجهالة، وبطل الأجير-بالفتح- يبطل بطالة وبطالة-بالكسر- أي تعطل فهو بطال، والبطال الذي لا يد عملا. [7]
- اصطلاحا: عدد الأشخاص القادرين على العمل ولا يعملون، بالرغم أنهم يبحثون عن عمل بشكل جدي. [8]
تعرف منظمة العمل الدولية العاطلين عن العمل بأنهم: أفراد قوة العمل الراغبين في العمل وفق الأجور السائدة، والباحثين عنه والذين لا يجدونه.[9]
تعبر عن: كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. [10]
كما عرفتها منظمة العمل الدولية بأنها: لفظ يشمل كل الأشخاص العاطلين عن العمل رغم استعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص، وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج. [11]
5.1.1.الخريجون من المعاهد والجامعات:
- الشباب: يرى علماء الاجتماع أن الشباب هم: كل من يدخل في فئة السن من 15 إلى 25 إن أولئك قد تم نموهم الفسيولوجي أو العضوي، بينما لم يكتمل نموهم النفسي والعقلي اكتمالا تاما بعد، بالتالي فهم في مرحلة وسط بين الطفولة والرجولة الكاملة وتحدد الفئة العمرية للشباب ما بين 15 حتى 40 سنة.[12]
- الخريج: طالب جزائري أمضى بنجاح على الأقل 03 سنوات في منظومة التعليم العالي.
- الليسانس: درجة علمية للشهادة الجامعية الأولى وتُمنح بعد إتمام 03 سنوات من الدارسة في الجامعة.
- مؤسسات التعليم العالي: هي مؤسسات تتولى شؤون التعليم العالي.[13]
- جودة التعليم العالي: عملية التعليم القائمة على معايير محددة عالمية أو محلية معتمدة.
- معايير التعليم العالي: السقف الأعلى للممارسات التعليمية المتوقعة من شخص أو مؤسسة تمارس التعليم العالي و تنقسم إلى: معايير محتوى ومعايير تقييم ومعايير الممارسات المهنية.
- سوق العمل: المجالالذييجدفيهالخريجأوالعاملفرصةعمل،وقديكونمحلياأوإقليمياأودوليا.
2.1. أهم الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الجزائر لتخفيض من معدلات البطالة:
بدأت مشكلة البطالة تتفاقم منذ 1985م، وهذا نتيجة الانكماش الاقتصادي وقلة الموارد المالية للدولة، الأمر الذي أدى إلى تقلص الاستثمارات الخالقة لمناصب العمل، وبالتالي الاختلال في سوق العمل بين عارضيه وطالبيه.[14]
بعد المعطيات الأولى التي قدمها الإحصاء العام للسكن والإسكان سنة 1987، ظهر أن نسبة البطالة تقارب 21.5%، يغطي منها طالبي العمل من الخريجين الذين يبحثون عن أول منصب عمل والذي يقل عمره عن 30سنة أي 75.5 %، وبناء على هذه النتائج، تم لأول مرة سنة 1988 إدراج مسألة تشغيل الخريجين كإحدى الانشغالات الأولوية للسلطات العمومية، ولمواجهة تدهور سوق الشغل أنشأت السلطات العمومية أجهزة جديدة لاحتواء الأزمة.[15]
يمكن تقسيمها إلى صنفين أساسيين:
- النشاطات التابعة للشبكة الاجتماعية والتشغيل التضامني: والتي تضم الأشغال ذات المنفعة العامة، الوظائف المأجورة بمبادرة محلية، التأمين على البطالة وعقود ما قبل التشغيل.
- الإجراءات الخاصة بالاستثمار: تهدف إلى ترقية الاستثمار والمحافظة على الشغل، والتي تضم القرض المصغر، المؤسسة المصغرة، مراكز دعم النشاط الحر وإعانة المؤسسات التي تواجه صعوبات. [16]
-
-
- الوظائف المأجورة بمبادرة محلية:
منذ سنة 1990، تبنت الحكومة برنامجا خاصا للتخفيف من حدة البطالة التي ورث عن نظام سابق له يسمى الإدماج المهني لسنة 1990، والهـدف منــه هو توفير منصب مؤقت للشاب العاطل، وذلك من خلال إنشاء صيغة جديدة لإدماج الخريجين من الجامعات في الحياة المهنية، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وظائف شغل مأجورة بمبادرة محلية لدى المؤسسات أو الإدارات المحلية، ثم تتولى الجماعات المحلية توظيف هؤلاء الخريجين على أن تتلقى الاعانة المالية من الصندوق الخاص بالمساعدة على تشغيل لمدة تتراوح من 3 إلى 12 شهرا، والذي سمح بتوظيف 72.500 خريج في سنة 2004، إلا أن الوظائف المنشأة مؤقتة وتتركز في مجملها في القطاع الخدمي.
-
-
- الصندوق الوطني للتأمين من البطالة:
يعمل هذا الجهاز على إعادة إدماج العاطلين عن العمل والحفاظ على الشغل، وقد سمح بالاحتفاظ بـ:1.837 منصب شغل، وفي سنة 2004 كرس هذا الجهاز إمكانية تمويل أنشطة العاطلين عن العمل الذين يتراوح سنهم من 35 إلى 50 سنة، والذي سمح بالمصادقة على 20.642 ملف، هدفه حماية العمـال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقتة قدرها ثلاث سنوات، ناهيك عن اعتماد فكرة خلق المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي وضعـت خصيصا لدعم فئة الخريجين الراغبين في إنشاء مؤسسات (المقاولة) وكذا العمال الذين تعرضوا لتسريح لأسباب اقتصادية.
-
-
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
أنشئت في سنة 1996 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296، تعمل على إعانة الشباب العاطل عن العمل لإنشاء مؤسسة مصغرة بحيث تقل تكلفتها عن 10 ملايين دج، وتشكل المؤسسات المصغرة إحدى الآليات الهامة لترقية التشغيل الذاتي، خاصة بعد تراجع دور الدولة في ترقية مناصب الشغل. وفي إطار هذا البرنامج في سنة 2004 تم إنشاء 6.677 مؤسسة مصغرة من خلالها تم توفير 18.980 منصب شغل، إلا أنه كان هناك تباين بين عدد المشاريع المعتمدة من طرف الوكالة وتلك التي تم تمويلها فعلا من طرف البنوك، حيث نجد 6.567 مشروع وافقت البنوك على تمويلها من بين 69.437 مشروع التي صادقت عليها الوكالة، لذلك من الضروري أن تساهم البنوك مع جهاز دعم تشغيل الشباب لإنجاز جميع المشاريع المقبولة ضمن هذا الجهاز،[17] بحيث تتمحور أهدافها إلى:
- تشجيع خلق النشاطات من طرف الخريجين أصحاب المبادرات.
-
تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب الخريجين من مختلف الجامعات .
مهام الوكالـــة الوطنيـــة لدعـــم تشغـيل الشباب: يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
- إعلام المستثمرين من الخريجين الشباب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
- إبلاغ أصحاب المبادرات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والامتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.
توجهات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:الجـــهاز يمول بحجم استثماري قد يصل حتى 10 مليون دينار جزائري موجـــه للخريجين من الجامعات البـــطال مـــن:
- أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.
- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.
-
كذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.
أما صيغة التمويل فإنها موزعة على :
- 1.قرض بدون فوائد من الوكالة.
- 2.قرض بفوائد مخفضـة من البنك.
-
-
- أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة:
صيغة التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة: هي عملية تشغيل ضمن الشبكة الاجتماعية في ورشات البلدية مقابل تعويض محدد بـ 3000 دج لكل شهر[18]، إلا أن هذا الجهاز سجل عدة نقائص تتعلق أساسا بالأهداف المسطرة والجوانب التنظيمية والقانونية لتحقيقها وتتمثل في:
- طبيعة العمل المقترح غير محدد بما أنها تعتبر تدخل في إطار «نشاطات ذات المنفعة العامة» وهي مفهوم غامض ومبهم، وكذلك أن المهن في مناصب الشغل المقترحة في إطار هذا الجهاز لا تشكل علاقة عمل حسب قانون الشغل المعمول به، وفي هذه الحالة هل يمكن اعتبار هذا العمل المؤقت كشغل؟.
- ما هي خصائص مناصب الشغل المقترحة في إطار التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، بالمقارنة مع الوظائف المأجورة بمبادرة محلية مطورة في إطار جهاز خاص؟.
إن الفرق الوحيد الذي يميز النوعين من الشغل هو الأجر الذي يقدر بـ: 3000دج شهريا بالنسبة للتعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، و أيضا 2500 دج شهريا بالنسبة للوظائف المأجورة بمبادرة محلية، وهنا يطرح التساؤل التالي: ما هو المنطق السائد في تحديد مستويات الأجور مقابل أشغال متساوية تقريبا؟ في جميع الأحوال يعتبر التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، والأجر الممنوح في إطار الوظائف المأجورة بمبادرة محلية أجور زهيدة، ولا تغطي الاحتياجات الغذائية. [19]
-
-
- عقود ما قبل التشغيل:
أصبح يسمى منحة إدماج حاملي الشهادات PID يخص هذا البرنامج مكافحة بطالة الخريجين حاملي شهادات التعليم العالي وخريجي معاهد التكوين الذين لهم مستوى تقني، وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 02-12-1998[20]، بالإضافة إلى التعليمة رقم08 الصادرة في: 29-06-1998المتعلقة بإجراءات تطبيق الجهاز في إطار عقود ما قبل التشغيل، وهدف هذا الجهاز هو التكفل بعروض العمل وتشجيعها وتشجيع إدماج الشباب حاملي الشهادات في سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و35 سنة.[21]
تظهر الحصيلة أن مجموع العروض في إطار عقود ما قبل التشغيل أكبر بكثير من التوظيف الفعلي في نفس الإطار، وأن أكبر نسبة كانت في الإدارة وذلك نظرا للتوظيف الضئيل في قطاع الوظيف العمومي، كما سجل العنصر النسوي نسبة 64,5% من إجمالي عدد المسجلين للسنوات الثلاث، ونلاحظ من خلال خريجي الجامعات لكل سنة أن فرعي التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية لها أعلى نسبة تصل من: 22% إلى 60%، وأقل نسبة سجلت لفروع العلوم الطبية بـ 4,01% وللهندسة المعمارية 2,30% .
إن حصيلة تطبيق البرنامج جزئية في ظل غياب العناصر الخاصة بطبيعة ونوعية مناصب الشغل والتكلفة الحقيقية للتوظيفات وتوزيعها الإقليمي، وتتم عملية تقييم البرنامج على أساس العناصر التي تقدمها وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأهم الهيئات المسيرة (وكالة التنمية الاجتماعية، الوكالة الوطنية للتشغيل)، وقد أظهر البرنامج العناصر التالية:
- نسبة التثبيت ضعيفة للمستفيدين عند انتهاء مدة العقد، وبالتالي90%من المستنفدين بعد استكمال حقوقهم يسجلون أنفسهم في وكالات التشغيل كباحثين عن العمل، وفي النهاية يبقى برنامج عقود ما قبل التشغيل فترة تأجيل دون أن يمنح إمكانيات حقيقية للإدماج.
- التمركز القوي للمستفيدين في الإدارة على حساب القطاعات الإنتاجية.
- غياب الجمعية الوطنية للحائزين على الشهادات العاطلين عن العمل في تطبيق البرنامج، علما أن تدخل هذه الجمعية كهمزة وصل وشبكة إعلامية عامل ضروري في نجاح البرنامج. [22]
-
-
- الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل:
أنشأ هذا الجهاز في سنة 2004، ويعمل على مرافقة القروض المصغرة ودعمها ومتابعتها، ويخص هذا الجهاز بإدماج الخريجين العاطل عن العمل والحرفيين والنساء بالمنازل، وتتراوح قيمة هذه القروض ما بين 50.000 و 400.000 دج.
-
-
- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات:
تهدف هذه الوكالة إلى تشجيع الاستثمار من خلال الخدمات التي تقدمها، وتقرير المزايا الضريبية المرتبطة بالاستثمار، والذي ينعكس إيجابا في إحداث مناصب العمل وبالتالي التخفيف من حدة البطالة، منذ إنشاء الوكالة سنة 2001، بلغ عدد المشاريع المنجزة في النشاط الإنتاجي 6.616 مشروع بمبلغ 743.97 مليار دج مما سمح بتوفير 178.166منصب شغل وتتوقف فعالية هذه الوكالة على توفير محيط مشجع للاستثمار.[23]
-
-
- الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـرض المصغر:
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 04/14 المؤرخ في : 22 جانفـي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.
تعبر مهمة الوكالة تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من أجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابـــهم الخاص ويتضمــن دورها في:
- تقديم الدعم والاستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجـــه لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو مــعارف في نشاط معين .
- الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـرض المصغر:
-
-
- الوكالـة الوطنيـة للتشغيل:هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في: 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في :29 نوفمبر 1962.
بذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيئات العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسية هي تنظيم سوق الشغل وتسييـــر العـــرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين :
- الوكالـة الوطنيـة للتشغيل:هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في: 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في :29 نوفمبر 1962.
- طالبي العمل : البطالون من كل الفئات.
- أصحاب و أرباب العمل من كل الفئات.
قد جاء القانون رقم : 04/90 المؤرخ في : 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز المكانة بصفتها الهيئة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم باستثناء الأماكن التي لا توجد بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات استثناء أن تقـوم بهذا الدور في حدود اختصاصاتها الإقليمية[24].
- أهداف الوكالة الوطنية للتشغيل:تهـدف أساسا إلى تحقيق ما يلي :
- توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.
- مسايرة التطورات التكنولوجية الراهنة.
- تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل .
- مهام الوكالة الوطنية للتشغيل: ويمكن تلخيص مهامها كما يلي :
- استقبال طالبي العمل لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه .
- تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات.
- تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.
- استقبال المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ما قبل التشغيل حسب التخصص.
-
تسجيل العمال المسرحين لأسباب اقتصادية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.[25]
[25]
- دراسة تحليلية لتقييم أثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر:
لقد قطعت الاستراتيجيات الاقتصادية أشواطا جديدة في مطلع الألفية الثالثة كان لها انعكاسها الايجابي أولا على مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة لدى الخريجين من الجامعات الجزائرية.
- تقييم مستويات ومعدلات البطالة لدى الخريجين:
الشكل(1): منحى يوضح معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة الممتدة (1970-2009):
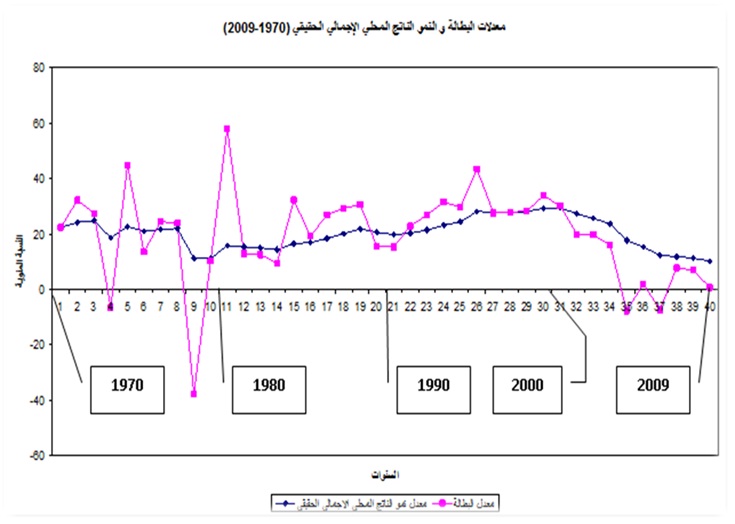
المصدر: من إعداد الباحثتين، باستخدام برنامج: Eviews 7.
معدلات البطالة:
الجدول رقم 1: معدلات البطالة بالنسبة للفترة: (1990-2015) الوحدة(%)
|
السنوات |
90 |
93 |
95 |
1997 |
1998 |
2000 |
2004 |
2008 |
2011 |
2015 |
|
معدل البطالة% |
19.70 |
23.25 |
28.10 |
26.41 |
28.02 |
29.08 |
17.65 |
11.30 |
10 |
9.6 |
المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء.
من خلال الجدول نلاحظ أن معدلات البطالة في الانخفاض وبشدة خاصة في عامي 2008 و 2011 وبلغت أدناها في 2015 حيث كان معدل البطالة 9,6%، وهذا ما يوحي بتحسن سوق العمل بالجزائر، وهذا نتيجة لما بذلته الدولة من جهود في سبيل محاربة الظاهرة.
الجدولرقم2: بعض المؤشرات الاقتصادية سنة 2017
|
نسبة النشاط |
نسبة التشغيل |
نسبة البطالة |
|
41,7 |
37,6 |
9,4 |
المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء، 2017.
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسبة النشاط والتشغيل تزداد مقارنة مع نسبة البطالة التي تمتص والذي يعود سببها إلى فعالية الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
الجدول رقم3: توزيع المشتغلون و البطالون حسب الجنس و الطبقة- سبتمبر 2015
|
السكان البطالون |
السكان المشتغلون |
نوع السكان |
||||
|
مجموع |
ريفية |
حضرية |
مجموع |
ريفية |
حضرية |
الطبقة الجنس |
|
728 |
234 |
494 |
8 262 |
3 027 |
5 235 |
ذكور |
|
348 |
88 |
260 |
1 474 |
348 |
1 126 |
إناث |
|
1 076 |
322 |
754 |
9 736 |
3 375 |
6 361 |
مجموع |
|
100 |
29,93 |
70,07 |
100 |
34,67 |
65,33 |
% |
المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء، 2015.
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسبة التشغيل تفوق نسبة البطالة في المناطق الحضرية والريفية.
الجدول رقم 4:توفر القوى العاملة عالية التعليم عدد الطلاب في التعليم العالي حسب المجال – 2016
|
الجزائر |
الهندسة والتصنيع والبناء |
الهندسة والمهن الهندسية |
عمليات التصنيع والتجهيز |
إجمالي عدد الطلاب في التعليم العالي |
||||
|
المسجلون |
الخريجون |
المسجلون |
الخريجون |
المسجلون |
الخريجون |
المسجلون |
الخريجون |
|
|
321734 |
56454 |
198467 |
34525 |
67436 |
12740 |
2453664 |
416329 |
|
المصدر:الموقع الرسمي للبنك الدولي، بيانات الجزائر، 2016.
الجدول رقم5: درجات تقييم مدى توفر القوى العاملة المؤهلة
|
الجزائر |
يد عاملة |
مهندسون مؤهلون |
مديرون |
مهارات اللغة |
مهارات التمويل |
مهارات تكنولوجية |
متوسط الدرجات |
|
5.94 |
75.7 |
22.6 |
17.5 |
11.7 |
48.7 |
21.6 |
المصدر:الموقع الرسمي للبنك الدولي، بيانات الجزائر،2016.
نلاحظ من خلال الجداول أعلاه، أن القوى العاملة المؤهلة تتوفر في الجزائر و التي مصدرها مختلف الجامعات و المعاهد و مراكز التكوين.
-
تقييم نجاح برنامج عقود ما قبل التشغيل:يتمثل فيما يلي:
الجدول رقم 6: التكلفة المالية لعقود ما قبل التشغيل بالنسبة للفترة 1998-2009 (بالمليار دينار)
|
السنوات |
المخصصات المالية |
الاستهلاكيات المالية |
نسبة الاستهلاك% |
|
1998 |
0.25 |
/ |
/ |
|
2002 |
1.14 |
0.42 |
36.9 |
|
2005 |
0.68 |
0.71 |
104 |
|
2009 |
0.89 |
0.75 |
84.3 |
|
المجموع إلى غاية 31/12/2009 |
2.96 |
1.88 |
63.5 |
المصدر:د. مدني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص 286.
- يبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث استفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود ما قبل التشغيل، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 طالب جامعي خريج .
-
الجدول رقم 7: حصيلة عقود ما قبل التشغيل لفترة 1998-2009 (منصب عمل)
|
قطاع النشاط |
1998 |
2004 |
2009 |
|||
|
العرض |
التوظيف |
العرض |
التوظيف |
العرض |
التوظيف |
|
|
المجال الإداري |
5980 |
5347 |
7274 |
5927 |
4000 |
2000 |
|
المجال الاقتصادي |
991 |
926 |
6332 |
4639 |
7543 |
7711 |
|
المجموع |
6971 |
6273 |
13606 |
10566 |
11593 |
9711 |
المصدر: د. مدني بن شهرة، ،مرجع سابق، ص 286.
الجدول رقم 8 : تطور المترشحين المسجلين في برنامج عقود ما قبل التشغيل:
|
السنوات |
1997-1998 |
2003-2004 |
2008-2009 |
|
عدد المسجلين |
45228 |
25606 |
32323 |
|
عدد خريجي الجامعات |
37323 |
39521 |
42214 |
|
التكوين المهني (تقني سامي) |
7572 |
19620 |
8101 |
المصدر:د. مدني بن شهرة، مرجع سابق،ص 287.
هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف فئة الخريجين من الجامعات و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم استثماري إجمالي يفوق :1.4 مليار دولار.
الجدول رقم 9: يوضح مساهمة قطاع الفلاحي في خلق مناصب الشغل الوحدة: ألف عامل
|
السنوات |
1998 |
1999 |
2000 |
2003 |
2005 |
2009 |
2010 |
2015 |
|
إجمالي فرص العمل |
168 |
356 |
320 |
361 |
773 |
448 |
505 |
267 |
|
في القطاع الفلاحي |
- |
143 |
110 |
127 |
52 |
66 |
97 |
72 |
|
مساهمة القطاع الفلاحي% |
- |
40.16 |
34.37 |
35.18 |
6.72 |
14.73 |
19.2 |
26.96 |
المصدر: من إعداد الباحثتين اعتمادا على موقع وزارة الفلاحة.
من خلال الجدول يمكن لنا التحقق من أهمية قطاع الريفي في خلق مناصب شغل جديدة، إلا أننا نسجل انخفاض محسوس في مناصب الشغل التي استحدثت من القطاع، ويمكن إرجاع ذلك إلى التقنيات الحديثة المستعملة مؤخرا في القطاع، من خلال التكنولوجيا الحديثة.
جدول رقم10: توزيع العاملين بدعم الوكالة لدعم تشغيل الشباب و الخريجين حسب فئات العمر (2006-2015)
|
السنة الفئة العمرية |
2006 |
2010 |
2015 |
|
15-19 % |
441 393 16.82 |
136 329 15.84 |
907 256 15.37 |
|
20-24 % |
958 687 29.41 |
872 666 32.09 |
378 505 30.23 |
|
25-29 % |
984 578 24.75 |
289 509 24.51 |
633 462 27.68 |
|
30-34 % |
890 280 21.01 |
568 245 11.81 |
447 206 12.35 |
Source : ONS, Données Statistiques n°343, 2015.
-
- صيغ الدعم المالي لوكالة تسير القرض المصغر: توجد صيغتين للتمويل في إطار الوكالة الوطنية:
التمويل الثنائي:يتكون رأس المال من المساهمة المالية الشخصية للخريجين أو الشباب أصحاب المشاريع، تمنح الوكالة قرضا بدون فائدة وينقسم هذا النوع من التمويل إلى مستويين:
- المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز: 200.000.00 دج.
المستوى 1 للتمويل الثنائي في إطار الوكالة:
|
المساهمة الشخصية |
القرض بدون فائدة |
|
1% |
29% |
المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz
المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يقدر من: 2.000.002.00 دج إلى 20.000.000.00 دج.
المستوى 2 للتمويل الثنائي في إطار الوكالة
|
المساهمة الشخصية |
القرض بدون فائدة |
|
2% |
29% |
المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz
التمويل الثلاثي: يشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع، تمنح الوكالة قرض بدون فائدة، تتحمل الوكالة تغطية جزء من فوائد القرض البنكي، يتوقف مستوى التغطية حسب طبيعة النشاط، يتم ضمان ومن طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة يتعلق هذا النوع من التمويل بمستويين :
- المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز: 2.000.000.00 دج.
المستوى 1 للتمويل الثلاثي في إطار الوكالة:
|
المساهمة الشخصية |
القرض بدون فائدة |
القرض البنكي |
|
1% |
29% |
70% |
المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz
- المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يقدر من: 2.000.002.00 دج إلى: 20.000.000.00 دج.
المستوى 2 للتمويل الثلاثي في إطار الوكالة:
|
المساهمة الشخصية |
القرض بدون فائدة |
القرض البنكي |
|
2% |
29% |
70% |
المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz
- تقييم نجاح صيغة الدعم المالي لوكالة تسير القرض المصغر
الجدول (12): حصيلة نشاط الوكالة في مجال الدعم المالي لمشاريع الاستثمارية خلال الفترة(1996- 2015):
|
نوع القطاع |
الخدمات |
نقل البضائع |
الحرف |
الفلاحة |
نقل المسافرين |
الأشغال العمومية |
|
عدد المشاريع |
49294 |
27456 |
23872 |
16380 |
13958 |
111288 |
|
النسبة% |
% 31 |
%17 |
%15 |
%10 |
%9 |
%7 |
|
نوع القطاع |
الصناعة |
المهن الحرة |
الصيانة |
الري |
الصيد البحري |
|
|
عدد المشاريع |
8431 |
3955 |
3506 |
428 |
616 |
|
|
النسبة% |
%5 |
%2.49 |
%2 |
%0.27 |
%0.39 |
المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz
- تقييم نجاح صيغة الدعم المالي لوكالة الوطنية للتشغيل على المستوى الوطني:
جدول (13): تطور طلبات و عروض العمل ومستويات التوظيف خلال الفترة: (1995-2010):
|
السنة |
طلبات العمل |
عروض العمل |
التوظيف المحقق |
السنة |
طلبات العمل |
عروض العمل |
التوظيف المحقق |
|
1995 |
827 182 |
511 138 |
873 102 |
2003 |
898 153 |
031 43 |
431 35 |
|
1996 |
116 165 |
151 109 |
749 84 |
2004 |
808 142 |
205 44 |
985 36 |
|
1997 |
402 183 |
137 96 |
177 79 |
2005 |
387 168 |
695 48 |
463 41 |
|
1998 |
221 243 |
035 112 |
776 86 |
2006 |
858 134 |
768 36 |
110 32 |
|
1999 |
218 248 |
088 100 |
960 71 |
2007 |
800 163 |
934 27 |
830 24 |
|
2000 |
845 229 |
783 78 |
498 60 |
2008 |
299 166 |
192 28 |
564 26 |
|
2001 |
875 158 |
922 53 |
219 42 |
2009 |
309 121 |
726 24 |
377 22 |
|
2002 |
709 170 |
815 44 |
668 36 |
2010 |
520 101 |
533 24 |
215 22 |
المصدر: الوكالة الوطنية للتشغيل والديوان الوطني للإحصائيات.
التحليل الاقتصادي و الاجتماعي :
- إعلام الخريجون الذين يعانون من البطالة بعمليات التوظيف بكل شفافية عن طريق فتح مواقع الكترونية وهذا من أجل إلغاء الحواجز والغموض بين الشركات والبطالين عن طريق فتح مسابقات التوظيف والتخصصات المطلوبة أي تكون هناك علاقة مباشرة بين طالب العمل وعارض العمل.
- العمل على توفر قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة عن سوق العمل عن طريق القيام بجمع البيانات والمعلومات كل فترة عن عدد العاطلين فعلا والبحث عن الأسباب الحقيقية وبالتالي تكوين صورة واضحة عن المجتمع حيث أن في المجتمعات المتقدمة نجد الملاحظين الأحرار يقومون بهذه المهمة حيث تتم عملية المسح وجمع المعلومات بكل دقة.
- الحد من ظاهرة البيروقراطية الإدارية في الحصول على القروض من طرف البنوك والتي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة ومكافحة الفساد.
- إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة حيث تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية، مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.
- وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف الاستخدام والعمل على مستويات الدولة متخذة في الاعتبار موضوع الاندماج في الاقتصاد العالمي زيادة القدرة التنافسية.
- الاهتمام أكثر بالقطاع السياحي لما له من إيجابيات في امتصاص البطالة.
- زيادة معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل دائمة ومنتجة.
- يجب أن يكون هناك دور هام للأقاليم والمحليات عند التصدي لمشكلة البطالة (اللامركزية).
- آلية الإعانات المالية للقطاع الخاص ضرورية لتحفيزهم على تدريب البطالين وزيادة فرص العمل لهم.
- تعتبر إعانات البطالة بمثابة حل مؤقت والحل الصحيح هو توفير فرص عمل دائمة.
- الأخذ بعين الاعتبار ببعض التجارب الدولية في القضاء على مشكل البطالة أو التقليص منها.
- خلق مناصب عمل في المجالات الكبرى طويلة الأجل التي تمتص فئة كبيرة من البطالين كمشروعات الأشغال العمومية من طرقات، مباني وعقارات، السدود، المطارات... من خلال الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية بشرط استخدام اليد العاملة المحلية.
- الجزائر كغيرها من الدول الغنية بالمساحات الزراعية وبالتالي تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي من استصلاح للأراضي، تربية المائيات وتربية الحيوانات وتوعية الخريجين من مختلف الجامعات و المعاهد الوطنية بضرورة الاتجاه نحو هذا القطاع لما له من إيجابيات على المدى الطويل خاصة أنه البديل بعد نفاذ البترول، وأيضا يحد من النزوح الريفي نحو المدن وحل مشكلة العقار.
- زيادة معدل النمو الاقتصادي وتشجيع النمو الذي يستهدف التشغيل الكامل.
- تشجيع قطاع الخدمات وذلك من خلال تخفيض معدلات الضريبة وتسهيل الحصول على التمويل.
- تنمية القطاع غير الرسمي ویتحقق ذلك عن طریق سياسات طویلة الأجل تتمثل في تحسين البنية الأساسية التي تفعل هذا القطاع في سياق سياسات متوسطة الأجل تتمثل في تقدیم الحمایة الاجتماعية والصحية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي.
- تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال دعم المنتج المحلي (المنتج المحلي) وفرض رسومات على المنتجات الخارجية .
- فتح القطاع الخاص عن طريق تعزيز آفاق إدماج الخريجين وتهيئة الظروف لتطوير المشاريع المستدامة وبالتالي زيادة وتحسين دور القطاع الخاص وقدرته على خلق وظائف أكثر .
- تقليل القيود واستقرار القوانين والقرارات وكذا رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل دور البنوك في دعم المؤسسات.
الخاتمة:
إن تفحص النتائج الاجتماعية- الاقتصادية للإجراءات السابقة يؤكد لنا دون أدنى مجال للشك أن هذه البرامج قد حققت إلى حد بعيد أهدافها، لاسيما منها المتعلقة بتوفير فرص العمل أو تكوين الخريجين و تهيئتهم للعمل ، و مع ذلك فإن الحصيلة تتميز بوجود حالات بارزة من اللاتوازن والتي تبدو جليا من خلال:
- الفوارق بين فرص العمل الدائمة و فرص العمل المؤقتة؛
- المساهمة المتفاوتة لمختلف القطاعات في هذه النشاطات؛
- تنوع النشاطات في بعض الولايات و الانعدام الشبه الكلي لها في ولايات أخرى؛
على الرغم من تنوع المشاريع المعتمدة فإن هدف هذه البرامج والمتعلق بإحداث التأهيل كان صعب المنال، إذ لم توفر هذه النشاطات أية آفاق للتأهيل و أخيرا في مجال الأجور نلتمس عدم رضاء الخريجين للمستوى المتدني لأجورهم و عدم كفايتها مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
قائمة المراجع:
- الكتب:
- اللغة العربية:
- 1.ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت-لبنان، ج1، د-ت.
- المرسي كمال الدين عبد الغني، الحل الإسلامي لمشكلة البطالة، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ط1، 2004.
- كمال عبد الحميد زيتون، التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، 2005.
- عبد الرحيم تمام أبو كريشة، دراسات في علم الاجتماع التنمية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003.
- فاروق عبده فيلة وأحمد عبد الفتاح الزكي، معجم مصطلحات التربية لفظا واصطلاحا، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004.
- 6.قنطقجي سامر مظهر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، 2005.
- اللغة الأجنبية:
- Arthur Dunhun, Community Development, Social Work Book, Russell Kurtz, 1960.
- المذكرات:
- مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل: التجربة الجزائرية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.
- سليم عقون، قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدلات البطالة دراسة قیاسیة تحليلية-حالة الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2009/2010.
- سمير لعرج، دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي، أطروحة دكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر3، 2008.
- القوانين و المناشير :
- 1.المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول أجهزة التشغيل، الدورة العامة العشرون، الجزائر، جوان2002.
- 2.الجريدة الرسمية، المرسوم 98- 402 المؤرخ في 02 ديسمبر 1998، المتضمن الإدماج المهني لضمان الحاملين لشهادات التعليم العالي والمهنيين الساميين وخريجي المعاهد الوطنية للتكوين، العدد91.
- 3.وزارة العمل والحماية الاجتماعية، منشور رقم 08 المؤرخ في 20جوان1998، يتعلق بإجراءات تطبيق جهاز الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات في إطار عقود ما قبل التشغيل.
- زين العابدين معو، مبروك ساحلي، سياسات التشغيل في الجزائر وسبل حوكمتها، دفاتر القانون والسياسة، العدد 11، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 2014.
- المداخلات
- عماد الدین أحمد المصبح، العوامل المؤثرة في البطالة في الجمهورية العربية السورية، المؤتمر الدولي: أزمة البطالة في الدول العربية، القاهرة- مصر، 17و 18 مارس 2008.
- المواقع الالكترونية:
- أكلي نعيمة، استراتيجيات التنمية في الجزائر، مستخرج من الموقع:
www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/، 08/04/2018، 12:24.
- د. محمد جلال مراد، مقال بعنوان: البطالة والسياسات الاقتصادية، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، على الموقع: www.mafhoum.com.
- صابر أحمد عبد الباقي، مقال حول المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة، كلية الآداب جامعة المنيا، جانفي2011، على الموقع: http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html.
- عاقلي فضيلة، البطالة تعريفها أسبابها وأثارها الاقتصادية (سياسة التشغيل في الجزائر)، مستخرج من الموقع: https://Iefpedia.Com، 11/04/2018، 13:22.
-
https://univ-a nnaba.org/attachments/120_makal7.pdf,10/04/2018, 09:37
- https://giem.kantakji.com/article/details/ID/643,08/04/2018,12:57.
- https://www.foromnet/ showthread.php, 10/09/2007 ,11 : 39.
[1]: فاروق عبده فيلة وأحمد عبد الفتاح الزكي، معجم مصطلحات التربية لفظا واصطلاحا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004، ص132.
[2]: عبد الرحيم تمام أبو كريشة، دراسات في علم الاجتماع التنمية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003، ص3.
[3] : Arthur Dunhun, Community Development, Social Work Book, Russell Kurtz, 1960, P186.
[4]: أكلي نعيمة، استراتيجيات التنمية في الجزائر، مستخرج من الموقع: www.univ-chlef.dz/eds/wp content/uploads/،08/04/2018، 12:24.
[5]:ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت-لبنان، ج1، د-ت، ص227.
[6]: سليم عقون، قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالة دراسة قیاسیة تحليلية -حالة الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2009/2010، ص3.
[7]: عماد الدین أحمد المصبح، العوامل المؤثرة في البطالة في الجمهورية العربية السورية، المؤتمر الدولي: أزمة البطالة في الدول العربية، القاهرة- مصر، 17و18 مارس2008 .
[8]:المرسي كمال الدين عبد الغني، الحل الإسلامي لمشكلة البطالة، دار الوفاء، الإسكندرية-مصر، ط1، 2004، ص11.
[9]: قنطقجي سامر مظهر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، ط1، 2005، ص17.
[10]: سمير لعرج، دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي، أطروحة دكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر3، 2008، ص23.
[11]: مدني بن شهرة، الاصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)، دار حامد للنشر و التوزيع، الأردن،2009، الطبعة الأولى، ص 197.
[12]: https://giem.kantakji.com/article/details/ID/643,08/04/2018,12:57.
[13]: زين العابدين معو، مبروك ساحلي، سياسات التشغيل في الجزائر وسبل حوكمتها، دفاتر القانون والسياسة، العدد 11، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 2014، ص151.
[14]:https://univ-annaba.org/attachments/120_makal7.pdf,10/04/2018, 09:37.
[15]: عاقلي فضيلة، البطالة تعريفها أسبابها وأثارها الاقتصادية (سياسة التشغيل في الجزائر)، مستخرج من الموقع: https://Iefpedia.Com،11/04/2018، 13:22.
[16]: مدني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص281.
[17]: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول أجهزة التشغيل، الدورة العامة العشرون، الجزائر، جوان2002، ص 114-115.
[18]:الجريدة الرسمية، المرسوم 98-402 المؤرخ في 2 ديسمبر 1998، المتضمن الإدماج المهني لضمان الحاملين لشهادات التعليم العالي والمتمنين الساميين و خريجي المعاهد الوطنية للتكوين، العدد 91، ص28.
[19]: وزارة العمل والحماية الاجتماعية،منشور رقم 08 مؤرخ في 20 جوان 1998 يتعلق بإجراءات تطبيق جهاز الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات في إطار عقود ما قبل التشغيل.
[20]: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص117.
[21]: عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره.
[22]: د.محمد جلال مراد، مقال بعنوان: البطالة والسياسات الاقتصادية، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، على الموقع: www.mafhoum.com.
[23]: د. صابر أحمد عبد الباقي، مقال حول المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة، كلية الآداب جامعة المنيا،جانفي2011، على الموقع:
http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html
تطور البحث العلمى في الجامعة الجزائرية
د.الجوزي وهيبة
جامعة تيزى وزو مولود معمري
ملخص المقال:
تعد مرحلة البحث العلمي الحديث أعظم نقلة في حياة الإنسان وحضارته. إلاّ أنّ سرعة التقدم في أنماط المعرفة المترتبة عليها وفي الطرق التقنية المتعلقة بعمليات تطبيقها ونشرها، جعلت النتائج التطبيقية كابتكارات، التي تترتب على عملية البحث العلمي نفسها، سريعة التقدم والزوال. فتقنيات البحث التي كان يحتاج تكوينها ووضعها سابقا إلى جهد فكري وفني هائلين .وقدمت على أنّها انفتاح ثوري في مجال البحث العلمي حيث أصبحت تقبل اليوم على أنها شيء عادي. لهذا أصبح أمام البحث العلمي تحديات، تفرض على الباحثين في المجتمعات المتحضرة، على أن لا يتم الوقوف عند مرحلة محدّدة في عملية معالجة المشكلة، لكون أنّ الفكرة تقبل اليوم في حينها أو بشكل مؤقت، سرعان ما يتم تجاوزها في مراحل البحث المفتوحة نحو فهم أفضل وأشمل. وليس كما يمكن أن يوجّه البحث العلمي إلى الابتكار وإنتاج معرفة نوعية، قادرة على اتخاذ القرار والمساهمة في عملية التنمية المستدامة وحل المشكلات التي تعيق المجتمع والدولة معا.
و من هنا تبرز أهمية المعرفة ومفاتيحها، وتأكيد دور التفكير العلمي والمنهجي في إثراءها ووضعها في السياق التطبيقي الملائم، حتى تتحقق المطابقة بين الفكرة والواقع والعمل على إثرائهما، والنهوض بالمجتمع فكريا وثقافيا. و تعزيز روابطه الحضارية والروحية والإنسانية.
والإشكال المطروح في هذا البحث، هو إشكالية البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ودوره في الخدمة الاجتماعية. و ذلك مساهمة منّا، في عملية الارتقاء بالبحث العلمي إلى البحث النوعي والجودة والخدمة الاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: البحث العلمي - الجامعة الجزائرية - الخدمة الاجتماعية - الباحث - التنمية المستدامة.
Résumé :
La recherche scientifique moderne est le plus grand saut dans la vie humaine et la civilisation. Cependant, les progrès rapides de leurs schémas de connaissances et de la manière technique dont ils ont été appliqués et diffusés ont fait des résultats appliqués des innovations, résultant du processus de recherche scientifique lui-même, rapide et éphémère. Les techniques de recherche, qui devaient être configurées et développées auparavant à l'effort des géants intellectuels et techniques. Il a été présenté comme une ouverture révolutionnaire dans le domaine de la recherche scientifique, où aujourd'hui il est accepté comme une chose normale.
C'est pourquoi la recherche scientifique est devenue un défi pour les chercheurs des sociétés civilisées, mais il n'est pas possible de s'attaquer à ce problème car l'idée est aujourd'hui acceptée de manière ponctuelle ou temporaire rapidement dépassée dans les étapes de recherche ouverte vers une meilleure compréhension
La recherche scientifique peut non seulement être orientée vers l'innovation et la production de connaissances de qualité, capables de prendre des décisions, de contribuer au processus de développement durable et de résoudre les problèmes qui entravent la société et l'État. L'importance de la connaissance et de ses clés est soulignée, et le rôle de la pensée scientifique et méthodologique est souligné en l'enrichissant et en le mettant dans le contexte approprié, afin que l'idée et la réalité puissent être conciliées avec leur enrichissement intellectuel et culturel. Et pour renforcer ses liens culturels et spirituels. Les problèmes présentés dans cette recherche sont le problème de la recherche scientifique dans l'université algérienne et son rôle dans le service social. C'est notre contribution à l'avancement de la recherche scientifique vers la recherche qualitative, la qualité et le service social.
Mots-clés: Recherche scientifique - Université algérienne - Travail social - Chercheur - Développement durable.
مقدمة:
البحث العلمي أو (Scientific Research) هو الأسلوب المُنظّم في جمع وتوثيق المعلومات وتدوينها كملاحظات تحليلية موضوعية، بعيدة عن المشاعر والانحياز، ويكتب البحث العلمي بخطوات علمية ممنهجة، وهذا للتأكّد من صحته فيما لو أراد من يقرأ البحث من التحقّق مما ورد فيه، وهذا أيضاً لسهولة الاقتباس منه للباحثين الجدد والدارسين بهدف الوصول إلى نظريات تنبؤيّة جديدة أو نظريات جديدة اعتماداً على الدراسات السابقة. والأبحاث العلميّة تفرض على الباحث طريقة السير في البحث وتفرض عليه توثيق كل كلمة في البحث من أبحاث سابقة معتمدة، أو بالتجربة (للأبحاث التجريبية)، حيث يقوم بدراسة الموضوع المُختار، وتسجيل الملاحظات والمعلومات المهمة، ووصف تطور الحدث، ووضع أسئلة البحث التي يقوم البحث بمحاولة الإجابة عليها ويمكن الاستغناء عن الأسئلة بوضع فرضيّات وهذا غالباً في الأبحاث التربوية والإنسانية التي لا يوجد بها أجوبة دامغة، حيث تكون محدّدات البحث بشرية سلوكية تتغيّر من مكان لآخر ومن مجتمعات لأُخرى، وقد بدأ البحث العلمي عندما حاول عالم النفس (ernest weber) قياس السلوك البشري بطريقة متسلسلة مدروسة، ليسهل على من سيأتي بعده على تقفّي خطواته ونتائجه بسهولة، فبالإحصاء الوصفي والدراسة المنهجية بدأت الأبحاث تتطور، فالإحصاء الوصفي لوحده لا يكفي، ومع الوقت تعمق علماء الإحصاء فابتكروا طرقاً إحصائية للتحليل سمّيت فيما بعد الإحصاء ألاستنتاجي، فبالطرق المدروسة المنظمة مع الإحصاء الاستنتاجي قلّت نسبة الخطأ للباحثين وصار من الأسهل القيام بالبحث مهما كان حجم المجتمع كبيراً فبالتناسب تكون نسبة معينة كافية لتغطية المجتمع وتسمى عينة البحث.
وأنّ الحاجات المستجدة التي خلفتها مشاريع التنمية والتطوير في القطاعات العامة والخاصة وكذا ضرورة إقامة جامعات وطنية تحافظ على تراث الوطن وتعمل على نشر ثقافته وتلبي حاجيات المجتمع وتعكس تطلعاته وأمانيه.
1- إشكالية البحث:
قد يبدو أن الجامعات على اختلاف أنواعها ومواقعها وأعمارها تقوم تقريبا بنفس الأدوار والمهمات، ورغم ما قد يكون بينها من اختلاف في الأهداف والغايات، فالجامعة في أيامنا هذه تقوم بأدوار ثلاث متكاملة التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. فالبحث العلمي أساسا هو أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند المقارنة بين الجامعات ومحاولة تصنيف وتفضيل أحدها عن غيرها. فالجامعة التي لا ينشر أعضاء هيئة التدريس فيها أبحاثهم باستمرار تظل قيمتها العلمية وخاصة على المستوى العالمي منقوصة إلى حد كبير، رغم ما قد يتميز خريجوها به من جودة في التكوين والإعداد، فالبحث العلمي هو الثروة العلمية التي تمتلكها البشرية اليوم.
إنّ الفكر العلمي ذو الطابع الاجتماعي، يتكون من خلال الوعي الفردي الجماعي والذي يسير وفق أنماط اجتماعية خاصة، بهدف تعميم بعض التماثيل أو التصورات أو المفاهيم، بالإضافة إلى بعض الأفكار على المستوى الفكري وهذا باستعمال المناهج العلمية لاكتشاف الحقيقة.
إنّ نماذج الفكر العلمي المنبعث من مختلف الحالات على مستوى الممارسة الاجتماعية أو من الواقع الطبيعي هو الذي يحدد الميادين والقوانين التي من خلالها تتشكل المفاهيم والأفكار المرتبطة بالواقع والتي تتحقق بواسطة التجربة والمحاولات وإعادة الإنتاج.
كما يشكل البحث العلمي ثمرة عمل متواصل ومنهجي لباحث أو فريق بحث. ويعتبر مجهود عريق العهد يتواصل من جيل إلى جيل مما أدى إلى تراكم نتائجه والتحقق منها في كل المجتمعات، على غرار الاختلافات الأيديولوجية المتواجدة في العالم. إنها مهمة المؤسسات والمنظمات المكلّفة بصيانة وتطوير الفكر العلمي. وهذا ما نلاحظه في المكتبات والجامعات والمخابر ومراكز البحث العلمي والنوادي العلمية والمجلات العلمية، وكل الوسائل الأخرى المختصة بعملية الاتصال والتي من مهامها حفظ وجمع أو نشر الفكر العلمي بهدف استثماره في الواقع لتنمية المجتمع بشكل وظيفي وعقلاني. فالفكر العلمي هو جوهرة الإنتاج المادي فهو العقل الذي يجعل هذا الإنتاج بإمكانه التطوّر والتحسن حتى يتمكن العمال من ترقية طاقاتهم الإنتاجية، بينما تجد الفئة الأخرى في ذلك، إمكانية ممارسة أعمالها المتميزة باللاعقلانية واللاشرعية.
إنّ مختلف مهام التنمية الوطنية تغذي بصفة متعددة أشكال النشاطات العلمية والتكنولوجية، كما يتبلور الآن برنامج طموح في مجال التنمية الاقتصادية العصرية الوطنية مشكلا مخبرا واسعا للتجربة والإنجاز، وأن تسيير المؤسسات الاقتصادية من خلال مشاركة الجميع في إدارة الحياة الاقتصادية ومجمل الإجراءات المتخذة لصالح العمال والجماهير المحرومة، كل هذه تعد نشاطات أساسية يندرج فيها العلم. ويكون لنشاطات البحث فيها دور الكاشف الذي يزداد أهمية أكثر فأكثر في الحاضر، ويكون هو الدليل للمستقبل.(1)
ولكي تستطيع أي دولة الحفاظ على وضعها ومكانتها في عالم اليوم وتعمل على تلبية التطلعات المتزايدة لشعوبها فلا يكفي أن تكون قد وصلت أو دفعت الثمن إلى مشارف التكنولوجيا، بل لابد لهذه الدولة، بعد ذلك، -للمحافظة على بقائها الاقتصادي- من أن تسعى بكل ما في وسعها، لكي تقوم الصناعة بالاستثمار الكثيف والفعّال في أنشطة البحث والتطوير التجريبي. ولا مفر للدول التي تفشل في تحقيق ذلك من أن تنتظر وتتوقع التخلف عن ركب التقدم.(2)
لهذا هناك أعداد كبيرة من مثقفي الدول الناشئة يعملون وبنجاح وعلى مستوى ممتاز في أرقى مؤسسات البحث العلمي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك نجد في الواقع أن التطورات العلمية الأساسية خلال الفترة الأخيرة قد ثبتت في المجتمعات الأوروبية. ولعل أبرز صفات العصر الرّاهن، هو بروز الدور المميّزة للعلم والتكنولوجيا مرفقا حيويا ديناميكيا له تأثير مباشر في مجمل النشاطات الإنتاجية والإنسانية.
ولقد أثبتت الإحصائيات أنه مع ثبات رأس المال والعمالة المستخدمة لأي مشروع إنتاجي، فإن تطوير نوعية المنتوج وزيادة الإنتاج إلى حد يصل 80%. يعود أساسا إلى ترشيد استخدام العلم والتكنولوجيا في المشاريع الإنتاجية لتطويرها. وهذه الحقيقة أدركتها مؤخرا شعوب العالم الثالث مما دعاها إلى فتح شراكة بين الجامعة والمؤسسة الإنتاجية وإنشاء مراكز للبحث العلمي التطبيقي.(3) والجزائر رائدة في هذا المجال، حيث قامت بإنشاء هيئات حكومية تختص بوضع سياسة البحث العلمي ومتابعته. وهذا يعني أن الباحث هو عضو خاضع لجهاز الدولة وبالتالي شاء أم أبى يعتبر عنصرا فعالا وخاضعا لأيديولوجية السلطة الحاكمة.
في هذا السياق نطرح التساؤل التالي:
- ما هي فعالية الجامعة والبحث العلمي وآفاقهما المستقبلية في الجزائر؟ باعتبار أن الجامعة مركز لإفراز القيّم وتطوير الأفكار وإعادة إنتاج الثقافة ومجتمع خاص تحيا فيه النخبة المثقفة في المجتمع الصانعة للأفكار والمثرية لها.
وللإجابة على هذا الإشكال نتناول في هذا البحث موضوع البحث العلمي ودوره في الخدمة الاجتماعية في الجزائر.بتقديم،أولا، رؤية موجزة عن المراحل التاريخية للبحث العلمي في الجامعة الجزائرية. ثم نحاول، ثانيا، كشف واقع البحث العلمي وآفاقه المستقبلية في الجامعة الجزائرية.
2- فرضية البحث:
وفي هذا البحث نقوم بصياغة فرضية البحث مؤسسة على التساؤل المحوري لمشكلة البحث وقائمة على تنبؤ معقول.
وعليه ففرضية الدراسة تتمثل فيما يلي:
للجامعة الجزائرية دور كبير في دعم البحث العلمي الموجه للخدمة الاجتماعية والتنمية الوطنية كما ينص عليه المشروع الوطني.
3- المنهج المتبع:
يتحدد المنهج الذي تدرس وفقه المشكلة، وهو المنهج الوصفي التحليلي، وتتضح التقنية المناسبة لجمع المعلومات المتصلة مباشرة بموضوع الدراسة وهي تقنية تحليل محتوى الوثائق الجامعية التي تتناول البحث العلمي كبحوث ومراسيم إدارية، وكذا المقابلة التي أجريت على الطلبة والقائمين على البحث العلمي على مستوى جامعة الجزائر.
4- سبب اختيار الموضوع:
والسبب الذي دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع يتمثل في المساهمة في عملية الارتقاء بنوعية البحث العلمي إلى البحث النوعي والجودة والخدمة الاجتماعية.
5- تحديد المفاهيم:
- تعريف البحث العلمي وأهميته:
يعرف الدكتور “ كايد عبد الحق” البحث العلمي بأنه "حصيلة مجهود منظم يهدف إلى الإجابة على تساؤل أو مجموعة من التساؤلات المتصلة بموضوع ما متبعا في ذلك طرائق خاضعة لقواعد وضعية".
كما عرفته ثريا عبد الفتاح محسن بأنه : "محاولة لاكتشاف المعرفة أو التنقيب عنها أو تنميتها أو فهمها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق".
وعليه فإن البحث العلمي عبارة عن جهد منظم يقوم به أفراد، هم أهل للقيام به لما يمتلكون من خصائص علمية ومعرفية تسمح لهم بذلك. متبعين خطة علمية معينة تسمح لهم بالوصول إلى نتائج محددة يمكن توظيفها والاستفادة منها في مجالات محددة تبعا لنوعية البحث وطبيعته.
كما للبحث العلمي ارتباط بالمجتمع لأنه يعتبر مسعى إنساني وجهد بشري مقصود، يتم التخطيط له بطريقة عقلانية وموضوعية. ويمكن عن طريقه أن يحقق الإنسان طموحاته النبيلة وأهداف مجتمعه في شتى المجالات. مستغلا في ذلك ذكاءه العقلي أو قدراته الذهنية الفطرية التي وهبها الله له... ومستخدما الإمكانات المادية الطبيعية والعملية والبشرية...الخ. التي تحت يديه أو المتوفرة لديه.(1)
وأيضا، البحث العلمي مهم في تطوّر العلوم بشكل عام، فالبحث العلمي للبحوث الإنسانية والعلمية هو دراسة ذو مصداقية، فيكفي أن يتبع الباحث خطوات كتابة بحث، ويتسلسل بتطبيق التجارب، والحصول على الأجوبة والنتائج الخاصة بالبحث ودراسة البحوث السابقة التي تعنى بموضوع بحثه، وإدراجها ليتتبع القارئ تطور البحث في سياق الموضوع المدروس ، كل هذا يجعل من البحث الطريق إلى تلخيص الدراسات السابقة في علمٍ ما ومن ثم اختار القارئ بالأبحاث الجديدة التي استفادت مما سبق ثم بنت عليه استنتاجاتها، والتي ليست بالضرورة توافقها بل يمكن أن تخالفها وبالتالي تشرح لماذا خالفتها وتقنع القارئ بالدلائل والمواثيق.
كما يزوّدنا البحث العلمي –كباحثين أو كقارئين- بآخر المعلومات التي وصلت لها الدراسات العلمية الحديثة، بل وتسمح لنا بالتعرف على بدايات التدون العلمي لما يخص الموضوع منذ زمن طويل، وما هي الدراسات التي تم تفنيدها أو التي أثبتت صحتها ولو كانت قديمة، وباطلاعنا على الأبحاث المنشورة فنحن نتطلع على أفضل الأبحاث في سياقٍ ما، وتكمن أهمية البحث العلمي أنّه يساعدنا على تأويل نتائج البحث، ويسهل على من يأتي بعدنا البحث والتمحيص، وهو تطبيق عملي للبحث وليس كتابة نظرية، فهو قابل للتطبيق إن اتبع الباحث خطوات من سبقه، وتزود المكتبات بالأبحاث أولاً بأول ممّا يساعد الباحثين الجدد في الحصول على كل جديد، فتتشكل قاعدة بيانات كبيرة من الأبحاث.
6- لمحة تاريخية حول تنظيم وتسيير البحث العلمي في الجزائر:
يمثل الفكر العلمي تقاليد حضارة الشعب الجزائري وتتمكن دائما من التعبير والتأكيد على وجوده عبر عدة قرون.
إن الجزائر التي كانت تصنع أدوات إنتاجها وأسلحتها قبل الاستعمار الفرنسي (1830) والتي كانت تتوفر على الخبراء والمفكرين من العلماء والتقنيات والإنشاءات الضرورية لتنمية العلم والتقنية بالنسبة إلى عصرنا. وجدت نفسها اليوم متخلفة بعدة عصور بسبب الاستعمار.
إن ثورة نوفمبر 1954 التي واصلت مشروعا اجتماعية مبنيا على الحرية والاستقلال والعدالة والمساواة وقد وضعت كمبدأ استرجاع الشخصية الوطنية بكل مقوّماتها ومكوّناتها والرّوح العلمية والمشاركة في الحركة العالمية لتطوير معرفة العلوم والتقنيات التي تشكل أحد العناصر الأساسية التي كان من شأنها تمهيد وبناء المستقبل. والجزائر لم تكن تتوفر غداة الاستقلال إلا على جامعة واحدة وإطارات بعدد ضئيل استدعوا إلى عملية إعادة البناء الوطني.
وقد واصلت بعض مراكز البحث الموروثة من العهد الاستعماري، نظام البحث، لكن لم تستطع بأية حال تشكيل قاعدة انطلاق من أجل تأسيس نظام وطني للبحث العلمي، لذا اكتفى فقط بتكوين الإطارات وأخذ على عاتقه تسيير بعض مراكز البحث العلمي الموروثة.
وحلّت هيئة التعاون التي أنشئت عام 1967، لتسيير مراكز البحث الموجودة وذلك بالتعاون معهم وتكفلت وزارة التعليم العالي بإدارتها، كما أسس مجلس مؤقت للبحث العلمي عام 1972.
وفي عام 1973 أصبحت كل عمليات البحث العلمي وطنية بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي، تحت وصاية الوزارة، حيث قامت بالتكّفل في تنفيذ سياسة البحث العلمي المحددة من طرف الحكومة بشكل متوازي مع العمليات المنتظمة الخاصة باسترجاع الثروات الوطنية. وهذا بإحداث معاهد التكوين ومخابر البحث.
وقد انعقدت أول دورة للمجلس الوطني للبحث العلمي في عام 1975 بمناسبة تهيئة المخطط الوطني الأول للبحث. وهي دورة تشاور وتبادل المعلومات حول مشاريع برامج البحث، حيث وضعت مبادئ البحث العلمي وتنظيم أحسن نشاطات البحث بين مختلف الميادين العلمية.
كما اهتم المخطط الخماسي بقطاع البحث العلمي بوضع عمل تمهيدي تمثل في تشاور كبار موظفي البحث العلمي وموظفي التنمية في إطار أعمال اللجنة الدائمة لتخطيط البحث العلمي. وتكفلت الحكومة به، حيث أقرّت حجم 2,6 مليار دينار للبرنامج مع مليار دينار من اعتماد الدفع للفترة المعينة. وهي الفترة التي سمحت بتشكيل برنامج وطني وكذا السيطرة والتحكم الأفضل على البرامج وتحسين التنسيق بين القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.(1)
وإذا سمحت اللجنة الدائمة للتخطيط للبحث العلمي بجعل النشاطات المتخذة خلال المخطط الخماسي الأوّل والثاني أكثر ترابط داخلي والمشاريع المباشرة أكثر نضجا، وصلت بسرعة إلى حدود إمكانياتها لعدم وجود مخطط حقيقي للبحث العلمي يعتمد على إستراتجية واضحة وأهداف ممكنة على المدى المتوسط والبعيد لا تندرج بصورة شكلية فقط بل بصورة ملموسة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهادفة إلى وضع برامج علمية وطنية حقيقية هي الآن ترى النور في الجامعة والمراكز العلمية والمخابر على مستوى التراب الوطني.
ولقد استحدثت على مستوى المعاهد تبعا للتعديل الذي أحدث على النظام السابق حيث أصبح هناك وحدات للبحث العلمي. أي أن كل معهد يقوم بالبحث في نطاق تخصصه تحت إشراف الجامعة والوزارة، وتشكيل فرق بحث استحدثت على مستوى المعاهد والهدف منها تنشيط حقيقي لهيئة التدريس واندماج كامل في مشاريع الجامعة المتعلقة بالتكوين والبحث.(2)
7- واقع البحث العلمي وتحدياته المستقبلية:
يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى إستراتيجية علمية واضحة المعالم، وقابلة للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة، تؤمن بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة أكاديمياً وقيادياً و يقوم به علماء مبدعون في ميادينهم، مدركون أوضاع أوطانهم وحاجاتها، قادرون على تقصي كل ما هو حديث وطرح الأسئلة، وتلقي الأجوبة. والبحث العلمي باختصار هو الطريق إلى مواكبة العصر في جميع الميادين تتولاه مراكز ومجالس للبحوث العلمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والسياسية والاجتماعية وتكون الجامعة هي النبع الذي يرفد جميع هذه المراكز والمجالس. ومما لاشك فيه أن من أهم مقومات البحث العلمي والتطوير توفر حرية أكاديمية مسؤولة عن مقاربة مشكلات المجتمع، كما يحتاج البحث العلمي الرصين للدعم المادي والمعنوي الكافي، وكذلك المتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة، والمختبرات والمراكز العلمية الملائمة، والخدمات الإدارية المساندة، فبهذه الشروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب من إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
والناظر لوضع البحث العلمي في العالم العربي يلاحظ أن هناك الكثير من العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المتوقع منه، مما أدى إلى تأخر عملية التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم. وسنناقش هذه العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي لتشخيص المشكلة لعل أن يتم وضع الحلول المناسبة لها.
و في الجزائر رغم ما حققه التعليم العالي من انجازات ومساهمات في جميع المجالات إلا انه أضحى يعاني من أزمة متعددة المظاهر”هي نفسها تقريبـا الموجودة على امتداد ساحات عربية عديدة” بوعشة(2005).حيث يجمع الباحثين، مطانيوس (2006) ،ألبرغوثي وأبو سمرة (2007)، معمرية(2007)،عبد الزهرة محسن (2012).طعمية والبندري (2004)،المجيدل وشماس(2010)، أن البحث العلمي في الجامعات العربية في أزمة حقيقية. ومن أهم ملامحها الاهتمام والتركيز على العملية التعليمية وإهمال الاهتمام بالبحث العلمي،الاهتمام بتوظيف مدرسين عوض التركيز على توظيف باحثين قادرين على أداء مهمة البحث العلمي، غياب خطة للبحث العلمي،وضعف ميزانية البحث العلمي،عدم تخصيص وقت محدد للبحث مثل ما هو مع عملية التدريس،عدم توجيه البحث العلمي لمعالجة مشاكل المجتمع،والبحث العلمي هو عبارة عن دروس نظرية تلقى على الطلبة في الجامعات، وغيرها كثير، وتؤشر على وجود أزمة في مجال البحث العلمي.
ممّا سبق اتضح لنا أن البحث العلمي في خدمة المجتمع والمؤسسة الجامعية التي تضمه أيضا والنظام التربوي الذي يضم كل من التعليم والبحث العلمي.
وإذا تعمقنا في الأمر نشير أن البحث العلمي يكون في خدمة المجتمع إذا روعي في ذلك أمران هما:
أ- أن يكون البحث وظيفيا.
ب- أن يراعي هذا البحث اهتمامات الباحث إلى جانب اهتمامات المجتمع.
فالأمر الأوّل: أن يكون وظيفيا فإن الوظيفية هنا تعني قيام هذا البحث بمراعاة المطالب الاجتماعية المختلفة والمتجددة باستمرار، كالمتطلبات الوطنية والدينية والثقافية والتنموية وغيرها ... وتكون متوافقة وخصوصيات هذا المجتمع، وما عداها يعاكس ذلك، (غير وظيفية) وبذلك فقط يكون هذا البحث فعّالا ومجديّا ومؤثرا وبه وحده يكون في خدمة المجتمع الذي يعلق عليه آمالا كبيرة للنمو والتقدّم.
الأمر الثاني: الذي يجعل البحث العلمي في خدمة المجتمع هو أن يلبي هذا البحث اهتمامات الباحث، أيضا، فأوّل ما يتبادر هنا إلى الذهن هو الفصل بين اهتمامات المجتمع واهتمامات الباحث العلمي. وهذا بتمسك الباحث بالأسباب الموضوعية ويبتعد عن الأحكام والقيم المسبقة إذا أراد النجاح لبحثه خاصة إذا كانت اهتمامات الباحث تتعارض واهتمامات المجتمع، فعليها أن تحفظ لعل اهتمامات المجتمع تتغير مستقبلا لتطابق الاهتمامات الحالية للباحث، كما أن الاحتفاظ بنتائج البحوث التي تعكس اهتمامات الباحث ضرورية لإثارة جو من النقد والنقاش الذي يسهم في خلق حركية معرفية وعلمية مفيدة تظهر من خلال ردود الأفعال حول نتائج تلك الاهتمامات.
وعليه تصبح اهتمامات الباحث وإن اختلفت، واهتمامات المجتمع بهذا التصوّر في خدمة المجتمع، طالما أن النتيجة واحدة وهي نمو وتطوّر المجتمع وحل مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية.
فالبحث العلمي هو قائم من أجل النهوض بالمجتمع ويستهدف مجالاته المختلفة عاملا على تنميتها وتطويرها من خلال زيادة المنتوج الفكري والمادي الذي يستخدم لسد الحاجات وتلبية المتطلبات وكذا تقديم حلول للمشكلات الاجتماعية والثقافية والسياسية والصناعية والبيئية وغيرها، التي يطرحها المجتمع.
والبحث العلمي شأنه شأن المجالات الأخرى، تعترضه مشاكل عديدة سواء ما تعلق بمشاكل الباحثين في مسار بحثهم، إذ تعترض طريقهم في البحث صعوبات قد تعجزهم عن مواصلة البحث أو بالمشاكل التي يفتعلونها هم أنفسهم، إذ يتحملون أعباء هذا البحث بكسلهم وعدم كفاءتهم وميولهم الأيديولوجية التي يفرضونها على تصوراتهم البحثية أو في إطار الإشراف العلمي على الأطروحات الجامعية إلى أداة للقهر الفكري وترويج بعض الاتجاهات السلبية وفرض التبعية الفكرية وهو أمر يتنافى مع الهدف الحقيقي من تكوين الرجل والباحث ويُورث الخضوع للاستبداد بالرّأي واحتقار الديمقراطية.(1) فالمشكلة الأيديولوجية كانت ولازالت تعيق البحوث العلمية على مستوى العلوم الإنسانية خاصة. ومن المشاكل أيضا المشكلة السياسية لأن بعض الموضوعات هي تعتبر حساسة كثيرا ما تمانع الحكومات على تبنيها كبحوث علمية وتتعمد عرقلتها، هو ما يؤكده الدكتور أحمد ظاهر "الحكومات العربية أيضا لا تشجع قيام البحوث العلمية في معظم الأحيان ولا تحب البحث في قضايا حساسة كقضايا القبلية والانصهار الاجتماعي والاغتراب السياسي أو قضايا التغيير والتحديث وغيرها"، فإذا طلب الباحث ترخيص لبحثه من الجهات المسؤولة فإن طلبه غالبا ما يرفض. وهناك مشاكل أخرى متعلقة بالظروف التي تحيط بالبحث العلمي وهي ذات الأثر السلبي على البحوث العلمية بحيث تقلّل من مفعولها، رغم جهود الباحث في مواجهتها وإقامة التحديات المختلفة، فتسيطر الأهداف ووضع الخطط وتوفير المناخ المادي والمعنوي يذلل بها صعوبات بحثه وهذا إن توفرت لديه الإرادة والعزيمة لإنجاح بحثه العلمي.
إنّ الداء الذي تعاني منه الجامعة الجزائرية هو مستفحل على جميع الأصعدة وفي جانبه البيداغوجي بشكل خاص حيث نلاحظ التشويش على الإطارات والعمل الجماعي الذي يجعل منها كلا مجزءا. أين نجد الكل منطوي على ذاته. الأغلبية القصوى من الأساتذة الباحثين لا يبحثون من أجل البحث وتجديد المعلومات وتجديد دروسهم، لكن ينقلون نفس الذخيرة المعلوماتية المهجورة من عام لآخر، ينتج عنه عدم التأهيل للجامعيين، وما يزيد من تفاقم الوضع في الجامعة هو وجود انزلاقات خطيرة قد تطيح بالجامعة وتفقدها قيمتها النبيلة، كأعلى مؤسسة في التعليم والتكوين، وتفقد بها قيمتها في المجتمع وحتى لدى الأسرة الجامعية بكل أعضائها. إذ نذكر من تلك الإنزلاقات البيداغوجية منها إذ وصلت إلى حد المتاجرة بالنقاط أي بالعلامات، وبعض من يزعمون أنهم يمثلون الحركة الطلابية ينحدرون في المستوى إلى ممارسة نشاط السمسرة، بربط علاقات مع المموّنين للأحياء الجامعية والخدمات الجامعية، والاستغلال الرديء والخطير للأحزاب والتنظيمات التي يمثلونها، كان من نتائج ذلك وللأسف الشديد، استنزاف هيئة التدريس بهجرة عناصر أكثر كفاءة وخبرة إلى الخارج ... هروبا من الوضع المزري الذي آلت إليه الجامعة الجزائرية.
وثمة الإشارة أيضا إلى إعادة إنتاج المناهج وتغيير وتجديد بعض الطرائق التي يعلم الجميع أنها من سمات التخلف في ظل الإصلاح الجامعي الجديد، فطرق التكوين والتأطير ومسابقات التوظيف ومسابقة الماجستير تتم في كثير من الأحيان بطرق تخضع لضغوطات مباشرة أو غير مباشرة وهي ممارسات غير علمية وغير أخلاقية. لكن هذه الطرق يتم التحفظ عليها بكيفية أو بأخرى ما يدفع بالطالب إلى التساؤل، وإن توفرت الجرئة، إلى البحث أيضا لترصد حقيقة ذلك. هو ما أفصح عنه وبجرئة الدكتور عبد الغني مغربي في أحد منتديات المواطنة والعصرنة حيث قال: "لماذا في هذه الحالة نبدي نوعا من التعقيد حينما نعلم أن الشهادة العليا وفي المقابل دكتوراه دولة التي يمكن أن تمنح لشخص لا يملك حتى مستوى الماجستير فمنح هذه الشهادة لا يتم في سرية كما يمكن
أن نعتقد، لكن في هذا الإطار شبه الرسمي أين تحترم حرفيا النصوص التشريعية
أو التنظيمية لأن المناقشة تتم في إطار مفتوح وهنا نحن في مستوى التأكيد أن الحرف قتل الفكر."(1)
وإذا تمعنا بنظرنا إلى المشهد الثقافي داخل الحرم الجامعي ودققنا الملاحظة نرى الطلبة في عزوف عن المطالعة حيث لا تشهد المكتبات الجامعية إقبالا كبيرا ما عدا فترة الإمتحانات. إذ لا نكاد نرى الطلبة إلا في وضعية ترفيه وبالأحرى مطالعة صحف أو مجلات الموضة للبنات والرياضة فيما يخص الذكور.
8- نتائج الدراسة:
- خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل فيما يلي:
1) إن وضع الجامعة الحالي يؤول إلى انشغال الجامعة الكبير بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذا ينعكس في المواضيع والإشكالات المطروحة على مستوى البحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة والتي تندرج في إطار تخصص العلوم الاجتماعية والعلوم ألاقتصادية وأيضا على مستوى نشاط الأساتذة الجامعيين بمختلف درجاتهم العلمية على مستوى المخابر العلمية المعتمدة من الجامعة وبشراكة مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2) التفعيل النسبي لدور الجامعة الجزائرية في خدمة التنمية الوطنية وهذا بوضع مشروع الشراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية في الميدان وليس فقط حبر على ورق، موثق في مراسيم وزارية تزكي معنويا نشاطاتها، ومستفيدة ماديا منها. وتفتح فضاء للبحث العلمي لذوي الكفاءات بالنشاط والعطاء، مساهمة بذلك في إنجاح المشروع التنموي للبلاد.
* وعليه، أقدّم بعض الاقتراحات علّها تنشط عملية البحث في الجامعة.
- إنشاء صندوق الدّعم المالي للبحث العلمي والإنفاق عليه، يموّل من هيئات حكومية مهتمة أو قطاعات خاصة تستفيد من نتائجه العلمية والتي تساهم في تطويرها.
- توفير المناخ العلمي السليم في الجامعة وإزالة غموض اصطلاح الحرية الأكاديمية في أنظمتها وقوانينها.
- وضع إستراتيجية تهدف إلى العمل على إيجاد بيئة متكاملة للبحث العلمي والابتكار والريادة. ومنافسة ومساهمته في التنمية.وفي انتاج المعرفة وربط مؤسسات التعليم العالي بالقطاعات التنموية والمساهمة في تطوير العمل الأكاديمي في المستقبل.
خاتمة:
إن البحث العلمي وتطويره من أهم القضايا التي يجب أن نوليها كامل اهتمامنا وعنايتنا ، ذلك لأن المواضيع التي يتناولها البحث العلمي بالدراسة ماهي إلا محاولة جادة لإيجاد حلول للمشكلات الكثيرة والمتعددة التي
تواجهنا في الحياة اليومية ، والتي تشكل عقبة في سبيل تحقيق التقدم والنجاح ، على مستوى كل الأصعدة ، من ذلك تتأتى لنا الأهمية البالغة والبارزة للبحث والتنقيب ، ليس أي بحث ولكن ذلك الذي أعد وفق قواعد وأسس تؤكد صحة وسلامة النتائج المحققة. وما ينبغي الإشارة إليه ، هو أن المنهجية ليست مجرد قواعد وخطوات علمية ، أو مجرد مجموعة من التقنيات والأساليب التي يجب أن يتبعها الباحث خلال إنجاز بحثه، وإنما هي أسلوبا في التفكير السليم والمنطقي ، فأحرى بالطلبة والباحثين في ميدان المنهج العلمي ، ونقصد بهذا تنظيم سير العقل بما يوافق القواعد العلمية ، ليكون لهم سندا وأساسا ينطلقون منه في إنجاز أي بحث أو القيام بأي دراسة علمية .فالبحث العلمي لا يحقق الفائدة المرجوة منه إلاّ إذا التزمنا في إنجازه بالمنهجية السليمة.
نخلص إلى القول، أنّ البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ورغم ثرائه، إلاّ أنّه في الواقع لم يصل بعد إلى المستوى الذي نرضى عنه جميعا. وهذا لاعتراضه جملة من المعوقات كنقص التدعيم المالي المخصص للبحث، وانشغال الأساتذة أكثر بعمليات التدريس والأعمال الإدارية وصعوبة النشر. وعدم وجود سياسة وطنية محكمة للبحث العلمي تحدد مجالاته وأولوياته.
فالواقع أن الحرية في البحث العلمي وفي الكثير من المجالات، تكون مقيّدة، ففي بعض الميادين يصعب على الباحث تناول القضايا الواقعة في نطاقها (السلطة) وإذا استطاع تناولها فإنه قد لا يكون حرّا في نشر النتائج التي يتوصل إليها. إلاّ إذا كانت ضمن الأطر المسموح بها. وخاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية الضاربة في عمق المجتمع والكاشفة له.
قائمة المراجع:
1- جون-ب. ديكنسون،(1986) العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، ترجمة: اليونسكو، الطبعة الثانية، باريس.
2- اتحاد مجالس البحث العلمي العربية (الأمانة العامة، (1980)، دور أجهزة البحث العلمي العربية في عملية التنمية العمومية، وقائع الندوة المنعقدة في عمان (الأردن)،
5-7/02/1979، تحرير د. بسام الساكت، بغداد .
3- سامي سلطي غريفج، (2001)،الجامعة والبحث العلمي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
4- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (2006)، النظام الداخلي لجامعة الجزائر،دليل مختصر.
5- مجدي عزيز إبراهيم، (2001)،رؤى مستقبلية في تحديث منظومة التعليم، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة .
6- مجلة الجامعة، ديوان المطبوعات الجامعية، (1975)،العدد 2، الجزائر .
-7Abdelghani MEGHERBI,(2006) « Bonne gouvernance espace de citoyenneté et mutations socio culturelles, Revue de Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité – Alger N°4, Mars.
-8 Dominique Glasman et Jean Crémer, (1978) ,Essai sur l’université et les code en Algérie, éd. C.N.R.S.
حمود البدر : معوقات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية و الإنسانية.
التراجـــع الديمغرافـــــي خلال الفترة الكولونيالية بالجزائر
(المنطقة الممتدة من سهول مينا والضفة اليسرى لشلف)
فيما بين 1863-1900
د. ليلى، بلقاسم
المركز الجامعي غليـــزان
La régression démographique pendant la période coloniale en Algérie (la zone s'étendant des plaines de la Mina et de la rive gauche du Chlef) entre 1863-1900:
The demographic regression during the colonial period in Algeria (the area extending from the plains of Mina and the left bank of Chlef) between 1863-1900:
مست السياسة الكولونيالية_ الفرنسية التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للفرد الجزائري جراء أساليب التفقير والقهر والمصادرات، فأفرزت نظاما يقصي الأهلي تضاعفت على حسابه ميزانية الميتروبول بما فيها جيوب الكولون، كنتيجة لتحطيم الإنسان الجزائري وإحلال الأوروبي مكانه باستنزاف خيرات البلاد الجوفية والسطحية باقتلاع الجزائري من أرضه ونسقه الاجتماعي وكانت منطقتي مينا والضفة اليسرى لشلف كعينة لما وقع في الجزائر خلال المرحلة الكولونالية الممتدة من 1863 إلى 1900 المرحلة التي تميزت بتطبيقات القوانين العقارية واستهداف الأرض والقبيلة.
فما هي عوامل التراجع الديمغرافي بالمنطقة؟ وماهي انعكاسات ذلك على التركيبة السكانية والاقتصادية؟
صرح لاموريسيار قائلا : " على المنتصر تطبيق قانون الغالب، فالعرب الذين حُطِّموا عسكريا يجب أن يُحَطَموا اقتصاديا، وهم مجبرين طوعا أو كرها على ترك أراضيهم للمستوطنين.[1]"
أدت السياسة الكولونيالية الفرنسية إلى إحداث خلل في الخريطة الديمغرافية في المنطقة المدروسة كعينة لما حصل في الجـــزائر، ممّا خلق حالة من لا استقرار الاجتماعي والسكاني، في مقدمته سياسة الإبادة والتهجير والتقتيل التي تخللت الانتفاضات الشعبية، فخلال انتفاضة فليتا 1864 والتي مست بلاد بني وراغ وبني مسلم وكل المنطقـــة، مما اضطر السلطة الاستعمارية إلى إخمادها وفق سياسة الأرض المحروقة وهذا ما ورد على لسان لاباســـي(Lapasset ) :" من جوان 1864 كان التالي: 02 جوان تمَّ حرق أراضي أولاد صابر وأولاد ايعيش وأولاد خويدم، في 03 جوان ضربت كل قبائل عمي موسى وفي 04 جوان اخترق منحدر رهيـــو من طرف طابور لاباسي وروز وأحرقت قرى مكناسة.[2]" وعقب نهاية الانتفاضة صودرت آلالاف الهكتارات وتمَّ نفــــي 300 ثائر إلى جزيرة كورتي وكورسيكا وكاليدونيا الجديدة، زادها حجم الضرائب والغرامات المالية المفروضة على الجزائريين، بلغت في قسمة مستغانم خلال أشهر أوت 1865 و جانفي 1866 و سبتمبر 1866 ما قيمته 1.227.696 فرنك و 80 سنتيم[3] من مجموع الضرائب التي ارتفعت خلال شهر أكتوبر 1866 إلى 6.482.544 فرنك و 85 سنتيم كغرامات حرب[4]، وهذا ما رصدناه من خلال الوثائق الأرشيفية إضافة إلى استمرار ضريبتي الزكاة و العشور في أوساط القبائل المتضررة لتصنف المنطقة ضمن الأقاليم الأَكثر بؤسا. المبالغ التي حوّلت لدعم المشاريع الاستيطانية بما يخدم الكولون منها الهياكل القاعدية في عمي موســـى وغليزان وزمورة يلـــل ذات بعد عسكري دفاعي بلغت قيمتها 2.458 فرنك و 42 سنتيم[5].
كما قادت السياسة الكولونياليــة إلى ارتفاع معدل الوفيات في أوساط قبائل المنطقة الأمر الذي أدى إلى تهديد الوضع الديمغرافي، كنتيجة لعمليات إفقار الفرد الجزائري، ففي مواطن فليتا والظهرة والونشريس: " تراوح التناقص ما بين 30 إلى 60 % في مجال مينا وأولاد بوعفان 65.7 % وأولاد بوعلي والونشريس وحول غليـــزان 62.4 % وفي بني زنطيس على سفوح الظهرة 58.5 % وبأولاد يايا بجبال زمـــورة لم يبق سنة 1869 إلاَّ 791 فردا من مجمل 2.460 فردا الذين شملهم إحصاء سنة 1866 ما يمثل خسارة بـ 67.8%"[6]. مما أدى إلى زوال قبائل بهدف كسر المقاومة ضد السلطة الاستعمارية، بل إلى افراغ المناطق من الساكنة جراء عمليات الإبادة والحرق والعقوبات الجماعية فكنتيجة لانتفاضة 1864 غادرت 341 خيمة مواطن فليتا تاركة أراضيها ولجأت إلى قسمة معسكر فرارا من أعمال القمع[7].
والجدول التالي يوضح حالة التقهقر السُّكاني في بعض القبائل ومنها قبيلة أَولاد العباس 1867-1897:
|
السنوات |
القبيلة |
الدواوير الأهلية |
السكان (نسمة) |
المساحة الإقليمية |
ملاحظات |
|
1867 |
أولاد العباس |
-قرواو -أهل قرين -واريزان |
6.462 |
17.018هكـ |
اقتطع 4.153 هكـ لخلق عين كرمان – وادرهيو دوار واريزان ألحق خلال هذه الفترة في جزء منه بلدية عين كرمان وجزء منه بالبلدية المختلطة سيدي أمحمد بن علي (Renault) |
|
1897 |
5.333 نسمة |
12.865 هكـ |
Source :Lecq,M, H, Commission d’étude des améliorations à apporter dans la situation agricole de la Vallée du Cheliff, Rapport à Monsieur le gouverneur général de l’Algerie, Alger, Imprimerie orientale, 1898, PP :122-123.
ما يلاحظ من خلال الجدول حالة التناقص الديمغرافي في العرش في مدة 30 سنة بمعدل 1.119 فرد وهذا كنتيجة لسياسة التفقير بسبب سلب العقار و اقتطاعهِ لصالح إنشاء المراكز الاستيطانية و توسيعها، إضافة إلى حجم الضرائب الباهظة التي بلغت في العرش ما قيمته 29.163 فرنك سنة 1867 في حين بلغت سنة 1897 م ما قيمته 34.840 فرنك كان يوجه أغلبها لدعم المشاريع الاستيطانية لصالح الكولون.
وبمأنَّ جلَّ القبائل الممتدة ما بين منخفض مينا والضفة اليسرى لشلف ما بين 1866-1870، خضعت لتطبيقات القرار المشيخي (Sénatus-Consult) 1863م، الذي أدّى إلى تحطيم التركيبة الاجتماعية للمجتمع المَحلي بالمنطقة لتصنف ضمن المناطق الأكثر تضرراَ حيث سجلت 1.383 ضحية في الفترة الاستعمارية بالخصوص في المناطق النائية الجبلية ما بين وادي مينا ووادرهيو بالخصوص التي شملتها انتفاضة 1864 [8]."
في حين انعكست السياسة الكولونيالية بالجزائر بالإيجاب على المستوطنين الأوروبيين و بالسلب على العنصر المحلي الجزائري، أمام تقلص نصيب الفرد الجزائري من الحبوب والمساحات الزراعية على حساب توسع زراعة الكروم والمحاصيل الصناعية الموجهة لخدمة الاقتصاد الكولونيالي الرأسمالي. فبينما ظلت مساحات الجزائريين تعرف انكماشاَ بفعل القوانين العقارية الجائرة ظلت مساحات المستوطنين الأوروبيين تعرف توسعا ، ضف إلى ذلك الدعم المالي المصحوب لهذه الفئة الدخيلة التي ازدادت ثراء . إذ انتهجت السياسة الكولونيالية عمليات الإفقار والإهمال اتجاه السكان الجزائريينَ بداية بالتشريعات العقارية وبالتحديد قانون فارني(Warnier) 1873 م الذي أباح التسويق في الأراضي الجزائرية ما شجع المعاملات الربوية وفرض الضرائب الثقيلة العينية والنقدية والرهنية، التي أنهكت جيوب الجزائريين وحولتهم إلى خماسين وبروليتاريا كادحة في المدن الهامشية كحي الزنوج أو القرابة* بغليزان، لتظهر فئة الفلاحين من غير أراضٍ وفلاح بدون عمل مسخر كأجير لخدمة الكولون والأرستقراطية والبرجوازية الجزائرية وهذا ما نقرأه في تقرير سبتمبر 1866 :" الأَهالي ومن أجل البحث عن وسائل معيشية أُخرى و لتخفيف مأساتهم جراء المحاصيل الضعيفة لسنة 1866، ومن بينها تلك القبائل المجاورة لمراكزنا الاستيطانية فالبعض شكلوا أيادي مساعدة للمزارعينَ الأُوروبيينَ والآخرونَ ذهبوا ليطالبوا بالعمل في ورشات السكة الحديدية… السكان العرب خلقوا موارد ذات قيمة وأصبحوا في نفس الوقت بالنسبة للكولون كما للمقاولينَ وسيلة بالغة المساعدة للأشغال الاستيطانية الكبرىْ[9]." ومع ذلك استمر تحصيل ضريبة العشور إلى مصلحة الضرائب (Service de contribution) - كما اوضحنا أعلاه- دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية للجزائريين. إلى الكوارث الطبيعية على رأسها الجفاف سنة 1865م صاحبه الجراد 1866م.
إنَّ الفقـــر الذي أصاب العنصر المحلي بالمنطقة المدروسة كعينة عن الجزائر يرجع إلى الأسباب التالية :
- الابتلاع المتزايد للأراضي الجزائريين الفلاحية الخصبة والرعوية مما أثــر على الأوضاع الاقتصادية بالخصوص الزراعية و على الظروف المعيشية للجزائريين جراء افراغ المطامير من مخزونها، التي كان يحتاطُ بها الجزائري في أوقات الفاقة والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية. وفي المقابل احتياطـــي المستوطنين من الحبوب لم ينقص منه شيء وبالرغم من ذلك لم يخطر ببال أحد الرسميينَ أو من الخواصْ أن قدم يد المساعدة للجائعين[10]. في ظل سياسة فرنسة الأراضي وجمع الجزائريينَ وحصرهم (Cantonnement) في مناطق محددة لا تتناسب وعددهم ولا احتياجاتهم مما أدى الى تقلص مواردهم الزراعية والرعوية .
- الفــــــــــاقات والمجاعات التي ضربت المجتمع المحلي بالمنطقة و التي ترسخت في ذاكرة الجزائري بالتأريخ لها بأعوام هذه الكوارث بعام الجوع وعام الشر (1867-1868) وعام الجراد (1866) الذي ترتب عنه إصابات بالتسمم في المياه مما ساعد على انتشار الأوبئة والأمراض كالتيفوس والكوليرا لم تسلم منه حتى الحيوانات، وهذا ما نقرأُه في تقرير ماي 1866م " جفاف طويل والسبب الأوَّل لهذه الحالة غزو الجراد، قبائل آغاليك الظهرة الأَكثر عناء من هذه الكارثة، خسرت الحبوب التي تكبدوها لقد رأوا أشجارهم الجميلة من التين قد دمرتْ تماماَ كارثة كبيرة ضربت مواردهم في كل المناطق،إنَّ الاستياء عميقْ[11]". وخلال شهر جوان لنفس السنة (1866) ورد التالي : " الأهالي مستاءون يقضون جلَّ وقتهم في الفتك بالجراد الذي تسبب في الكثير من الضـــرر، هذه السنة ستكون أكثر سوءا ، الحبوب في تناقص محاصيل السنة الأخيرة الآمال فيها ضعيفة و كذلكَ محاصيل أشجار التين لمعظم قبائل القسمة ... المأساة بدأت وتمّ استشعارها في عدة نقاط مما سيشكلُ تهديدا حقيقيا[12]."
من الأمثلة على ذلك قبيلة أولاد رافع باقليم زمــــورة تذكر التقارير أنَّها عانت كثيرا من أزمة 1866-1868 بحيث فقدت سُدس سكانها جراء المجاعات والأوبئة إذ نقص عدد السكان إلى 384 فرد إلى جانب خسائر في الثروة الحيوانية بشكل عظيم، أصبحت القبيلة لا تشمل إلاَّ 11 حصان و 6 بغال و 12 حمار و 65 بغل و 1.027 خروف و 574 من الماعز، وقدرت الضريبة خلال 10 سنوات الأخيرة بـ 5.191 فرنك و 68 سنتيم نفس المتوسط بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة وُجد منخفضا بـ 769 فرنك و 80 سنتيم[13] . ومن الأَمثلة على ذلك أيضا قبيلة أولاد راشد كما باقي قبائل فليتا عانت بقوة من أزمة 1867م ، فخلال سنة واحدة و مقارنة بالوضعية الإحصائية لسنتي 1867-1868 يظهر الانخفاض جليا بحيث فقدى ثلث سكانها[14]. ومن أكثر القبائل بؤسا قبيلة أولاد بلحي فمن خلال الأرقام التي تركها المكتب العربـــي فقدت من 1867 م إلى 1868 م حوالي 1.176 فرد و 253 حصان و 1.271 من الثيران و 13.705 من الخرفان والماعز[15] ما يعني هلاك ثرواتها وإمكانياتها المادية والبشرية، القبيلة التي كان طرفا مهما في انتفاضة سيدي لرزق بلحاج(فليتا ) 1864م.
- انعكاسات الانتفاضات و المقاومات جراء افراغ الساكنة من الأراضي كنتيجة للقمع و الغرامات الحربية التي انهكت الأهالي فقبيلة فليتـــــــــا فرضت عليها الغرامات التي انهكتها بالكامل جراء انتفاضة 1864م وفي شهر أوت 1865م، حوالي 99 سجين أُرسل الى مستغانم و 100 سجين آخر وضعوا في زمورة، وفي شهر شهر نوفمبر 1865م 341 خيمة من فليتا فرّت من البلاد، ولجأ أغلبها إلى قسمة معسكر يذكر التقرير أنّ فليتا جراء ذلك لم يكن لها الوقت الكاف لإعادة ترميم ما أصابها من جديد بالخصوص ما لحقها من مجاعة 1867م التي أغرقتهم مرة أخرى في البؤس[16].
- انتشار الأمراض والأوبئة التي أهلكت المجتمع المحلي و منها داء الكوليرا والطاعون وغيرها من الأَمراض الفتاكة. يذكر تقرير ديسمبر 1863م: " أنّ وباء حمى متقطع ومعقد الملاريا الدماغية (L’accès pernicieux ) تمّ ظهوره بتاريخ 08 ديسمبر 1863 بقبائل مديونة و مازونة... وأدى إلى وفيات كبيرة، وبتاريخ 16 ديسمبر سجلناَ في قبيلتين 58 حالة وفاة خلال غزو المرض، السيد فيدال(Vidal ) موظف من الدرجة الأولى هذا الطبيب حاليا متواجد بمازونة مع الأَدوية وفي هذا المكان ساح في القبائل المتضررة من هذا الوباء وعمل ما في وسعهِ لإنقاذ الأهالي[17]." كما يشير تقرير أوت 1865م : " أنَّ الوضعية الصحية لا ترقى إلى المستوى المطلوب فالعديد من القبائل انتشرت فيها الحمى بالخصوص تلك المجاورة للمستنقعات[18]". ويضيف تقرير أكتوبر 1865م :" أنّ الوضعية الصِحيَّة تركت نُقصا، الحمى المتواترة متواصلة في الحاق الضرر فقد مست العديد من أجزاء مستغانم، نسب الوفيات كبيرة جداَ في هذه الظروف، الإدارة تدخلت للمساعدة في حدود إمكانياتهاَ للأهالي الطبيب المكلف بمصلحة الصحة بالمكتب العربي حرصَ على صحة القبائل التي تضررت، بتوزيع حبوب الكانين Des pilules de quinine التي تمت بشكل واسع وبالشكل المُمكن، وبفضل هذه الرعاية وهذه النجدات للعديد من الأَهالي تمّ إنقاذهم من الوباء الذي أصبح في طريقه إلى الزوال".[19]
- المَديونية والقروض الربوية إذ يشير تقرير شهر أكتوبر 1866م " أنّ موسم الحرث قد بدأ مع أواخر 15 من شهر أكتوبر وقد وجد الأهالي أنفسهم في مأزق الحرثْ الذي شمل نطاقا ضيقاً، فالأهالي ليس لهم حبوب البذر والحصول عليها يستوجب عليهم تغطيتهاَ بالقروض الربوية بشروط مدمرة ففضل الكثير منهم عدم الحرث هروبا من هذه الأصناف من الديون[20]."
- عامل الجفاف الذي استمر لفترة طويلة والذي حال حسب تقرير شهر ديسمبر 1866 دون توسع عملية الحرث بالمنطقة مما آثار مخاوف الأهالي إذ لم تتهـــاطل الأَمطار سنة 1867م، ستكون سنة فاجعة كما كانت سنة 1866م [21]." وهذا ما انعكس على الانتــاج الفلاحي وأدَّى إلى تناقص في انتاح الحبوب بكافة أنواعها وقد أشار تقرير جويلية 1866م "أن القمح والشعير يجلب إلى الأسواق بكميات قليلة جدا، ما أدى إلى ارتفاع ثمنهِ خارج نسب المواردْ[22]." وتشير الوثائق الأرشيفية أنّ سوء الظروف أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية بالمنطقة جراء دمَار الحملة الفلاحية فقبائل المنطقة لا يمكنها الاعتماد على إنتاج مصادر أخرى كالمواشي مما تسبب في انتشار الأَمراض بسبب الجفاف الذي عصف بالبلاد[23]".
ورد في مراسلة بتاريخ 07 جوان 1877م تخص ملحقة زمـــورة أنّ انتاج الحبوب رديء وأنَّ البذر تم ّ في وقت مبكر وبسبب الجفاف لم ينتج شيئا ... ففي قبائل أولاد سويد والعناترة وفي الدواوير الأهلية (أولاد زيد قبيلة أولاد يحي) وبن عودة واد حامول ( لمحال) لا يوجد على الإطلاق شيء لا انتاج ولا رعي... وفي قبائل الحرارثة وبني درقن وأولاد سيدي أحمد بن محمد وأولاد بلحي وأولاد سيدي لزرق وأولاد سيدي يحيى بن محمد وأولاد سيدي يحيى وأولاد رافع، المحصول ناقص وفي عدد من الدواوير المردودية ستكون بنصف المحصول وفي القبائل الأُخرى من جيد إلى سيءْ[24].
مما جعل المحصول مفقودا في 05 قبائل أو دواوير أهلية وفي القبائل الثمانية الأُخرى نصف المحصول، إذ أثبتت المعلومات التي قدمها الزعماء الأهالي أن 10 قبائل بالملحقة لا يمكنها التزود بالحبوب في السنوات القادمة ، فعلى على سبيل المثال أشار التقرير أنَّ قبيلة أولاد راشد لا تحوز الامدادات الخاصة الكافية للبذر لبلوغ نهاية الشتاء. مما اضطر أهالي فليتا إلى بيع بعض مواشيهم لكي يتمكنوا من دفع ضريبة الزكاة التي يجب دفعها في الشهر الجاري من جوان 1877م، الأمر الذي دفع الزعماء الأهالي ووفق تعليمات الإدارة الكولونيالية إلى مساعدة الجزائريين المتضريين، و بأنّ الماشية لا قيمة لها في الأَسواق وأنَّه من الأفضل الحفاظ عليها لأكبر وقت ممكن. وأشار التقرير إلى أنّ الأهالي رؤوا أنّه إذا جاءت أمطار الخريف في وقتها بوفرة فإِن الأَزمة سيتم تجاوزها ولا تترك أثرا، في حين إذا حدث العكس وسقطت الأمطار متأخرة وبكميات قليلة فإن الوضعية تصبح أكثر انتقادا[25]. ما يعني أنّ الأهالي الجزائريين كانوا يعتمدون في عمليات السقي على ما تذره السماء من أمطار على غرار الأوروبـــي الذي دعم بشبكة ضخمة من الموارد المائية من خلال السدود ومدها بقنوات المياه التي تمّ تشييدها تحت ضغط شكاوي الكولون لري ملكياتهم الزراعية الواسعة على حساب تحويل المجاري المائية بما يخدم زراعتهم وهذا ما نقرأه في شكوى المعمر قورنـــاي (Gourany) بغليزان في رسالة موجهة إلى الحاكم العام بتاريخ 19-08-1862 حول نقص المياه بمحيط مينا من حيث التوزيع، والذي تعود أسبابه حسب الرسالة إلى إفراط الأهالي في استخدام المياه في الجزء الأعلى من واد مينا، وإلى استغلالهِ من طرف آهالي المنطقة المجاورة لمزرعتهِ ممّا أدى إلى تناقصهِ وتوقفهِ في الجزء الأسفل[26].
علما أنَّ الادارة الكولونيالية أخضعت في هذه السنة قبائل ملحقة زمورة إلى ضريبة الزكاة بحيث تم إحصاء 2.007 من الثيران و 17.477 من الخرفان و 2.709 من الماعز في حين احتوت مطامير التخزين للجماعة ما قيمته 7.230 هيكتولتير و 80 لتر. وأشار التقرير أن الوضعية الأخيرة تدل على أنَّ هذا الرقم ليس متنوع وأنه ستقدم دفعات للقبائل التي تفتقر للبذور الحرث وقروض بضمانات تقدم للفلاحين لسد حاجياتهم [27].
أمَّا في دائرة عمي موسى فقد تقرر أنَّ احتياطي الامدادات (approvisionnement) للأفراد متوفر بجدية لدى الخيم الجيدة فقط (les bonnes tentes ) في حين منعدم بالنسبة للخماسين والفلاحين، وأشار أَيضا أنًّ ظروفهم ستكون لسنة أو سنتان على الأًقل أكثر صعوبة وعدم الاستقرار خلال السنوات الست والثمانية الأخيرة من عام 1877م وأمام السعر المرتفع للحبوب والمغري أَشار إلى أنَّ ذلكَ من شأنهِ أَن يدفع بعض الفلاحين الأَغنياء إلى بيعِ جزء من احتياطاتهم [28]. في حين أَبدى تقرير حول عين كرمان (وادرهيو) بتاريخ 27 أفريل 1878م أنّ وضعية الآهالي غير مطمئنة على نقيض ما أعلنه الاداري، ذلك أنَّ المحاصيل مُنعدمة في 03 دواوير جزئية، يعادل ¼ من المحصول في 07 أخرى، و ½ في 21 دوار و جيدة في 07 دواوير، الأمر الذي دفع الادارة الكولونيالية إلى العمل على اتخاذ إجراءات احتياطية فيما يتعلق بالدواوير الثلاث أين المحصول بالكامل منعدم وفي 07 دواوير الأهلية حيث لديها ربع المحصول[29].
- الضرائب الثقيلة والمجحفة في حق الجزائريين الأهالي والجدول التالي يبين قيمة الضرائب التي فرضت على قبائل المنطقة:
|
1897 |
1867 |
القبيلة |
|
34.840 فرنك |
29.163 فرنك |
أولاد العباس |
|
17.030 فرنك |
11.950 فرنك |
أولاد أحمد |
|
29.824 فرنك |
22.904 فرنك |
عكرمة الشراقة |
|
26.268 فرنك |
14.404 فرنك |
المحال |
|
7.584 فرنك |
9.217 فرنك |
أولاد سلامة |
|
19.049 فرنك |
30.214 فرنك |
أولاد خويدم |
|
13.465 فرنك |
15.783 فرنك |
اولاد سيدي بوعبد الله |
Source- Lecq. M.H, Commission d’Etude des améliorations à apporter dans la Situation Agricole de la vallée du Chéliff, Rapport à Monsieur le Gouverneur Général de l’Algérie, Alger, Imprimerie Orientale, 1898.pp, 122,123.
فمن خلال قراءة الجدول الاحصائي يتبين لنا ارتفاع قيمة الضرائب ما بين سنتي 1867 و 1897 ويدخل هذا ضمن سياسة إفراغ جيــــوب، بهدف تدمير البنى الاجتماعية والاقتصادية وإزاحة السكان بكل الأساليب عن السهول والمناطق الزراعية فالإضافة إلى ذلك كان للوجهاء نصيب منها من القياد والآغاوات مقابل 10 بالمائة من الضرائب المحصل عليها ، إلى جانب الاستفادة من أَعمال السخرة والتويزة في أراضيهم ونقل منتجاتهم مما مكّن القيادات المحلية من تجميع ثروات نقدية كبيرة[30].
الجدول التالي يَعرض وَضعية المحَاصيل في اقليم البلدية المختلطة وادرهيو (Inkermann) 24 أفريل 1878:
|
أسما الدواوير |
اسماء المشاتي |
وضعية المحصول |
|
القيايبة Kiaiba |
- القصارة. - العجاونية - العواشيش - أولاد سلطان - أولاد خنار |
- منعدم نهائيا - نفسه - نفسه - ¼ من المحصول - نفسه |
|
أولاد عدي Ouled Addi |
- المعايزية - السوايمية - قدايشية - الشراطنية - زارة - مخاطرية - مفاتحية |
- ½ من المحصول - نفسه - نفسه - محصول جيد - محصول سيء - ½ من المحصول - نفسه |
|
الجرارة Djerara |
- الطراميل - حساين الجرارة - ماجن بن طاهر - أولاد عابد - العوايشية - أولاد شنة |
- ½ من المحصول - نفسه - نفسه - نفسه - نفسه - نفسه |
|
الحمادنة Hamadena |
- مشتة خدام سيدي علي - حساين البرايجية - السوالم - الشكايرية - أولاد بن والي |
- ¼ من المحصول - ½ من المحصول منعدم في الجبال - ¾ من المحصول - محصول جيد في السهول وسيء في الجبال. - ½ من المحصول. |
|
عبد القوي Abd El Goui |
- أولاد المداح - الزناينية - أولاد بن عودة - مجايدية - دوار أولاد عابد - الرتايمية - العواينية - عبد الدايم - أولاد بوجلة |
- ¼ من المحصول - نفسه - محصول جيد. - محصول جيد - محصول جيد - ½ من المحصول - نفسه - نفسه - ¼ من المحصول. |
|
مرجة قرقر Merjat El Gargar. |
- السلاطنة - سيدي عابد ولد الحاج احمد - الخنايق - الغرايب - جديات - دراهمية |
- ½ من المحصول - نفسه - نفسه - ¼ من المحصول - محصول جيد - محصول جيد. |
Source : A.N.O.M, 14H37, Famine 1868, état présentant la situation des récoltes à la date du 24 avril 1878,dans le territoire de la commune mixte d’Inkermann, l’administrateur signé, Guérin.
تراجع الأنشطة الاقتصادية التقليدية كالحرف والنشاط التجاري في بعض الحواضر
إذ يسجل الجيلالي صاري :" تزايد النمو السريع للهجرة سنة 1896م في منطقة مازونة كنتيجة لتراجع الحرف والنزوح إلى الأحياء الهامشية[31]". وهو العرش الذي اقتطعت منه 2.700 هكـ لتأسيس المركز الاستيطاني سيدي أمحمد بن علي (Renault)، وخلال تطبيق قانون فارني 1873م تسبب ذلك في عزل المدينة اقتصاديا جراء محاصرتها بالمراكز الاستيطانية وإبعادها عن شبكة المواصلات فمنعت التجارة والحرف رغم إرادة تجارها ومثابرة حرفييها في ظل الانحطاط القاتل[32]. مما تسبب في الهجرة الداخلية إلى المناطق الأخرى إلى سهل الشلف وغليزان ومستغانم[33].
- اختراق النظام الاقتصادي الرأسمالي للسوق للاقتصادي التقليدي الجزائري، إذ كان النظام السائد قبل الوجود الاستعماري قائم على تخزين الحبوب في المطامير لمواجهة التغييرات المناخية والاضطرابات السياسية التي قد تهدد وجود الفرد والقبيلة، مما يضمن الاكتفاء الذاتي غير أن افراغ مطامير بني وراغ وأولاد صابر والقبائل المحيطة بالمطمر (Les Silos) نتيجة المضاربات الربوية والدخول في الاقتصاد النقدي داخل القبائل مما أَجبرهم على بيع احتياطاتهم التقليدية مما يتسبب في حالة المحصول السيء وضعاَ متزعزعا عند شراء ما ينقصهم من الحبوب ونلاحظ هنا يذكر بن آشنهو أنّ أية ظاهرة ستكون ذات اتساع كبير في سنوات المحصول السيءْ[34]. الأمر الذي أدى بالفلاح الجزائري إلى عجزه عن مواكبة التغيرات في ظل تحول الأرض إلى مجرد سلعة تجارية :" فقد قاد الفلاح الجزائري إلى مواجهة كل الضغوطات من دون سند خارجي، ويختفي الاحتياطي الجماعي من الحبوب ويخضع الفلاح صاحب القطعة المجزأة إلى التغييرات المناخية وبالتالي يتعرض للربا وانتزاع الملكية منه[35].
و كنتيجة لسياسة التفقير (La politique d'appauvrissement) التي أدت إلى التقهقر الديمغرافي وتغير الخريطة السكانية وزوال قبائل بأكملها، وكنتيجة للفاقات ومعارك البطون الجائعة بالمنطقة يذكر تقرير ديسمبر 1866م : " أنّه بسبب المأساة الكبيرة التي اجتاحت البلاد، انتشرت السرقات بشكل كبير ومن ذلك أنّه في ليلة 04 إلى 08 ديسمبر 1866 حدثت سرقات شملت 140 مقياس شعير لصاحبها الجيلالي قدور من قبيلة عكرمة الغرابة تمّ إفراغها كلها[36]." كما توالت عمليات السطو على المطامير المملوكة للقياد والكولون على حد سواء لإشباع البطون ففي جلسة 17 ديسمبر 1866 أعلنت اللجنة التأديبية (La commission disciplinaire) أنّ بن عودة بن دالي من العناترة ومحمد بن عمار والحاج ولد محمد بن عمار من أولاد يحي متهمين بسرقة مطامير الشعير، وقد تمت معاقبتهم بـ 06 أشهر بالنسبة للإثنان الأولين والثالث بـ 08 أشهر بالسجن العقابي ببوخنافيس (بسيدي بلعباس) وتم فرض 60 فرنك كتعويض للأضرار لأحمد ولد سيدي محمد بن بركات[37]. ومن خلال قراءة الجلسات التأديبية لقسمة مستغانم التي أعدت للجزائريين أنَّ أغلب القضايا متعلقة خلال هذه الفترة بالسرقات التي خصت الحبوب والمواشي ففي جلسة بتاريخ 07 إلى 17 ديسمبر 1866م أعلنت عن الأحكام التالية:
*-صيهوب ولد الحاج قدور بن سيدي علي وعابد ولد الغول وعابد ولد سيدي غلام الله من أولاد سيدي بوعبد الله اعترفوا بذنب سرقة الشعير وعوقبوا بسجن 06 أشهر بالمؤسسة العقابية ببوخنافيس مع دفع غرامة مالية بـ 60 فرنك كأضرار لسي طاهر ولد حاج عابد من نفس القبيلة.
*-المليود بوعزة وقدور بن خيرة وعبد الله بن غالي من عكرمة الغرابة اعترفوا بالإجماع بسرقة اثنان من الأبقار عوقبوا الاثنان الأوَّلان بسنة سجن والأخير بـ 03 أشهر سجن في المؤسسة العقابية ببوخنافيس ودفع غرامة مالية قدرت بـ 100 فرنك كأضرار لسي أحمد بن عبدة من نفس القبيلة .
*-أحمد بلعربي من أولاد إسمر وبوعبد الله بلعربي اعترفوا بالإجماع على سرقة 10 خرفان عوقبوا بـ 06 أشهر من السجن بالمؤسسة العقابية ببوخنافيس، كما اقترح التعويض المالي بـ 80 فرنك تعويضا عن الأضرار لمحمد بلحاج من أولاد إسمر[38].
الخاتمة:
إنّ الوقائع التاريخية المستقاة من وثائق وكتابات الفرنسيين أنفسهم أشارت إلى الإنجازات التي أقيمت هنا وهناك واصفين إياها بالفعل الحضاري، غير أنّ الواقع يقول بنقيض ذلك فلقد شهد المجتمع المحلي بالمنطقة المدروسة جراء التواجد الهمجي للقوات الاستعمارية منذ البداية تغيرات سلبية جـــذرية، أثرت على البينة الاجتماعية والاقتصادية نتيجة سياسة الأرض المحروقة وسلب العقار بصيغ مختلفة، ناهيك عن حصيلة الضحايا التي ما فتئت ترتفع وسط السكان العزل بالخصوص في مثلث الظهرة والونشريس وفليتا، فلم تسلم قبائل المنطقة التي طبقت عليها كل أشكال القمع والقهر بما في ذلك القوانين الزجرية لتحقيق الأهداف الكولونيالية ، وطبيعي جدا ردة فعل القبائل القوية بالمقاومة الفردية و الجماعية كلما سنحت الفرص بذلك خلال التوغل الاستعماري، مما تسبب في إعاقة المشاريع الكولونيالية التوسعية في المنطقة خلال فترات متقطعة، ولمّا أدركت السلطات الاستعمارية أنّ القبائل هي ذخيرة الانتفاضات في منطقتي مينا وسهل الشلف وضعت استراتجية استهدفت تضييق الخناق عليها وفق منطق التخويف لأجل التطويع وإفلاسهم اقتصاديا وماليا، لإضعافهم على المدى البعيد حتى يتسنى لها القضاء على الانتفاضات وتنفيذ المشاريع الاستيطانية، الأهداف التي تكررت في رسائل القادة العسكريين والمدنيين خلال كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة طالبين من قادتهم تجسيدها وهو ما يجعلنا نجزم بالمسؤولية التاريخية عن تلك الممارسات البربرية الملقاة على عاتق فرنسا ككيان سياسي وكدولــــة.
دفتر العقاري ودور في الحماية القانونية للملكية العقارية
كريمة برني
الجامعة:جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
الملخص:
يعد القطاع العقاري واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة في أية دولة كانت، وذلك نتاج لجملة من العوامل التاريخية والاقتصادية والاجتماعية وارتباطه بمختلف القطاعات الاقتصادية وتأثره بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة محليا و إقليميا وعالميا.
ومن جهة، يعتبر العقار الركن الهام في أية تنمية اقتصادية، باعتباره الحاضن للنشاط الاقتصادي، مما تترتب عليه أن تولي له الدولة أهمية إستراتجية حال رسمها للسياسة التشريعية المنظمة له،الأمر الذي يؤدي إلى القول أن نجاح أو فشل تلك السياسة مرتبط طرديا بنسبة تحقيقها للتنمية الاقتصادية، لكن بالرغم من وجود القانون العقاري والأحكام التي جاء بها إلا أن الواقع استغلال العقار من ناحية العملية فرضا نمطا آخر.
ولقد كانت هذه الفكرة محل تبني وتطبيق من قبل الدولة الجزائرية خلال 50 سنة من الاستقلال،انتقلت فيها الجزائر من أنظمة قانونية إلى أخرى مستجيبة لذلك لحاجات التنمية الاقتصادية المتطورة.
و تعتبر الملكية العقارية أساس تقدم ورقي الحضارات الإنسانية لمل لها دور في التنمية عموما والتنمية العمرانية على وجه الخصوص فلا يمكن التحكم في التنمية الاقتصادية دون وجود تنظيم وتوجيه للاستثمارات العقارية.
وقد حضيت الملكية العقارية الخاصة باهتمام المشرع الجزائري، وكرسها دستور 1996 من خلال نص المادة 52 التي تنص على أن "الملكية الخاصة مضمونة" كما تضمنها قانون التوجه العقاري 90/25 من خلال نص المادة 28، وعرفها في نص المادة 27 منه[1] ، وقد بين هذا القانون الأملاك الوطنية العقارية، والملكية العقارية الخاصة، وتصنيف الملكية والقيود التي ترد عليها، فيهدف هذا القانون إلى استقرار الملكية العقارية وتوجيه كيفية استخدامها واستغلاله[2]
كما تطرق المشرع لتعريف حق الملكية في نص المادة 674 من قانون المدني الجزائري" الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمله استعمالا تحرمه القوانين[3] والأنظمة."
وتبدو جليا أهمية هذه الدراسة من خلال تبيان الآليات القانونية التي يمكن استخدامها لإثبات الملكية العقارية الخاصة في ظل النظام الشهر العيني وفق القانون الجزائري، والتي بادرت بها الجزائر و خولت لكل حائز لعقار لم تشمله بعد عملية المسح الحصول بفضل هذه الوسائل القانونية على سند الملكية "دفتر العقاري" التي تعود نشأة تسليمه مرتبط ارتباطا وثيقا بإتمام عمليات المسح العام[4]وهذا ناجم عن إرادة المشرع في تطهير الوضعية العقارية في البلاد.
من هذا المنطلق، فإن الإشكالية التي أود إثارتها في هذا الورقة البحثية المتواضعة، والنقطة التي تحتاج إلى تمحيص وتحليل،إلى أي مدى يمكن اعتبار الدفتر العقاري كآلية إثبات للملكية العقارية في الأراضي المسموحة ؟، وما مدى حجيته في الإثبات أمام القضاء أو الجهات الإدارية في الدولة؟.
وللإلمام بهذه التساؤلات سنحاول تسليط الضوء على أهمية الدفتر العقاري في الإثبات وذلك بعد التطرق لكيفية الحصول عليه وتعريفه ومضمونه وإبراز طبيعته القانونية في" المبحث الأول"ثم نعرج في دراسة " المبحث الثاني" حجيته في إثبات الملكية العقارية ثم نختمها بأهم التوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.
المبحث الأول: ماهية الدفتر العقاري
إن موضوع الدفتر العقاري لم ينل بعد الكثير من الاهتمامات من قبل المختصين ومزال يحيطه الكثير من الغموض، لذا سأتناول في هذا المبحث إلى مفهوم دفتر عقاريومضمونه في ( المطلب الأول ) ثم نعرج لدراسة الطبيعة القانونية للدفتر العقاري في( المطلب الثاني).
- إن المشرع الجزائري بعد الاستقلال، في إطار إعادة تنظيم الملكية العقارية واستقرارها وتطورها وفق ما تقتضيه التنظيمات العقارية الحديثة صدر الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقار[5] وقد عرفت المادة الثانية منه مسح الأراضي العام" بأنه يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات، وهوية المالك الظاهر للعقار وأصحاب الحقوق العينية، كما عرفت المادة 03 من نفس الأمر أن السجل العقاري هو يضبط الوضعية القانونية للعقارات، ويبين الحقوق العينية العقارية، والسجل العقاري هو المرآة العاكسة لكل عقار والتغيرات التي تطرأ عليه مهما كانت نوعها، وبهذا أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العيني، بدل الشهر الشخصي[6].
المطلب الأول: مفهوم الدفتر العقاري
لم يتطرق المشرع الجزائري في الأمر رقم 75/74 ولا في المرسوم التنفيذي رقم 76/63 المؤرخ في 05/03/1776 المتضمن تأسيس السجل العقاري[7] ولا في التعديل الذي لحقه لإعطاء مفهوما دقيقا، وعليه نتطرق له في الفرع الأول من خلال تعريف دفتر العقاري وبيان مضمونه في الفرع الثاني.
الفرع الأول: تعريف الدفتر العقاري
يستمد الدفتر العقاري وجوده القانوني من مرسوم التنفيذي 73/32 المؤرخ في 05/01/1973 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، لا سيما في المادة 32 منه والتي تعتبر كشهادة ميلاد للدفتر العقاري وتنص:تستبدل شهادات الملكية بدفاتر العقارية بمجرد إحداث المسح العام للأراضي البلاد المنصوص في المادة 25 من الأمر 71/73 المؤرخ في 08/11/1971.
كما نصت المادة 33من نفس المرسوم: إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث يشكل حسب الكيفيات التي ستحدد في نصوص اللاحقة المنطلق الوحيد لإقامة البينة في شأن الملكية العقارية، وبموجب الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الصادر بتاريخ 12/12/1975 في القسم الثاني منه تم التطرق للدفتر العقاري في المادتين 18و19 بنصيهما:
المادة 18: " يقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر العقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية."
المادة 19: "تسجل جميع الحقوق الموجودة على العقار من وقت الإشهار في سجل العقاري وفي دفتر العقاري الذي يشكل سند الملكية".
والمرسوم التنفيذي رقم 76/63 المعدل بالمرسوم رقم 93/103 المتعلق بتأسيس السجل العقاري والذي نظم من خلال المواد من 45 إلى 54 الدفتر العقاري الصادر بتاريخ 25/ 03/1976، ومن ثم وبعد استقراء النصوص القانونية يمكن إعطاء تعريف دفتر العقاري "عبارة عن سند إداري يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم بعد انتهاء من عملية المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري يسلم إلى مالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة وهذا السند محدد بموجب نموذج خاص بالقرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ17/05/1977 وهو يعبر عن الوضعية القانونية الحالية للعقارات".
ومنخلال تعريف تبين لنا عدة خصائص:
ينشأ الدفتر العقاري بعد انتهاء من عملية المسح العام الأراضي وتأسيس السجل العقاري،
يسلم دفتر العقاري للمالك الذي ثبت حقه على العقار الممسوح لعد إنشاء بطاقة عقارية تظهر الوضعية القانونية للعقار المعني.
دفتر العقاري يكون مطابق للنموذج المحدد بموجب القرار الوزاري وعملية إعداده وكيفية التأشير عليه محددة بنص قانوني، وبالرجوع إلى نص المادة 45 فقرة 01 من المرسوم رقم 76/63 المعدل والمتمم، نجد أن المشرع الجزائري قد ترك للوزير المكلف بالمالية مبادرة وتجديد نموذج الدفتر العقاري كما ترك للإدارة المكلفة بمسك الدفتر العقاري[8] إمكانية إعداد دفتر العقاري بواسطة استنساخ أو تصوير.
دفتر العقاري سند للملكية العقارية وهذا ما جاءت يه المادة 19 من الأمر 75/76 والمادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 73/32 المؤرخ في 23/01/1973، المذكور أعلاه
ومن خلال هذه التعاريف يمكن القول أن الدفتر العقاري لا يسلم إلا للمالك الذي يثبت حقه بعد الانتهاء من عملية المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، وأنه لا يمكن للشخص إثبات ملكيته العقارية مهما كان نوعها بالأراضي الممسوحة إلا عن طريق الدفتر العقاري الذي يعتبر سند وحيد لإثبات الملكية العقارية، وهذت ما أكدت عليه المادة 19 من الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
الفرع الثاني: مضمون دفتر العقاري وكيفية إعداده
أولا: مضمون الدفتر العقاري
إن دفتر العقاري يعد الوثيقة إدارية تسلم بقرار من محافظ العقاري وهو موظف الذي أوكلت لع مهمة مسك السجل العقاري عكس ما هو جاري به العمل في معظم الدول التي تستعمل النظام الشهر العيني والتي أسندت مهمته إلى قاضي من قضاة المحكمة وهو قاضي العقاري[9].
ويتميز بأن وجوده مقترنا دائما بعملية المسح العام للأراضي ويسلم بعد إيداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة عقارية تنفيذ الإجراءات الأولية الخاصة بترقيم العقارات.
بالرجوع إلى نموذج دفتر العقاري المحدد بموجب قرار من وزير المالية حسب ما نصت عليه المادة 45 من المرسوم 76/63 نجده يشتمل على إطار علوي و06 جداول، فالطابع عبارة عن مجموعة من البيانات المعرفة للعقار المخصص له الدفتر ويتضمن البلدية، القسم، مجموعة الملكية، سعة المسح.
أما بالنسبة للجداول، الأول تعين فيه مجموعة الملكية مع ذكر النطاق الطبيعي( الموقع، المساحة، عدد القطع المكونة...).
أما الثاني يتعلق بتلك الإجراءاتالأولية لشعر الحقوق العقارية، وكذا جميع التصرفات العقارية على العقار، وينم فيه تعيين المالك أو المالكين من حيث هويتهم( الاسم، اللقب، المهنة، الجنسية...) أما الجدول الثالث فتسجل فيه جميع الإجراءات المتعلقة بالاشتراكات بالفاصل مع الارتفقات الايجابية والسلبية لمجموعة الملكية العقارية مع ذكر مراجع إشهارها في الخانة المقابلة لها، كما تؤثر فيه جميع التغيرات أو النشاطات التي تلحق بالحقوق المشهرة[10].
الجدول الرابع يتضمن مجموع الحقوق المشهرة المتعلقة بالتجزيئات والأعباء، مثلا حالة التجزئة إلى قسمين تؤشر فيه كل الامتيازات و الرهن على مجموعة الملكية.
بينما الجدول الخامس يخص تأشيرة التصديق والتي من خلالها يصادق المحافظ العقاري وتحت مسؤوليته على أمرين:
الأمر الأول: هو التصديق على تاريخ تسليم هذا الدفتر لمالك
الأمر الثاني: هو التصديق على تطابق التأشيرتان المتباينتان في هذا الدفتر مع البطاقة العقارية الموافقة له، ويتم التصديق عن طريق وضع الخاتم الرسمي للمحافظة وتوقيع المحافظ[11].
ثانيا: كيفية إعداد الدفتر العقاري
إن تأسيس الدفتر العقاري يكون انطلاقا من عملية المسح العام للأراضي والتي تجد لها أساسا قانونيا في المادة 02 من الأمر رقم 75/74 المتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، حيث أن الهدف من عملية المسح هو تحديد النطاق الحقيقي والطبيعي للعقارات، وتقوم على طرق وقواعد هندسية وإقامة مخططات لها، وبذلك يكون الأساس المادي للسجل العقاري والبطاقات العقارية المكونة له[12]، ولكون أن عملية المسح عبارة عن أعمال مادية وأخرى قانونية، فإنها تمر بعدة إجراءات في إطار ما نص عليه الأمر رقم 75/74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
وعليه،يتم إعداد أي تشريع وخاصة التشريع العقاري على أساس قواعد وأسس دقيقة ومتينة، وهدا راجع إلى إتباع عدة طرق ووسائل مادية وبشرية لكي يتم تجسيدها على أرض الواقع وذلك مرور بمرحلتين هما: مرحلة التحضيرية والمرحلة الميدانية[13].
1/ المرحلة التحضيرية:
تتم هذه الإجراءات عن طريق جمع الوثائق اللازمة والضرورية وذلك بواسطة التحري وإعداد الخريطة المتعلقة بالبلدية المعنية والمنجزة من طرف المعهد الوطني للخرائط التي يتم بواسطتها تنسيق جميع الجهود لأجل جمع كل المخططات والتصاميم اللازمة والضرورية.
كما يتم أيضا جمع كافة الوثائق المتواجدة على مستوى جميع المصالح المحلية والتي يمكن جمعها وحصرها في الوثائق المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة والهيئات المحلية، المتواجدة لدى البلديات والمصالح العمومية والمؤسسات الإدارات العمومية[14].
أولا:افتتاح عملية المسح العام للأراضي
إن عملية المسح العام للأراضي أو عملية المسح العقاري هي تلك العملية الفنية والقانونية التي تهدف إلى وضع هوية العقار عن طريق تثبيت وتحديد مواقع العقارات، وتحديد أوصافها الكاملة وتعيين الحقوق المترتبة عليها والتعريف بالأشخاص المترتبة عليهم الحقوق.
تخضع جميع الأملاك العقارية دون استثناء سواء كانت خاصة أو عامة إلى عملية المسح وذلك على كل تراب الوطن وهذا ما نصت عليه المادة 04 من الأمر رقم 74/74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والتي جاءت في ما يلي" يتم على مجموع التراب الوطني تحديد الملكيات قصد إعداد مخطط منظم وتأسيس مسح للأراضي[15].
ثانيا:إنشاء لجنة المسح
بمجرد افتتاح عملية المسح على مستوى البلدية تتم أنشاء لجنة المسح و تتشكل هذه اللجنة من عدة أعضاء مكلفة بمهمة المسح و تحديد مهامهم وهذا حسب المادة 07 التي تحدد تشكيلية لجنة المسح للأراضي(36) و تتكون هذه الجنة من :
_ قاضي من المحكمة التي توجد ضمن دائرة اختصاصها و هو يقوم برئاستها.
- تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من يمثله ويكون نائب الرئيس .
- موثق يعين من طرف الغرفة الجهوية للموثقين، و يكون له دور أساسي في عمل المسح العقاري وحضوره ضروري عند افتتاح هذه العملية[16].
- ممثلا عن إدارة الأملاك الوطنية أو أملاك الدولة الذي يعمل على تجسيد أهداف عماية المسح إضافة إلى التحقق من عدم المساس بالأملاك الوطنية التابعة لأملاك الدولة.
تمثل مهام اللجنة وفقا لنص المادة 06 من المرسوم 92/134 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 76/62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام بما يلي:
- جمع الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية.
- التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم وفي حالة عدم وجود اتفاق،محاولة التوفيق بينهم .
- البث بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على إثر عمليات معاينة صحة الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم تسويتها بالتراضي.
2/ المرحلة الميدانية
إن عملية التحقيق تهدف إلى ضبط الإجراءات الأولية حيث من خلالها تحقيق للحالة العقارية في جوانب الطبيعية والقانونية، وهي تهدف إلى جمع والتقاط كل العناصر الضرورية لمعاينة حق الملكية والحقوق العينية الأخرى، وجمع المعلومات المتعلقة بتعريف هوية ذوي الحقوق وتطبيقها.
أولا: التحقيق الميداني
يتولى الأعوان المكلفون بمهمة التحقيق العقاري معاينة أصحاب الحقوق والقيام باستدعائهم سواء المالك الظاهر أو صاحب الحق وسواء أشخاص طبيعيين أو معنويين.
ويكون تعيين الأشخاص بطبيعتهم إذا كانت شركة أو جمعية بتحديد هويتها وذلك بتقديم اسمها، وطبيعتها القانونية. مقرها الاجتماعي، وقانونها الأساسي، أما إذا كانت تابعة للهيئات المحلية فجيب بيان إذا كانت بلدية أو ولاية، أما إذا كانت تابعة للهيئات الوطنية فيجب ذكر اسمها ومقرها، بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية وترقيم العقارات في السجل العقاري ترقيما نهائيا بمجرد استلامه وثائق المسح مما يخول للمالك الحق في الحصول على الدفتر العقاري وهكذا يتم تعين الملكية وإثباتها لكن بشرط وجود عقود أو سندات لإثبات حق الملكية[17].
تقوم مصلحة المسح العقاري أثناء التحقيق بفحص المعلومات التي توجد على السند المقدم من طرف الملك وجمع أقوال وتصريحات الأشخاص المعنيين وإثارة كل المعلومات التي قد تنير التحقيق ومقارنة هذه المعلومات ميدانيا بتلك الموجودة على مستوى أرشيف المحافظة العقارية الموجودة على مستوى إدارة أملاك الدولة والوثائق الأخرى المجمعة أثناء الأشغال التحضيرية وإعداد بطاقة التحقيق العقاري.
ثانيا: إيداع وثائق المسح لدى مقر البلدية
بمجرد الانتهاء من العمليات التقنية والتحقيقات العقارية وإعداد الوثائق، نودع وثائق المسح الأراضي بمقر البلدية لمدة شهر على الأقل لتمكين الجمهور وكل شخص معني بعملية المسح من الاطلاع عليها، وتسلم الوثائق من طرف رئيس مكتب المسح إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يسلمه شهادة الإيداع، ويلاحظ أن النص تناول الإيداع ولم يوجب إعلانه بشكل صريح كما أنه تناول مدة الإيداع ولم يضبطها بدقة رغم ما لهذه العملية من أهمية مما يترتب عليها آثار قانونية،إذ أن انتهاء هذه المرحلة يجعل نتائج المسح بما فيها المخططات المنجزة والبيانات التي تحتويها نهائية، وأهمية الإعلان تكمن في أنه يؤدي وظيفيتين الأولى في إعلام المعنيين بانطلاق هذه المرحلة والثانية أن يكون أساسا لبدء حساب مدة الإيداع[18].
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعلان الجمهور عن طريق إشعار ممضي من طرفه وينشر في الأماكن المعتادة للبلدية والبلديات المجاورة وكذا الوسائل أو الإعلانات الكتابية أو الشفوية[19].
3/ الإجراءات القانونية:
بعد استكمال الإجراءات المادية لإعداد الوثائق اللازمة لعملية المسح يتم إيداعها لدى المحافظة العقارية والتي تقوم بإجراءات أهرى تتمثل أساسا في الإجراءات القانونية المتشكرة في تأسيس السجل العقاري ليتم فيما بعد تسليم الدفتر العقاري ومدى حجيته في الإثبات وهذا ما سنتطرق له بشيئ من التفصيل في النقاط التالية:
أ- تأسيس السجل العقاري:
المشرع الجزائري لم يأتي بتعريف السجل العقاري وإنما عرفه المشرع المصري بأنه" مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كال عقار وتبين حالاته القانونية، وينص على حقوقه المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به[20].
أما المشرع الجزائري فقد نص في نص المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري على بيان كيفية مسك السجل العقاري بالإشارة إلى نص المادة 13 من الأمر رقم 75/74 المتعلق بإعداد مسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري التي تنص بأنه يمسك مجموعة البطاقات العقارية التي تبين الوضعية القانونية للعقارات، وتبين تداول الحقوق العينية ويجب أن يكون مطابقا للمخطط الفتوغرافي ووثائق المسح بصورة مطلقة حتى تكون الناطق الطبيعي فيما يتعلق بالحقوق العينية والارتفاقات وتعديلات على حالة العقار.
ب-إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية
تتم عملية إيداع الوثائق والبيانات التي تم جمعها عند القيام بعملية المسح لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا بعد انتهاء من الإجراءات المسحية لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدية المعنية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية وشهرها في البطاقات العقارية التي يتم إعدادها لتكوين السجل العقاري، حيث تثبت هذه الوثائق في محضر يسلم للمحافظ العقاري مقابل وصل استلام ويتم شهر هذا المحضر في أجل 8أيام[21].
يمنح لكل ذي مصلحة أجل 04 أشهر للإطلاع على الوثائق خلال عملية المسح وتقديم الاعتراضات بشأنها، وإيداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح أو أنها لم تتم قبولها من خلال هذه الأخيرة وتشكل هذه العملية همزة وصل بين الإدارة المسح والمحافظة العقارية والتي من خلالها يشرع المحافظ العقاري في الترقيمات العقارية .
- الترقيم العقاري: إن عملية الترقيم تبدأ من يوم إيداع الوثائق المسح لدى المحافظة العقارية ويعتبر الترقيم قد تم من يوم الإمضاء على المحضر التسليم وثائق المسح، وفقا لنص المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم[22]. وهو يكون في حالتين الترقيم المؤقت والترقيم النهائي.
- إنشاء البطاقات العقارية: تعتبر البطاقات العقارية من الوثائق الأساسية المكونة للسجل العقاري، فهي وثيقة مطابقة لنماذج محددة بمقتضى قرار وزير المالية، ويقوم المحافظ العقاري بإنشاء البطاقة العقارية بحيث تحتوي كل بطاقة عقارية على مجموعة تبين الحالة المادية والقانونية للعقار، وتعمل هذه الأخيرة على تشجيع المتعاملين في العقار وتوفير الحماية والإئتمان، وهي تخضع لعملية التأشير وعي نوعين:
- بطاقات عقارية عينية وهي التي تعد بعد إتمام عملية المسح العام للأراضي.
- بطاقات عقارية شخصية وهي ذات طبيعة مؤقتة لأنها أعدت خصيصا للعقارات والحقوق العينية الي لم يتم مسحها.
ج- تسليم الدفتر العقاري
عند الانتهاء من عملية المسح العام للأراضي لجميع الإجراءات القانونية والتأكد من صحة الوثائق المسحية، يتم بعد ذلك تسليم الدفتر العقاري لمن له الحق في الملكية حتى يكون لع حجية في الإثبات.
يمنح الدفتر العقاري إلى مالك العقار عند إجراء الإشهار الأول الذي يحمل بيانات البطاقة العقارية لذلك فإن الدفتر العقاري يسلم إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطلقة عقارية مطابقة، وفي حالة الشيوع يودع لدى المحافظة العقارية دفترا واحدا ما لم يقوموا بتعيين وكيل لهم لحيازة الدفتر[23].
أما في حالة الضياع يحق للمالك الحصول على الدفتر العقاري آخر يؤشر في البطاقة العقارية وهذا وفقا لنص المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
وبالتالي فإن تسليم الدفتر العقاري يختلف باختلاف من له الحق في الملك سواء كان إنفراديا أو ملك على الشياع، أما فيما يتعلق بالملك الانفرادي فإنه يسلم إلى صاحب الملك بصفة شخصية و وإذا كان ملك الشياع فإنه يسلم إلى وكيل الذي يعين بموجب وكالة قانونية، أين يؤشر المحافظ العقاري على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار،لأن منح الدفتر العقاري لصاحب الحق له حجية في إثبات ملكيته.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للدفتر العقاري
يعتبر الدفتر العقاري من ضمن الأعمال الإدارية التي تختص بها المحافظات العقارية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة المالية على مستوى الأقاليم،أما بالنسبة للطبيعة القانونية للدفتر العقاري فقد اختلف الفقهاء والباحثون في تحديدها فمنهم من يعتبر الدفتر العقاري قرارا إداريا ( الفرع الأول) ومنهم من يعتبره عقدا إداريا (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الدفتر العقاري قرار إداري
لقد حضي موضوع القرار الإداري باهتمام العديد من الفقهاء، كما أسهم أيضا في الكشف عن ملامحه، ولقد تعددت التعاريف بشأنه بحيث أن هناك من يعرفه على أنه" إفصاح الإدارة عن إرادته الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين بابتغاء المصلحة العامة [24].
دفتر العقاري عبارة عن قرار إداري، يرى بعض أن دفتر العقاري عبارة عن قرار إداري إذ تنطبق عليه عناصر القرار الإداري يحث يعد أنه تصرف إداري الذي يخضع في تحديده للشكل المحدد قانونا.
صادر عن هيئة إدارية (محافظة العقارية)، يترتب عليه أثر قانوني يتعلق بحق الملكية.
وبالرجوع إلى كيفية إصدار الدفتر العقاري نجد أنه لا يعد إلا أن يكون قرارا إداريا على أساس أنه تصرف قانوني صادر من طرف المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وهذا ما يمكننا من استنباط بعض الخصائص[25]:
أ- الدفتر العقاري صادر عن جهة إدارية، يعني أنه يصدر عن المحافظة العقارية والتي تعتبر مؤسسة عمومية إدارية تقدم خدمة عامة وذلك حسب ما حددته المادة 02 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة [26].
ب- الدفتر العقاري يصدر بالإرادة المنفردة، ما يؤكد ذلك هو عدم وجود توقيع وبصمة المستفيد من الدفتر العقاري، وبالتالي فإن هذا الأخير يعتبر قارا إداريا يبعد كل البعد عن العقد الإداري الذي يجب أن يكون ممضيا من مصدر الدفتر العقاري والمستفيد منه، فالدفتر العقاري صادر بالإرادة المنفردة ويحمل توقيع المحافظ العقاري لوحده.
ج- الدفتر العقاري يحدث آثارا قانونية تجاه المستفيد منه، بمجرد استلام الدفتر القانوني يكون المالك متمتعا بكافة الصلاحيات في المال العقاري، ولقد تم تكريس هذه الخاصية في نص المادة 33 من المرسوم 73/32 المتعلق بإثبات الملكية العقارية وهذا المرسوم ملغى ضمنيا بموجب القانون رقم 90/25 المؤرخ في 12/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري معدل والمتمم، إضافة إلى نص المادة 19 من الأمر رقم 75/74 المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري بحيث تسجل جميع الحقوق الموجودة على العقار مت وقت الإشهار في السجل العقاري في الدفتر العقاري الذي يشكل سند الملكية[27].
الفرع الثاني: الدفتر العقاري عقدا إداريا
دفتر العقاري ليس قرار إداري، وهو ما يراه جانب آخر من الفقه كون دفتر العقاري لاتنطبق عليه عناصر القرار إداري إذ أنه يعد عملا انفراديا، كما أنه لا يحدث أثر قانوني بل أن دوره كاشف للمراكز القانونية فقط. ويرى ان دفتر العقاري مجرد شهادة إدارية إذ أن المحافظ العقاري في دفتر العقاري يقتصر على الاشهاد بمطابقة هذا الأخير للبطاقات العقارية وكذا السجل العيني.
حتى في حالة الحائز حيازة قانونية الذي من حقه الحصول على دفتر العقاري مثبت للملكية فإن دور دفتر العقاري يبقى دائما كاشف للحق العيني أو مجرد إشهاد على هذا الحق، ذلك أن حق الملكية قد اكتسب بأحد أسباب كسب الملكية العقارية وهو التقادم المكسب.
وإذا رجعنا إلى الدفتر العقاري نجد أن الإدارة ممثلة في شخص " المحافظ العقاري" ليست طرفا متعاقدا وإنما جهة مصدرة له، وبالتالي العقد الذي لا يكون أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام لا يمكن أن يعتبر عقدا إداريا المتفق عليه أن العنصر الأول المتعلق بالعقد هو تطابق الإرادتين[28] وهذا ما ل انجده في الدفتر العقاري.
وبالتالي نستنتج أن الدفتر العقاري يهدف إلى تحقيق الصالح العام الذي في هذه الحالة إلى العمل على استقرار المعاملات المدنية بوجه عام والعقارية بوجه خاص، وتنظيم السوق العقارية لأن أساس أي استثمار لا يبنى إلا بعقار واضح المعالم محددا لكافة البيانات الجوهرية له[29], وذلك لا يكون إلا في الأراضيالممسوحة المترتبة عنها في آخر المطاف تسليم الدفتر العقاري.
إلا أن نرى أن الرأي الراجح، هو اعتبار دفتر العقاري قرارا إداري لتوافر مميزات القرار الإداريفيه،كحقه لتصرفات الإدارة التي تتمثل سواء في العقد الإداري أو القرار الإداري،ويترتب عن هذا الدفتر العقاري قرار إداريا أنه لايجوز الطعن فيه إلا عن طريق دعوى الإلغاء.
المبحث الثاني: حجية الدفتر العقاري في الإثبات
كما سيق الإشارة إليه فإن الدفتر العقاري هو بمثابة الحالة العقارية حيث تسجل فيه جميع البيانات المتعلقة بالعقار وتلك الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية لدى مصلحة السجل العقاري، لاسيما وصف العقار والأعباء المثقل بها والهوية وأهلية وأصحاب الحقوق العينية. كما يسجل كل تغيير يطرأ على ملكية العقار في البطاقات العقارية وفي الدفتر العقاري كالبيع والرهن أو القسمة وغيرها من التصرفات القانونية التي تنقل الملكية العقارية الخاصة، هذا ما يقودنا إلى طرح التساؤل التالي: عن حجيته في إثبات الملكية العقارية الخاصة التي تم مسحها والإجابة عنها في(المطلب الأول)، وعن موقف المشرع الجزائري من هذه الحجية؟في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: القوة الثبوتية للدفتر العقاري
كما سبق ذكره، أن القاعدة في نظام الشهر العيني أن دفتر العقاري يعتبر السند الوحيد في إثبات الملكية العقارية كما هومنصوص عليه في المادة 19 من الأمر 75/74: على أنه تسجل جميع الحقوق الموجود على عقار ما وقت الإشهار في سجل العقاري وفي دفتر العقاري الذي يشكل سند الملكية.
إن الدفاتر العقارية الموضوعية على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث بشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية.
بالاستناد إلى المادة 19 من الأمر 75/77 المتضمن إعداد المسح العام وتأسيس السجل العقاري التي جاءت صريحة وواضحة في مضمونها، وهي تفيد بأن دفتر العقاري سند يسلم إلى الشخص المالك الذي حدد عقاره تحديد كليا بعد إعداد عملية مسح كما أن دفتر العقاري يعتبر السند الوحيد وأقوى في إثبات الحق العيني العقاري الأصلي وليس السند الذي سيكون مستقبلا الدليل الوحيد للإثبات ملكية العقارية عملا بالمادة 19.
والقاعدة في نظام الشهر العيني: أن عملية المسح العام الأراضي تظهر العقار حسب حقيقته القانونية بما في ذلك كل الحقوقوالأعباء التي تنقله، وعلى أساس ذلك يتم تحرير دفتر العقار بحيث لايمكن لأي شخص أن يدعي خلاف ما يتضمنه دفتر العقاري من بيانات أو يدعي اي حق عيني عقاري عليه ما لم يكن حقه مقيد بالبطاقة العقارية الخاصة بكل عقار بعد إحداث عملية المسح لأن الغرض من المسح العام الأراضي وتأسيس السجل العقاري هو إعطاء القوة الثبوتية المطلقة للحقوق تسهيلا لتداول العقارات وبعث الائتمان العقاري وضبط الملكية العقارية[30]، وبهذا المفهوم يعتبر بمثابة حسم الملكية العقارية يستمد روحه من وثائق المسح ويشكل كل مخالفة هذه القواعد من طرف المحافظ العقاري خرقا فادح لأحكام الشهر تترتب عنه مسؤولية كاملة بمجرد ثبوت خطأه المتمثل في تسليم الدفاتر العقارية، دون مراعاة مقاييس الرسم الطبوغرافية لحدود الملكيات المنجزة بمناسبة أشغال المسحية.
وبما أن الدفتر العقاري هو منتوج نظام الشهر العقاري العيني فهو يستمد منه خصائصه ومميزاته من القوة الثبوتية والحجية وتطهير التصرفات ودلالته القطعية على الملكية العقارية.
المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من القوة الثبوتية للدفتر العقاري
بالرجوع إلى نص المادة 16 الفقرة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري، نلاحظ أن المشرع الجزائري قلل من القوة الثبوتية المطلقة للحقوق المقيدة، ذلك أنه خرج نسبيا عن القواعد العامة المقررة في ظل نظام الشهر العيني، بحيث خول للأشخاص إمكانية إعادة النظر في الحقوق الثابتة عن طريق القضاء حتى بعد الترقيم النهائي العقارات بالمحافظة العقارية.
أما عن مضمون نص المادة فهو كما يلي:" لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجبه أحكام المواد 12 و13 و14 ومن هذا الفصل إلا عن طريق القضاء.
وفي إطار تطبيق نص المادة 16 المشار إليها سابقا صدرت عدة أحكام قضائية عن المحكمة العليا تكريسا لمحتواها نذكر منها القرار الصادر عن الغرفةالمدنية المؤرخ في 16/03/1994، ملفرقم 10800 المجلة القضائية العدد الثاني لسنة 1995، ص80 والذي جاء فيه مايلي:
إشهار الحقوق – الحصول على الدفتر العقاري- لا يمكن فسح تلك الحقوق ـوإبطالها ‘لا عن طريق المعارضة بدعوى قضائية مقبولة.
المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80/210 والمرسوم التنفيذي رقم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ وإبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها،لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي والمرحومة موروثة المطعون ضدهم مع أنهم مرتكز على عقد الصحيح تحصلت لموجبه على الدفتر العقاري ولم تقع أية معرضة مقبولة ضده فإنهم أساؤوا بذلك تطبيق القانون وعرضوا قرارهم لنقض.
وبالتالي فإن المشرع الجزائري جعل القوة الثبوتية للدفتر العقاري نسبية، إذ يمكن الطعن فيه قضائيا طبقا لنص المادة المذكورة سابقا.
إلا أن هناك بعض الآراء تدعوا إلى إضفاء القوة الثبوتية المطلقة للدفتر العقاري مبررين رأيهم بأن الجهود والتكاليف التي تتكبدها الدولة في سبيل عمليات المسح لتكريس نظام الشهر العيني، أن ينتج عنه بالمقابل الدفتر العقاري المكتسب للقوة الثبوتية المطلقة، وبناء عليه إذا حدث وأن أصيب شخص بأضرار نتيجة الأثر التطهيري للشهر العيني، فما عليه سوى اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاحتماء بالقواعد العامة التي لا تخوله إلا الحق بالطالبة بالتعويض جبرا لما لحقه من ضرر، دون أن يخوله القانون الحق في التماس أي تعديل في الحقوق المقيدة.
وفي الأخير، نقول أن المشرع الجزائري سلك الطريق العادل عندما يسمح لكل من له الحق من الطعن في الدفاتر العقارية، وهذا حتى لا تضيع حقوق الأفراد اعتمادا على الحجية المطلقة للدفتر العقاري، وبالتالي فإن الدفتر العقاري له حجية نسبية في مجال إثبات الملكية العقارية.
الخاتمة:
باستقراء النظام القانوني لملكية العقار والأملاك الوطنية بصفة خاصة في الجزائر، نلمس ذلك التذبذب وعدم الاستقرار منذ الاستقلال إلى غاية صدور أول قانون الأملاك الوطنية وذلك بسبب سياسة التغيير الشامل التي كانت تنتهجها البلاد في كل مرة وخاصة في أواخر الثمانينات والمتمثلة في الإصلاحات الجدرية التي مست جميع الميادين باختلاف أنواع السياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية.
إن النظام الأساسي للملكية العقارية يشكل قاعدة من القواعد الأساسية لكل مجتمع لأنه يضمن الاستقرار والاستمرارية، كما تعد مسألة النظام العقاري أساسية كذلك بالنسبة لأي سلطة مهما كان نوعها، لذا فإنه إقامة مسح عام للأراضي كنظام عقاري حتما من تحديد وضعية الأملاك العقارية.
من أجل ذلك بات من الضروري الاهتمام بموضوع الملكية العقارية الخاصة في المناطق الممسوحة وتسليم سنداتها، والتعرف المسبق على هذه الملكية والحقوق العينية العقارية الواردة عليها، لإنجاح عملية العقارية واستقرار الملكية العقارية، وبعد الانتهاء من عملية المسح العام الأراضي تسليم الدفتر العقاري الذي يعتبر بطاقة تعريف للعقار والسند الوحيد لإثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الممسوحة ،وعليه، يعتبر الدفتر العقاري منتوج نظام الشهر العيني ويجب أن يستمد منه خصائصه ومميزاته من قوة ثبوتيه وحجية وقدرة على تطهير التصرفات القطعية على الملكية، إلا أن المشرع لم يأخذ بالقوة الثبوتية المطلقة للدفتر العقاري، وهذا يقلل من أهمية نظام الشهر العيني، ويؤدي إلى عدم استقرار الملكية العقارية في بلاد وضعف درجة الائتمان العقاري إذ يبقى المالك دائما مهددا بظهور المالك الجديد.
و من أبرز النتائج والتوصيات التي نستطيع أن نخرج بها هي:
إضافة مواد ضمن الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري تنص صراحة على مبدأ قوة الثبوت المطلقة واستبعاد مبدأ القوة النسبية للدفتر العقاري في إثبات الملكية
العقارية في الأراضي الممسوحة.
- مراجعة النصوص القانونية الصادرة بخصوص التنظيم العقاري وإعادة النظر في كل ما يتعلق بالتعديل أو الإلغاء إذا استوجب ذلك حتى يكون مناسب للوضع الاقتصادي الجديد المتطور.
- القيام بعملية المسح الشامل للأملاك العقارية التي تحدد ملكية الأفراد والملكية الخاصة بالدولة.
- العمل على تكريس الحجية المطلقة لسند الملكية العقارية، وتأكيد القوة الثبوتية له لأن الدفتر العقاري يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تثبت بها الملكية العقارية، والطعن فيه يعرض للفسخ أو الإبطال لأن ذلك يشكك في مصداقيته وقوته الثبوتية، وهذا ما يتعارض مع مبادئ الشهر العيني على تكريس الحجية المطلقة.
- ضرورة تطوير وتحديثالمحافظة العقارية بالوسائل الحديثة والتكنولوجية المتطورة لتسهيل أداء مهامها بشكل سريع، ولتسهيل المعاملات بين الأفراد.
LES OLIVIERS D’HANNIBAL À L’OUEST
DE KALEA SEGHIRA AU SAHEL TUNISIEN[1]
AdelNjim ː Maître Assistant en Histoire et Archéologie Phénico-puniques à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax
Mots clés :
Kalea Seghira - Exploitations antiques - Oliviers d’Hannibal - Fermes puniques - Politique de peuplement
Résumé :
La ville de Kalea Seghira est très riche par son terroir, sa position, son histoire et son patrimoine exceptionnels. Seulement, cette cité est paradoxalement peu étudiée.
Ma contribution à mieux la connaitre portera sur une récente découverte aux environs de cette ville.
Il s’agit de présenter une découverte inédite d’une exploitation agricole antique située à quelques kilomètres à l’ouest de cette ville au lieu dit « Ennagar ». Cette exploitation contient des oliviers au tronc immense qui prouve leur âge antique. Des vestiges liés à la gestion de l’eau et une collecte préliminaire de la céramique témoignent d’une occupation allant de l’antiquité à la période islamique. Même si cette culture matérielle est digne d’un dossier approfondie.
Mes investigations m’ont permis de mettre cette ferme essentiellement oléicole avec un témoignage littéraire auquel jusque là on a accordé peu d’attention sur les oliviers plantés par le général punique Hannibal dans toute la région du Sahel. Cette découverte confirme que ce témoignage textuel ne relève pas du mythe.
De plus, cette exploitation serait en quelque sorte un des témoignages du système carthaginois très complexe. Il a un aspect militaire et sécuritaire original en rapport avec les systèmes des Phoinikoi Tapoi littéralement Fosses phéniciennes qui passent plus à l’ouest non loin de cette zone. Cette ferme dévoileaussi un aspect démographique par la fixation des fermiers à la marge des territoires d’une grande ville telle que Hadrumète. Cette exploitation essentiellement oléicole a aussi une vocation économique sans conteste de gestion et de rentabilisation des territoires périphériques à l’époque punique.
La publication de cette ferme punique enrichi ce dossier sur notre connaissance de cette culture surtout dans la célèbre région de la Byzacène devenue le Sahel un des fiefs historiques de Carthage et dans l’arrière pays de la ville d’Hadrumète cité punique majeure.
Title :
HANNIBAL OLIVE TREES IN THE WEST OF KALEA SEGHIRA IN THE TUNISIAN SAHEL
Keywords :
Kalea Seghira - Ancient Farms - Hannibal Olive Trees - Punic Farms - Settlement Policy
Abstract :
The city of Kalea Seghira is very rich by its terroir, its position, its history and its exceptional heritage. Only this city is paradoxically little studied.
My contribution to better know her will focus on a recent discovery around this city.
This is to present an unpublished discovery of an ancient farm located a few kilometers west of the city at a place called "Ennagar". This farm contains olive trees with an immense trunk that proves their ancient age. Remains related to water management and a preliminary collection of ceramics bear witness to occupation from antiquity to the Islamic period. Even though this material culture is worthy of a thorough record.
My investigations allowed me to put this farm essentially olive with a literary testimony to which little attention has been given to the olive trees planted by the Punic General Hannibal throughout the Sahel region. This discovery confirms that this textual testimony is not myth.
Moreover, this exploitation would be in some of the testimonies of the very complex Carthaginian system. It has an original military and security aspect related to the systems of Phoinikoi Tapoi literally Phoenician Fosses that pass further west not far from this area. This farm also reveals a demographic aspect by fixing farmers at the margins of the territories of a large city such as Hadrumète. This mainly olive-growing operation also has an undoubted economic vocation for managing and making profitable the peripheral territories of the Punic era.
The publication of this Punic farm enriches this file on our knowledge of this culture especially in the famous region of Byzacène became the Sahel one of the historical fiefs of Carthage and in the hinterland of the city of Hadrumète major Punic city.
INTRODUCTION
La ville de Kalea Seghira est très riche par son terroir, sa position, son histoire et son patrimoine exceptionnels. Seulement, cette cité est paradoxalement peu étudiée.
Ma contribution à mieux la connaitre portera sur une récente découverte aux environs de cette ville.
Il s’agit de présenter une découverte inédite d’une exploitation agricole antique située à quelques kilomètres à l’ouest de cette ville au lieu-dit « Ennagar ». Cette exploitation contient des oliviers au tronc immense qui prouve leur âge antique. Des vestiges liés à la gestion de l’eau et une collecte préliminaire de la céramique témoignent d’une occupation allant de l’antiquité à la période islamique. Même si cette culture matérielle est digne d’un dossier approfondie.
Mes investigations m’ont permis de mettre cette ferme essentiellement oléicole avec un témoignage littéraire auquel jusque-là on a accordé peu d’attention sur les oliviers plantés par le général punique Hannibal dans toute la région du Sahel. Cette découverte confirme que ce témoignage textuel ne relève pas du mythe.
De plus, cette exploitation serait en quelque sorte un des témoignages du système carthaginois très complexe de gestion des territoires. Il a un aspect militaire et sécuritaire original en rapport avec les systèmes des Phoinikoi Tapoi littéralement Fosses phéniciennes qui passent plus à l’ouest non loin de cette zone. Cette ferme dévoileaussi un aspect démographique par la fixation des fermiers à la marge des territoires d’une grande ville telle que Hadrumète. Cette exploitation essentiellement oléicole a aussi une vocation économique sans conteste de gestion et de rentabilisation des territoires périphériques à l’époque punique.
La publication de cette ferme punique enrichi ce dossier sur notre connaissance de cette culture surtout dans la célèbre région de la Byzacène devenue le Sahel une des fiefs historiques de Carthage et dans l’arrière-pays de la ville d’Hadrumète cité punique majeure.
- Les vestiges
La zone à laquelle on consacre cette note se situe à l’ouest de l’actuelle ville de Sousse aux environs immédiats de la ville de Kalea Seghira (figure 1). Les données réunies sont inédites et plaident en faveur d’une occupation antique préromaine de la région.
Cette découverte pousse à une évaluation plus détaillée du dossier avec les multiples données du terrain avant de passer à l’interprétation.
- La toponymie
Les noms de lieux en Tunisie constituent un chapitre non négligeable pour connaître le passé d’une région. Le toponyme de Kalea Seghira est sans doute très significatif. Seulement, nous ne sommes pas capables de dire dans quelle mesure cette appellation qui remonte à l’époque islamique reflète-t-elle un passé antique et encore moins punique[2].
- Gurza et Kalea Seghira
La cité antique voisine de Kalea Kebira portait probablement le nom antique de Gurza[3]. Nous ne disposons d’aucune interprétation probante de ce toponyme. L’assimilation avec la ville voisine de Kalea Seghira n’est pas assurée pour l’instant.
- Ennagar
La zone qui nous occupe dans cette note porte le nom de « Ennagar ». La signification de ce toponyme nous échappe pour l’instant. Le rapport entre la toponymie nord-africaine et les ressources hydriques étant très grande[4], on pourrait rapprocher ce nom de lieu avec celui d’un toponyme à vocation hydrique qui veut dire « l’eau courante » ou « l’eau abondante ». Seulement, ce n’est qu’une interprétation préliminaire qui mérite d’être approfondie.
- La route
Une autre donnée assez significative de cette zone nous est fournie par sa position par rapport au réseau routier. En effet, ces exploitations se situent au bord d’une route qui part de la ville de Sousse pour se diriger vers l’ouest. Nous allons revenir sur la signification de cette route et son importance pour le peuplement de toute la région. Nos investigations rapides nous poussent à dire que cette route est la continuation d’une voie antique qui remonte à la fois l’époque punique et romaine. Cette voie est actuellement méconnaissable parce qu’elle est masquée par l’aspect récent de la route asphaltée.
- Les vestiges funéraires
Les parcelles que nous présentons dans ce cadre renferment un certain nombre de vestiges de nature diverse. On a trouvé non loin des oliviers une tombe. Celle-ci a été violée des fouilleurs clandestins (figure 2). Selon le témoignage d’un berger habitué à fréquenter ces lieux on y a trouvé un plat en céramique intact. Il semble qu’il s’agit d’une pièce en sigillée d’après la description qui nous a été fournie. Le fossé de l’inhumation ne contient aucune trace de mobilier.
Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’inhumations multiples ou d’une nécropole. Nous penchons vers l’idée d’une seule inhumation ou même de quelques-unes. Il n’est pas improbable que d’autres tombes non fouillées existent encore à cet endroit. Notre investigation rapide de la zone ne nous a pas permis de les déceler.
- Les vestiges hydrauliques
Cette zone renferme aussi des vestiges très intéressants puisqu’ils dévoilent la fonction de ces parcelles. Il s’agit de structures à vocation hydraulique. Nous avons trouvé un puits assez profond creusé dans le sol rocheux de la zone. Il est actuellement abandonné et totalement inaccessible à cause d’un figuier qui l’obture (figure 3). Nous aurons souhaité pouvoir le prospecter afin de rechercher de la céramique qui pourrait nous aider à dater la période de son usage. Non loin de ce puits on a trouvé un bassin de forme carré d’environ quatre mètres et demi de diamètre (figure 4). Il est relativement dégradé par les intempéries. La surface est faite en mortier hydraulique. La situation de ce basin à proximité des oliviers indique que son utilisation est en rapport étroit avec ses plantations soit pour l’arrosage ou pour l’extraction de l’huile. Il n’est pas improbable qu’avec l’exploitation des oliviers des plantations éphémères étaient pratiquées qui exigeaient l’usage de l’eau.
Une autre structure hydraulique probablement souterraine située non loin de ces plantations nous a été signalée par un berger qui fréquentait cette région. Il s’agirait de réservoirs d’eau. Nous n’avons pas pu voir de près ces vestiges vu leur proximité d’une maison nouvellementbâtie dans la zone.
- Les carrières
Non loin de ces plantations on trouve à l’intérieur des terres demultiples dépressions assez conséquentes. Il s’agit peut-être de zones d’attraction de pierres qui aurait était utilisée pour la construction de la route. Seul un examen approfondi peut nous éclairer sur cette question.
- Le mobilier
Notre prospection rapide de cette zone nous a permis de recueillirun mobilier très riche assez instructif sur l’histoire de l’occupation de cette région.
Nous allons reprendre cette moisson d’objet dans un travail ultérieur détaillé. Il s’agit ici de présenter brièvement ces indices surtout pour situer chronologiquement les oliviers et les exploitations que nous avons découverts. Les indices matériels recueillis vont de la préhistoire à l’époque islamique et témoignent de la continuité de peuplement dans cette zone (figure 5).
- Les exploitations agricoles
L’intérêt principal de cette zone est constitué par les plantations d’oliviers situées au bord de la route.
- Oliviers
Les oliviers découverts sont très anciens vu le tronc immense qu’ils présentent (figure 6). Notre enquête nous autorise à dire qu’ils remontent avec certitude à l’époque punique selon des multiples indices. La parcelle que nous avons prospectée n’est sans doute pas la seule digne d’intérêt. Un retour sur les lieux est nécessaire et une investigation plus approfondie serait une bonne chose.
- Cultures éphémères
Les oliviers étaient probablement accompagnés de cultures éphémères dont les traces nécessitent des moyens techniques plus sophistiquées. Le bassin situé dans ces parcelles constitue sans doute une réserve d’eau pour ces cultures éphémères.
- Activités pastorales
De plus, cette zone était sans doute une zone de pâturage comme elle l’est encore de nos jours. Cette activité est favorisée par l’abondance de l’herbe aux pieds des oliviers. L’élevage avait souvent constitué une source d’appoint pour les fermiers nord africains.
- Les oliviers d’Hannibal
- Les données archéologiques
Les oliviers de Kalea Seghira sont caractérisés par leur tronc immense qui témoigne de leur ancienneté. Grâce à une collecte de céramique préliminaire nous avons pu les attribuer à l’époque punique. Ces oliviers millénaires ne se limitent pas à cette zone.
Nous avons pu découvrir des oliviers similaires à de multiples reprises dans d’autres endroits du Sahel. En effet, nous avons été interpellés par ces oliviers au tronc immense comme ceux de Kalea Seghira dans les environs de Melloulech (au Sud de Chebba), à Henchir Maklouba (entre Rajiche et Ksour Essaf), à Thapsus, à Lamta , au village de Moureddine (à l’ouest de Sousse), à Sousse (dans les environs de la cité Erriadh) et à Hammam Sousse (dans des parcelles situées non loin de la mer).
Nous avons pu attribuer ces parcelles à l’époque punique grâce à des ramassages de céramique.
Bien sûr, le premier souci était de dater ces oliviers avec plus précision. La méthode de datation des arbres à la portée des archéologues est la dendrologie[5]. Elle se fonde sur l’analyse du tronc de l’arbre par calcul des cercles de croissance. Cette démarche nécessite d’avoir un arbre dont le tronc est sectionné pour pouvoir effectuer la datation. Sans parler du coût de l’opération qui suppose le recours au financement d’une institution de recherche et d’un projet autour de cette découverte. En l’absence de ces possibilités cette découverte est suspendue.
- Les données littéraires
Nous pouvons améliorer cette chronologie grâce à témoignage littéraire assez instructif. Le retour à ce dossier s’est fait tout à fait par hasard lors d’une recherche sur Hannibal[6]. En effet, en lisant le travail de Segre Lancel consacré à Hannibal nous avons découvert une donnée littéraire fort intéressante. Le premier réflexe était de tenter de concilier entre ce témoignage textuel et les indices découverts sur le terrain. Selon une légende rapportée par un auteur tardif Aurelius Victor on apprend qu’Hannibal craignant les effets pernicieux de l’oisiveté pour ses soldats les avaient employés à planter en masses des oliviers. D’après Serge Lancel, une telle action aurait pu se faire pendant deux périodes. Soit en l’année qui sépara son retour d’Italie à l’automne de l’année deux cent trois et son engagement contre Scipion à Zama à la fin de l’année deux cent deux alors qu’il avait son quartier général à Hadrumète. Ou dans les années entre la paix imposée à Carthage après Zama et son suffétat[7].
- Verdict scientifique
Pour résumer la question, d’un côté nous avons sur terrain les traces d’une forêt d’oliviers d’âge très ancien située dans divers endroits du Sahel. De l’autre nous disposons d’un témoignage certes tardif mais sans doute digne d’intérêt sur une opération de plantation d’oliviers dans la région du Sahel par les soldats d’Hannibal.
C’est à l’occasion d’un travail de recherche destiné à être présenté lors d’un colloque sur la ville de Kalea Seghira qu’un lien solide a pu être établi entre les données textuelles et celles fournies par le terrain. En effet, lors d’une prospection dans un lieu-dit Ennagar à l’ouest de Kalea Seghira, nous avons pu découvrir des exploitations agricoles antiques axées sur la culture de l’olivier. Des investigations minutieuses dans l’une des parcelles en question témoignent qu’elles ont fonctionné durant la période antique et qu’elles remontent avec certitude à l’époque punique. Ce qui constitue un patrimoine exceptionnel à valoriser[8].
Donc, il n’a nul doute que les oliviers du Sahel remontent à l’époque punique. Les attribuer à l’œuvre des soldats d’Hannibal est facilement envisageable. Certes, nous auront toujours besoin d’une datation précise d’avantage pour être plus sûr. Une telle opération pourrait se faire dans le cadre d’un projet dédié à ce patrimoine agricole punique exceptionnel.
- Intérêts scientifiques
- Agriculture punique
Ces fermes puniques situées à l’ouest de la ville de Kalea Seghira ont une portée plus large. D’abord, ces exploitations élargissent nos connaissances sur le milieu rustique punique en dehors de la métropole de Carthage qu’on connait à travers quelques études ponctuelles[9].
Les fermes puniques situées au Sahel confirment les connaissances dont nous disposons sur l’agriculture carthaginoise. Effectivement, nous savons qu’après la défaite de Zama le potentiel économique local de Carthage était intact. Appien parle des années du début du deuxième siècle avant J.-C.. Il insiste sur la puissance retrouvée de Carthage. En effet, dix ans après Zama Carthage pouvait proposer à Rome de s’acquitter par anticipation des quarante annuités d’indemnités de guerre qui lui restaient à régler selon le traité de l’année deux cent un[10].
De telles découvertes sont de nature à éclaircir notre connaissance sur le fonctionnement du territoire de la métropole punique d’Hadrumète à l’époque punique.
- Peuplement punique
Effectivement, les exploitations puniques aux environs de l’actuelle Kalea Seghira à l’Ouest de la ville de Sousse l’ancienne cité phénico-punique d’Hadrumète dévoilent un chapitre important et peu étudié de la politique punique de gestion des territoires périphériques. Ce mode de fermes agricoles fait partie du système à facettes multiples. Il a un aspect démographique par le cantonnement de tribus à la périphérie de la limite du territoire de la Byzacène dont la ville d’Hadrumète était la principale cité. Ce mode de gestion a aussi un aspect sécuritaire puisque le Sud-Ouest de la Byzacène échappait relativement au contrôle de l’autorité punique[11]. Enfin, ce mode de gestion avait un aspect économique indéniable surtout par la production de l’huile dont l’importance pour Carthage était incontestable.
Ce mode de gestion paysan par le cantonnement de fermiers dans les marges des territoires puniques allait de pair avec des structures de contrôle appelées Phoinikoi tapoi dont nous avons montré l’intérêt non seulement dans les régions situées au Nord de la Tunisie mais sans doute au Sahel et dans l’actuelle région de Sfax qui correspond à la région historique de la Petite Syrte[12].
- Aspect sécuritaire
Les exploitations agricoles d’époque punique à l’Ouest de l’ancienne cité d’Hadrumète dans les environs de la ville actuelle de Kalea Seghira sont en un rapport avec la politique sécuritaire punique dans la région de la Byzacène.
Ces exploitations agricoles sont liées à un système de fixation des fermiers et de surveillance des terres dans le cadre d’un dispositif de gestion des territoires périphériques appelé Phoinikoi Tapoi.
Cette question de limite de territoire en Afrique du nord est très intéressante. Il semble que cette structure défensive a presque peu changé entre l’époque punique et romaine. La phase romaine est très médiatisée alors que le chapitre punique est encore peu connu et il l’est encore moins dans la partie de la Byzacène et de la Petite Syrte d’où l’intérêt de cette recherche.
La limite de territoire dite communément « Fossa Regia » fut tracée par Scipion Emilien après la défaite punique en 146 avant J.-C. pour séparer la région qui correspond à l’ancien territoire punique de Carthage, des territoires numides (figure 7). En effet, Pline l’Ancien définit le plus clairement la nature et le rôle de la Fossa Regia. Selon lui, elle servait à séparer le royaume numide du territoire de Carthage conquis par Rome. Effectivement, les textes épigraphiques qui sont des bornes limites d’époque impériale précisent cette appellation de « limite entre la nouvelle et l’ancienne province : l’Africa Vetus et l’Africa Nova »[13]. Cependant, Pline l’Ancien indique seulement le point de départ et d’arrivée de cette frontière. Le point de départ de cette ligne de démarcation se situe sur la côte Nord-Ouest de l’actuelle Tunisie. Il correspond au fleuve Tusca non loin de la ville de Tabarka. Celle-ci se trouvait vraisemblablement sur la frontière mais en territoire numide. Le point d’arrivée de cette frontière aboutissait à Henchir Thina ou Thaenae. En ce qui concerne le secteur de la Fossa Regia à la latitude du Sahel selon A. Machrek, elle se situe dans la vallée de Oued Merguellil situé à l’Ouest de Kairouan[14]. Ainsi cette limite est à l’ouest des fermes puniques situées dans les environs de la ville de Kaleae Seghyra.
Nous venons à une idée de synthèse qui nous avance dans notre débat sur ces exploitations agricoles antiques. Selon l’infatigable archéologue Nadia Ferchioule problème de la FossaRegia est loin de se limiter au simple tracé d’une ligne de démarcation entre deux pays ou deux provinces. En fait, il touche à des aspects les plus divers tels que la politique des deux protagonistes de l’époque, les opérations militaires, les institutions municipales et juridiques, le droit des gens et du sol, l’assiette financière, la répartition et le recouvrement de l’impôt. On peut donc se rendre compte que la question de la FossaRegia est un sujet particulièrement complexe[15].
Ce système défensif est bel et bien punique. Des témoignages de sources littéraires antiques font échos d’un système de défense territorial en Afrique du Nord nommé Phoinikoi Tapoi littéralement Fosses Phéniciennes. En effet, nous disposons d’un témoignage littéraire digne d’intérêt sur ces Fosses phéniciennes. Il s’agit d’un grec nommé Eumachos. Selon Serge Lancel cet auteur était sans doute l’historiographe d’Hannibal[16]. L’implication de l’auteur dans les évènements est de nature à accroitre la crédibilité accordée à son témoignage sur ce phénomène. Cet auteur mentionne un fossé creusé par les Carthaginois autour de leur propre territoire[17]. Nous disposons d’un second témoignage littéraire antique sur ces limites fourni par Appien. En effet, l’auteur mentionne des Fosses Phéniciennes à de multiples occasions dans son œuvre consacrée à la civilisation de Carthage[18]. Entre autre, Appien parlant du traité qui termina la guerre d’Hannibal à la fin de ce qui communément appelé la seconde guerre punique, nous apprend que les Carthaginois avaient établi des garnisons des villes situées au-delà des « Fosses Phéniciennes ».
Fait étonnant, les Fosses phéniciennes n’ont fait l’objet d’aucune notice dans le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique. Cette absence marque le peu d’intérêt accordé à cette question. Nous avons eu l’occasion de formuler des réserves sur le contenu de ce travail entre autre à ce sujet et d’attirer l’attention sur ce manque dans une note encore inédite[19]. De même l’article consacré à la Fossa Regia au sein de cet ouvrage ne fait aucune allusion à cette frontière[20]. Pourtant, Stéphane Gsell dans sa synthèse sur l’Afrique du nord évoque cette question[21]. Charles Tissot, l’éminent spécialiste de l’Afrique du Nord antique reconnaissait ce phénomène et distingue entre les Fosses Phéniciennes et la Fossa Regia[22]. Le dossier des Fosses Phéniciennes s’est recouvert grâce aux travaux de Nadia Ferchiou dans la Nord-Ouest tunisien. Dans un premier travail, elle soulève cette question de façon dubitative[23]. Ensuite, elle reprend cette enquête dans un travail de terrain où elle avance des constatations plus sûres[24].
Pour certains chercheurs l’appellation de « Fosses Phéniciennes » bien évidente des sources antiques ne reflète pas une réalité. L’interprétation qu’ils donnent est la suivante. Selon ces chercheurs, ce terme serait une pure invention due à un auteur romain. Ce dernier, soucieux de justifier l’usurpation du roi Massinissa aurait jugé bon de falsifier le traité conclu en 201 après J.-C. il aurait inséré une clause afin d’obliger les Carthaginois vaincus à évacuer tout le pays en dehors de ce fossé qu’il aurait frauduleusement qualifié de « Fosses Phéniciennes »[25]. Certains chercheurs actuels semblent du même avis. Pour eux, ces Fosses n’auraient pas existé à l’époque punique. Il faudrait les identifier avec la Fossa Regia d’époque romaine.
Seulement, une nouvelle découverte faite par l’archéologue tunisienne N. Ferchiou pousse à rouvrir ce dossier. Elle signale un fossé qui traverse en diagonale la Tunisie antique. Le secteur qu’elle a découvert se situe entre Sbikha et le Sud de Djebel Bargou et se dirige au Nord-Ouest vers Vazi Sarra[26]. Elle se pose la question si ce fossé correspond ou non à celui de la Fossa Regia. Son verdict est clair : « ce tracé nous ramène vers l’hypothèse des Fosses Phéniciennes qui cernaient le territoire de Carthage avant la défaite de Zama. Nous ne voyons guère d’autre alternative »[27]. L’une des raisons que l’auteur présente est la suivante. Elle affirme que ce fossé découvert passa à une vingtaine de kilomètres en moyenne au Sud des bornes déjà connues de la Fossa Regia[28]. Néanmoins, il n’empêche que la prudence est recommandée car les deux structures de la Fossa Regai et des Phoinikoi Tapoi sont en maints endroits superposables[29].
Passons à tenter d’énumérer quelques paramètres qui nous permettent d’identifier ce type de structure dans des endroits précis ce qui nous aidera à essayer de reconnaître sa présence dans la région de la Byzacène et de la Petite Syrtes.
La toponymie est un outil assez efficace pour nous faire avancer dans l’étude de cette limite de territoire à condition d’être bien exploitée. Parmi les toponymes révélant des structures de ce type le nom de lieux de Haddada qui fait allusion à une frontière. Nous disposons à des multiples endroits de toponymes pareils. Par exemple à l’Ouest de Mactar on a un nom de lieu de Haddada ou également Oued Haddada. Selon le colonel Reyniers ce terme désignait la Fossa Regia[30]. Dans la zone du Sahel, à l’Ouest de Sidi el Hani on trouve sur la carte d’État-major le toponyme de Seguiet el Hadd. Au même endroit, on trouve le nom de lieu de Henchir el Hadd[31]. Charles Tissot, y avait reconnu des vestiges. Un autre toponyme révèle probablement des fortifications, il s’agit de Oued Zouara qui coule à quinze kilomètres à l’Est de Tabarka[32]. Une enquête toponymique dans la région de Thyna pourrait nous éclairer sur les toponymes révélateurs de limite de frontière. Celle-ci devrait être accompagnée d’une vérification sur terrain afin d’éviter les confusions.
Dans la recherche des structures fortifiées appartenant à la Fossa Regia et ou aux Phoinikoi Tapoi il faut être muni de beaucoup de discernement. En effet, des structures de fortifications urbaines peuvent nous induire en erreur. Bon nombre de villes numides sont munies de fortifications délimitant leurs territoires[33]. L’assimilation entre la Fossa Regia et ou les Phoinikoi Tapoi d’un côté et la fortification d’un territoire d’une cité est sans aucun doute chose facile. Seule une enquête de terrain minutieuse accompagnée d’une étude des textes littéraires et épigraphiques quand elles existent peut nous éviter les erreurs d’interprétation.
Dans la quête des cités ayant fait partie de l’Africa Vetus ou de l’Africa Nova, les qualifications des noms des agglomérations peuvent dévoiler leurs status juridiques et par là même leur rapport avec ce système défensif de la Fossa Regia ou des Phoinkoi Tapoi. Par exemple le terme de Pagus des localités romaines nous indique qu’elles étaient souvent localisées au-delà des frontières[34]. Nous savons également que l’étiquette de Regius accolée à une agglomération veut dire qu’elle est rattachée au monde numide. Nous avons par exemple en Byzacène la cité d’Aqua Regia située à une quarantaine de kilomètres au Sud Est de Kairouan qui est une possession de la monarchie numide[35].
Une indication importante concerne une limite de territoire d’époque punique, celle des « Arst » considérés comme révélatrices d’une limite de territoire qu’on a trouvé à Mactar médiatisée sous le nom de borne de Micipsa[36]. Malheureusement, cette indication ne concerne pas la région de Thyna. Attendons le bon hasard d’une nouvelle découverte épigraphique dans la zone de la Petite Syrte qui apporte un éclairage sur les rapports de Puniques à cette région.
Cette limite de territoire en Tunisie antique appelée Fossa Regia et Phonikoi Tapoi est sans doute un dossier intéressant qui mérite davantage d’approfondissement.
Une question brulante concerne la date des Fosses Phéniciennes. Stéphane Gsell s’est posé cette question. Selon lui vraisemblablement cette frontière fut tracée à l’époque où Amilcar Barca étendit les limites de la domination punique selon le témoignage de Cornelius Népos[37].
Une étude récente pourrait nous éclairer davantage sur cette question. Elle porte sur les rapports des Carthaginois à l’Afrique du nord et entre autre la région de la Petite Syrtes[38]. Cet auteur donne une chronologie de l’affirmation de l’autorité punique en Afrique du Nord. D’après lui, c’est entre le quatrième et le troisième siècle av. J.-C. que le territoire de Carthage atteint son maximum d’expansion. Après le troisième siècle commence la phase de restriction territoriale suite aux conquêtes de Massinissa[39]. Ainsi, le système des Phoikoi Tapoi se situera dans cette fourchette chronologique. Dans une autre étude ce chercheur nous présente les différentes zones d’influence progressive du pouvoir punique en Afrique du Nord[40].
L’intérêt des Puniques à la région de la Byzacène est motivé par de multiples considérations à la fois d’ordre stratégique et économique.
Celle limite de territoire qui traverse la Tunisie du Nord-Ouest au Sud Est mérite qu’on s’y arrête à plusieurs égards. Il est évident que ce système de fortifications ne soit pas souvent fait en matériaux qui résistent longtemps face aux éléments de la nature surtout dans les zones steppiques. De telles œuvres risquent de disparaitre ou qui ont déjà disparu. La limite de la Fossa Regia est certainement en rapport étroit avec celle des Phoinikoi Tapoi. La continuité entre les deux systèmes est frappante. Les motivations de l’édification de cette frontière sont multiples à la fois géographiques, stratégiques et bien évidemment économiques. La création de cette limite de territoire marque la mainmise des Puniques sur le sol africain. Ce souci s’est poursuivi les Romains une fois en Afrique du Nord. Cette étude n’est sans pas exhaustive. Elle nécessite un approfondissement et surtout un travail de terrain dans la région de la Byzacène et de la Petite Syrte que ces oliviers et ses fermes antiques nous encouragent à poursuivre notre investigation.
CONCLUSION
La région du Sahel qui correspond à la Byzacène antique renferme encore des données à découvrir. Cette mise au point sur la cité de Kalea Seghyra démontre la richesse de cette région. Notre présentation a le mérite de présenter un aspect inédit de l’archéologie punique en Tunisie qui est celui des vestiges agricoles. Les oliviers de Kalea Seghyra sont en rapport avec des exploitations parsemées dans tout le Sahel. Ces oliviers concentrés surtout au Sahel enrichissent sûrement le dossier sur notre connaissance de la culture punique surtout dans la célèbre région de la Byzacène devenue le Sahel un des fiefs historiques de cette civilisation en Tunisie. Egalement, ces exploitations ont des significations multiples à la fois économiques et sécuritaires. Ils nous renseignent sur la fonction particulière de la cité d’Hadrumète devenue une véritable capitale durant l’époque punique dontl’héritage est peu valorisé[41].
BIBLIOGRAPHIE
De Bonis, Cartagine : A. De Bonis, Confine e articulazionedelterritorio di CartaginenellaTunisiaantica, L’AfricaRomana 19, 2010, volume 1, p. 189-209.
De Bonis, Tunisiapunica : A. De Bonis, Distribuzione di siti e circolazione di beninelleTunisiapunica, L’AfricaRomana, 20, 2015, volume 1, p. 162-183.
Djelloul, Propriété : N. Djelloul, Propriété foncière maraboutisme etformation du paysage urbain du Sahel au moyen âge, dans La méditerranée : l’homme et la mer, Tunis 2001, p. 13-194.
Dubuison-Lipinski, Byzacène : M. Dubuisson- E. Lipinski, Byzacène, dans E. Lipinski, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et Punique, Paris-Bruxelles 1992, p. 85.
Fantar, Gammarth : Mh. Fantar, À Gammarth avant la conquête romaine, BAC, ns. 17 B, 1984, p. 3-19.
Ferchiou, Fossé inconnu : N. Ferchiou, Un fossé inconnu en Afrique proconsulaire suite des recherches, REPPAL 5, 1990, p. 107-115.
Ferchiou, FossaRegia : N. Ferchiou, FossaRegia, dans Encyclopédie berbère, tome 19, 1997, p. 2897-2911.
Ferchiou, Nouvelles données : N. Ferchiou, Nouvelles données sur un fossé inconnu en Afrique proconsulaire, dans troisième colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du nord, Montpellier, 1985, volume 1, p. 351-365.
Février, Micipsa : J.-G. Février, La borne de Micipsa, Cahiers de Byrsa 7, 1957, p. 119-121.
Gharbi, Fortifications : M. Gharbi, A propos de quelques fortifications urbaines numides à l’époque de la guerre de Jugurtha, dans Ministère de la Défense, Actes du colloque national d’histoire militaire : le patrimoine national de la Tunisie, Tunis 2011, p. 5-13.
Gsell, Histoire : S. Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du nord, I-VIII, Paris 1913-1928.
Jockey, L’archéologie : Ph. Jockey, L’archéologie, p. 286-288, figure page 287.
Kolendo, Fossa Regia : J. Kolendo, Fossa Regia, dans E. Lipinski, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Paris-Bruxelles, 1992, p. 176.
Lancel Carthage : S. Lancel, Carthage, Paris 1992.
Lancel, Hannibal : S. Lancel Hannibal, Paris 1995.
Lipinski, Gurza : E. Lipinski, Gurza/Gorza, dans E. Lipinski, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Paris-Bruxelles, 1992, p. 202.
Njim, Hannibal : A. Njim, Hannibal l’ombre de son père, Colloque International Familles, parents et enfants, de l’Antiquité à nos jours : Sensibilités, stratégies et conflits, Faculté des Sciences Humaines
et Sociales de Tunis 17, 18 et 19 novembre 2016, En cours de publication.
Njim, Index : A. Njim, Index thématique du Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique (travail inédit).
Njim, Kalea Seghira : Les oliviers d’Hannibal à l’Ouest de KaleaSeghira, Colloque KaleaSeghira, Territoire, Histoire et Patrimoine, 27-29 avril 2017, En cours de publication.
Njim, Sousse : A. Njim, Sousse phénico-punique : bilan, évaluation et perspectives, Patrimoine urbain et acteurs de patrimonisation, Colloque International, Monastir 6-9 décembre 2017, en cours de publication.
Njim, Thyna : A. Njim, A. Thyna : station des Fosses phéniciennes, Colloque Sfax et la mer, Juillet 2017 (Sfax), En cours de publication.
Njim, Toponymie : A. Njim, La toponymie maghrébine antique lecture pragmatique de l’espace, 19th International Congress of Classical Archaeology, Cologne-Bonn (Allemagne), 22-26 May 2018, en cours de publication.
LISTE ET REFERENCES DES FIGURES
Figure 1. Sousse et son arrière-pays : partie de la carte topographique de Sousse
Figure 2. Tombe qui a subi une fouille clandestine : photo de l’auteur.
Figure 3. Puits creusé dans le roc obturé par un figuier : photo de l’auteur.
Figure 4. Bassin à mortier hydraulique à proximité des oliviers : photo de l’auteur.
Figure 5. Mobilier de différentes époques collecté sur les lieux : photo de l’auteur.
Figure 6. Un des oliviers millénaires des exploitations de Kalea Seghira: photo de l’auteur.
Figure 7. Le tracé de la Fossa Regia et des Phoinikoï Tapoï : Ferchiou, Fossé inconnu, p. 114, pl. I.
CATALOGUE DES FIGURES

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6
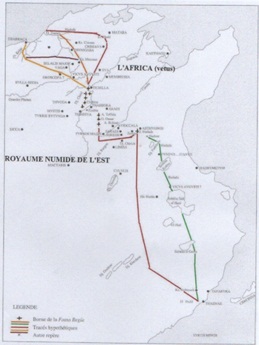
Figure 7
[1]AdelNjim ː Maître Assistant en Histoire et Archéologie Phénico-puniques à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (Tunisie). Mail ː عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
[2] Djelloul, Propriété, p. 45.
[3] Lipinski, Gurza, p. 202.
[4] Njim, Toponymie.
[5] Jokey, L’archéologie, p. 286-288, figure page 287.
[6] Njim, Hannibal.
[7] Lancel, Carthage, p. 381 ; Id., Hannibal, p. 325.
[8] Njim, Kalea Seghira.
[9] Fantar, Gammarth, p. 3 et suivant.
[10] Lancel, Hannibal, p. 329.
[11] Dubuisson-Lipinski, Byzacène, p. 85.
[12] Njim, Thyna.
[13] Ferchiou, Fossa Regia, p. 2897.
[14] Ferchiou, Fossa Regia, p., 2897.
[15] Ibid.,p. 2897.
[16] Lancel, Op., Cit., p. 362.
[17] Gsell, Op. Cit., II, p. 102.
[18] Ibid., p. 101.
[19] Njim, Index.
[20] Kolendo, Fossa Regia, p. 176.
[21] Gsell, Ibid.,p. 101-102.
[22] Ibid., p. 102.
[23] Ferchiou, Nouvelles données.
[24] Ferchiou, Fossé inconnu.
[25] Gsell, Op. Cit., p. 101.
[26] Ferchiou, Fossé inconnu, p. 107, pl. I.
[27] Ibid, p. 113.
[28] Ibid., p. 107.
[29] Lancel, Op. Cit., p. 362.
[30] Ferchiou, Op. Cit., p. 111.
[31] Ferchiou, Fossa Regia, p. 2910.
[32] Ibid., p. 2901.
[33] Gharbi, Fortifications.
[34] Ferchiou, Fossa Regia, p. 2901.
[35] Ibid, p. 2904.
[36] Février, Micipsa, p. 120-121.
[37] Gsell, Op. Cit., p. 102.
[38] De Bonis, Cartagine.
[39] Ibid., p. 199.
[40] De Bonis, Tunisia punica, p. 164, fig. 1.
[41] Njim, Sousse.

 Français (France)
Français (France) 