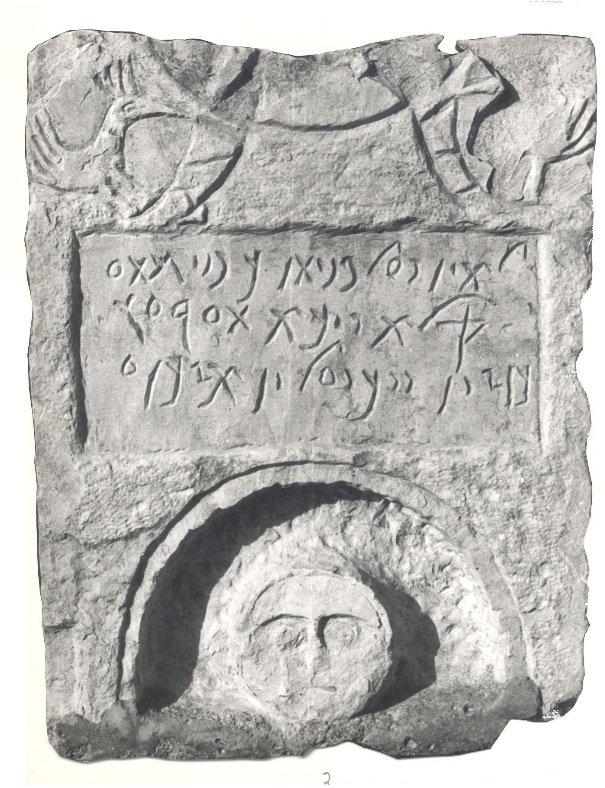أنصــــــاب من توفاة مكثـــر
أ. د. محمّد حسين فنطر
أستاذ دكتور متميّز بالجامعة التونسية
مدير عام سابق بالمعهد الوطني للتراث
المشرف على كرسي حوار الحضارات والأديان
توطئــــــة:
يحتوي عنوان هذه المداخلة على اسماء ثلاث تستوجب التعريف وهي: مكثر وتوفاة وأنصاب. فمكثر اسم مدينة تقع في الربوع الوسطى من البلاد التونسية، وتفصلها عن العاصمة مسافة قدرها 150 كلم تقريبا. والطريق الدافعة إليها معبّدة فسيحة مفتوحة لوسائل النقل البري جميعها، وتمر بمدن وقرى عديدة منها "الفحص"، و"سليانة". ومكثر مدينة ذات مساحة متوسطة، تتوفر فيها المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وهي مركز لمعتمدية تشرف على عمادات عديدة. تتميز بمناخ قارّي، تتراوح درجة الحرارة فيها بين الصفر في لياليالشتاء و 40 درجة في حرّ الصيف نهارًا، أما ليلا فتمتاز بنسيم عليل، وسماء وضاءة وكواكب لا تحصى. يكثر حول مدينة مكثر جبال ذات أشجار غابيّة متنوعة، كالصنوبر والعرعار والسرو والكراتوس المستورد من استراليا. وتكسوها ثلوج ناصعة البياض في الشتاء، ممّا يزيدها حسنا وإغراء.
تتربع المدينة على نجد يحمل اسمها ويرتفع إلى ما ينيف عن 900 مترا فوق سطح البحر، كما تشرف مكثر على"وادي الصابون" الذي ينحدر ليلتقي "بوادي وزفة". تحد المدينة "حمادة ولاد عيّار" غربا، و"حمادة ولاد عون"شمالا، وتقابلها شرقا مدينة "كسرة". وهي على صعيدها شامخة، كانت تسمى في العصور القديمة "كوسيرة". ومن جهة الجنوب، يتراءى لك "جبل بربرو".كما تحيط بمكثر مجموعة من القرى والمواقع الأثرية أهمها "وزفة" "كسرة" بالجنوب الشرقي. وفي شمالها، تتربع أطلال "زامة" "Chusira" ، و"تجبّة" غربا، و"مدد" بالجنوب الغربي وقرية "جامة" التي خلفتها، تفخر "بمقام سيدي أنبيل". وهو كلّ ما بقي من عظمة "حنبعل" في الذاكرة الجماعيّة. وهل ننسى قرية "اللاّس" ومعالمها الجلموديّة، تلك التي تعرف عند المختصين "بالدلامين" ومفردها "دلمان" "Dolmen".
كما تعرف بلوحة من الفسيفساء تمثل تتويج "فينوس"، ويتباهى بها متحفنا الوطني "بباردو". وقد استلّوها من أطلال "اللاّس" وهو اسم عتيق ورد ذكره مسطورًا على نصب من أنصاب الموقع، كشف الغطاء عنه عرضا أثناء أشغال كانت تقوم بها إدارة المياه الجهوية في العقد الأخير من القرن الماضي.
تواجد مدينة مكثر في ربوع أينع فيها العمران، فهي في محيط يوفر ظروف الصحة والدفاع، فيه عيون مياء غزيرة، تقي السكان والأرض شر العطش والقحط. وكانت المدينة تستفيد من مياه "حمادة ولاد عيّار" حيث توجد اليوم مدينة "سوق الجمعة". ومن اللاّفت غياب الصهاريج فيها، فكيف كانت تجمع مياه القناة وتوزع على السكان ومرافق المدينة؟
وفي الحديث عن هذه المدينة، لابد من إشارة إلى جذورها النوميدية التي تنغمس في ماض سحيق. فلقد نشأت نوميدية أصيلة، و"النوميديّون" فرع من فروع "اللّوبيين" وهم سكان شمال إفريقيا الأصليين. يمثلون عرقا عظيما يتفرع إلى شعوب وقبائل شتى، و"النوميديون" أنفسهم فرعان كبيران وهما "المصوليون" وربوعهم في ما بين غربي" تونس وشرقي الجزائر. لهم مملكة عاصمتها "كرطن" سماها الرومان "قيرتا:Cirta" ثم أصبحت تسمّى "قسنطينة" نسبة إلى "الإمبراطور قسطنتينوس " Constantin: الذي تبوأ عرش الإمبراطورية الرومانية بين سنتي 307 ، و 337 بعد الميلاد.
أما الفرع الثاني، فيتكون من "المسصوليين" الذين كانوا يعمّرون غربي الجزائر، إلى حدود " نهر الملوية"، عرفت مملكتهم امتدادا واسع ، عاصمتها سيجن Siga وأشهر ملوكها "سيفاكس " "Syphax " الذي سقط، أسيرًا في أواخر الحرب الرومانية القرطاجيّة الثانية، تحديدًا سنة 203 قبل ميلاد المسيح.
فلا غرو أن يكون لسكان مكثر القدامى صلة بالممالك النوميدية، من عهد الملك جيّا " Gayya" إلى عهد .حفيده "يوباي الأول"، مرورا بالملك "مسّنسن "Massinissa الذي تبوّأ العرش النوميدي من سنة 202 إلى سنة 148 قبل ميلاد المسيح، ثم خلفه أبناؤه الثلاثة "مكوسن"و"جوده" و"مستنبأ". بعدها انفرد "مكوسن" بالعرش النوميدي إثر وفاة أخويه، وبقي على رأس المملكة إلى سنة118 قبل ميلاد المسيح.
تجدر الاشارة أن الملك "مكوسن" ذكر في النصوص الإغريقية اللاتينية باسم "ميقبسة "Micipsa" فما هو مردّ هذا التغيير؟ . سؤال نطرحه يذكّر بما طرأ على أسماء مشاهير الحضارة العربية: "فابن سينا" يصبح "Avicenne" و"ابن رشد "Averroès" وهلم جرّا.
إن آخر من تحلّى جبينه بإكليل المملكة النوميدية هو "يوباي الأول"، الذي انتحر بعد هزيمته أمام جيوش "قيصر" في تابسوس "Thapsus"، شمال "المهدية" على السّاحل التونسي سنة 46 قبل ميلاد المسيح. فلما انتصر القائد الروماني في هذه المعركة الحاسمة على الحزب الجمهوري الروماني وحليفه "يوبا الأول"، أغلقت مدينة "زامة" أبوبها في وجه العاهل المهزوم، فانتحر، وبموته غربت شمس المملكة النوميدية، وضمّت إلى الممتلكات الرّومانية بأفريقيا.
ولا غرو أن تعيش مدينة مكثر، وهي على مسافة قصيرة من "زامة"، هذه الأحداث التي أدت الى انتحار الملك النوميدي ولا شكّ أنها واكبت، من قريب أو بعيد، ملحمة "يوغرطة". البطل النوميدي الذي تحدّى "روما" وجيوشها، وتمكّن من الصمود الى غاية القرن الثاني قبل ميلاد المسيح. ثم القي القبض عليه غدرا، ضمن مؤامرة حاك خيوطها الضابط الروماني "بومبيوس "Pompée بالتعاون مع "بكّوس "Bocchus" ملك "الماووريين"، الذي وإن تحالف مع "يوغرطة" وزوّجه من ابنته حتّى يطمئنّ له، فلم يتردد في التآمر مع الجيش الروماني ليسلّمه، وهو حليفه وصهره، مغلولا لعدوّه اللّدود. ففي السياسة تجاوزات يقبل عليها فقراء الإيمان بالقيم.
اسر "يوغرطة" وأخذ الى روما ليمثل في موكب النصر الذي أقيم إجلالا للقائد "ماريوس" الذي لاحق "يوغرطة" من ربع الى ربع، ومن مدينة الى مدينة، ولم يتمكن من القبض عليه إلا بالغدر والخيانة. وبعد مثول "يوغرطة" في الموكب، ألقي به في غياهب "سجن التوليوم Tullianum بروما.
بعد أيّام قلائل، أجهز عليه خنقا وهو في غيبوبة، من شدة البرد وقساوة الجوع، سنة 105 قبل ميلاد المسيح. فضمت على إثر ذلك مدينة مكثر من المملكة النوميدية الى المملكة الرومانية بأفريقة. وأصبحت المدينة تابعة للولاية التي أطلق عليها اسم "أفريقة الجديدة: "Africa Nova" إثر معركة "تابسوس" وانتحار "يوباي الأول" " سنة 46 قبل ميلاد المسيح.
ومن نتائج هذه الأحداث، تسربت الحضارة الرومانية الى المدن والقرى والأرياف ومنها مدينة "همكتريم" ، التي تغير اسمها لاحقا بصيغة لاتينية "مكتريس" "Mactaris" مع العلم أن حرف :C" في اللاّتينية كان في نطقه أقرب إلى القاف العربية منه الى الكاف، ودليل ذلك في لقب قيصر الذي يكتب بالحرف اللاتيني "Caesar" وينطق بالعربية "قيصر".
ولئن ترونقت المدينة وتحلّت بروائع العمارة الرومانية من معابد وحمّامات وفوروم 10 وأقواس النصر، وبيوت فخمة، وشوارع مبلّطة، فلم تتخلّ عن تراثها النوميدي البوني. ودليل ذلك في العمارة واللغة والأعلام الآدمية، فلقد تباهى أعيان المدينة في لباسهم وفي أسمائهم وفي بعض مظاهر الحياة اليومية عندهم، ولكن بقيت العامة متشبثة بالجذورالنوميدية، وبما أخذوه عن الحضارة القرطاجية البونية. وطقوسها كتلك التي كانت تقام في فضاء مقدس يعرف لدى المؤرخين المعاصرين باسم "التوفاة" فما تكون؟
التوفاة اسم مازالت أصوله اللغوية يتخللها بعض الغموض، فلم يتوصل فقهاء اللغات السّاميّة إلى تشخيص المادّة اللّغويّة، التي اشتق منها الاسم أو الى من ينتمي. فيرى بعضهم أن كلمة "توفاة" منحدرة عن جذر أرامي دون تشخيص لذلك الجذر بدقة مقننة. والثابت أن ذكر "التوفاة" ورد في بعض آيات العهد القديم من الكتاب المقدّس. ففي الآية العاشرة من "الإصحاح الثالث والعشرين" من "ثاني سفر الملوك" جاء ما يلي:" ودنس التوفاة الذي في وادي بني هنّم حتّى لا أحد يمرّر ابنه أو ابنته في النّار الى مولوك"
كما ورد اسم "التوفاة" في الآية الواحدة والثلاثين من "الإصحاح السابع لسفر إرميا": "وبنوا مرتفعات التوفاة الذي في وادي بن هنّم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار وهو ما لم آمر به ولا مرّ بخاطري".
وعليه، ففي سياقات العهد القديم، يشير اسم "التوفاة" إلى فضاء مقدّس، فيه نار مؤججة. ويبدو أنّ "الكنعانيّين" ومن اقتدى بهم كانوا يرمّدون أبناءهم وبناتهم فيها قربانا للملوك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن "وادي هنّم" تعريب لما ورد في النصوص العبرية في عبارة "جي هنّم". مع العلم أن كلمة "جي" العبرية تعني الوادي و"هنّم" اسم علم، ومن "جي هنّم" صيغ اسم "جهنّم" المذكور في القرآن الكريم. فهل كان "الفينيقيون" في "صور" و"صيدا" و"جبيل" يقيمون مثل هذه الشعيرة؟. إن الاجابة عن مثل هذا التساؤل تستوجب وثائق خطيّة، أو عناصر أثرية، ا تتوفر في المدن الفنيقية المشرقيةّ . أما في "قرطاج"، فقد كشف الغطاء عن فضاء مقدّس، دفنت فيه قوارير تحتوي على رماد أطفال صغار السنّ . بل غالبهم من المعجّلين أي من الأجنّة، مع العلم أن القوارير تعد بالآلاف وقد دفنت جميعها في بطن الأرض المقدّسة.
وانطلاقا من هذا الاكتشاف الذي تم صدفة في شتاء سنة 1921 ، رأى بعض الآثاريين، وقتئذ أن ما أسفرت عنه الحفريات في "قرطاج" تجسيد لما ورد في العهد القديم من الكتاب المقدس. أي لتلك الآيات التي تتحدث عن توفاة بوادي "هنّم". ووجد بعض المفسّرين التوراتين في ذلك برهانا، يثبت صحّة ما ورد في أسفار العهد القديم. وتعزيزا لهذا التفسير، لم يتردد بعض المؤرخين المعاصرين الغربيين في تسخير نصوص دعائية، تستهدف "قرطاج" وحضارتها. فكان مضمون الدعاية أن القرطاجيين قوم ليس في قلوبهم للبرّ والرحمة مكان، حتّى أنهم يقبلون على تقديم أطفالهم قربانا لكبير آلهتهم "قرونوس" وكانت المعادلة بين "مولوك "Molk" و"قرونوس "Cronos قائمة في نصوص القدماء وتبنّاها المؤرخون المعاصرون. هكذا تمّ الرّبط بين تلك الأطلال القرطاجيّة، من جهة، وبي نصوص المؤرخين القدامى، ونصوص الكتاب المقدّ س من جهة ثانية. وفي ضوء تلك القراءة، بات عامّة الناس، من مؤرخين وغير المؤرخين، غربا وشرقا، يعتقدون أن القرطاجيين كانوا يقدّمون أطفالهم قربانا لإله التوفاة. مع العلم أن كلمة توفاة لم تكن معروفة عند القرطاجيين، فالفضاء الذي وجدت فيه القوارير والأنصاب كان يسمى عندهم "قدس بعل حمون". وبذلك ساهم الرسامون والأدباء والشعراء في بث هذه المؤامرة حتى رسخت في العقول والنفوس ضمن تيار جارف معاد للسّاميّة. وبالتالي معاد للعرب والمسلمين ومنتصرا لحركة الاستعمار، والعرب عن كلّ ذلك غافلون.
ومن بين الأعمال الأدبية التي نالت من سمعة "قرطاج"، وانتشرت انتشارا منقطع النظير رواية "صلامبو" لغوستاف فلوببير Gustave Flaubert
و لهذا التيار المعادي لقرطاج وحضارتها أثر في مختلف الفنون من شعر ومسرح ورسم.
والمؤسف أن بعض أدلاء السياحة في تونس مازالوا يردّدون هذه المقولات المعادية لتاريخ "قرطاج" ومن ورائها للعرب والمسلمين. والحال أن بحوثا معاصرة جديدة فنّدت تلك الآراء، وأثبت أصحابها أن ما أوردته النصوص الإغريقية اللاّتينية، وليد خيال خصب. سخّر لتشويه سمعة "قرطاج"، وهي قراءة خاطئة لما كان يمارسه القرطاجيون تجاه الأطفال الذين يموتون صغار السن، وتجاه المعجلين ضحايا الإجهاض. فكانوا لا يقبرونهم دفنا في المقابر بل ترمّد رفاتهم طبقا لطقوس نجهلها تعرف ب "المولك Molk . حيث يوضع الرّماد في أرن من فخّار، تدفن في أرض ذلك الفضاء المقدس المخصص لعبادة الثنائي الأكبر، المولى "بعل حمّون" والربّة "تانيت". وقد سميّا معا في نصوص تكاد لا تحصى عددا، سطرت على أنصاب كانت تعلو الأرن "Urnes" ممّا يثبت العلاقة بين هذه وتلك. ولكن ماهي الأنصاب؟
يقال نٌصب بضمّ النون والصاد ومفردها نصب بفتح النون وسكون الصاد. النصب حجرة قد تكون منجورة مهيّأة او شظية أي كما خرجت من المحجر. فمن الأنصاب ما ينحت في شكل قفّ "Cippe" أومذبح ""Pilier" أو عمود "Autel". وقد يتحلى مهاد بعضها بصورة "ناووس" بالمعنى الإغريقي، وهو غرفة .مخصوصة لصورة الإله. ويكون "الناووس" مقتبس من العمارة السامية الفينيقية، أو من العمارة المصريّة الفرعونية، كما اقتبست بعض النواويس من العمارة الإغريقية. هذا وتزدان نصب التوفاة بصور مستوحاة من عوالم مختلفة، كالهندسة، والحيوان، والنّبات. ولا تخلو مصورة الأنصاب من مشاهد الحياة اليومية، ولا من صور الآلهة، والرموز فترى القرص والهلال. هذا، ومصورة الأنصاب تختلف باختلاف المحيط، ومشاغل الحرفيين. فمصورة الأنصاب في توفاة "قرطاج" تختلف عن مصورة أنصاب التوفاة في "سوسة" أو عن مصورة أنصاب "قسنطينة" بالجزائر، وغيرها من المدن البونية كالتي في جزيرتي "صقلية" 17 و "سردينيا" 18 وبالإضافة إلى هذه النقوش، والنحوت، والرسوم المختلفة، تحمل الأنصاب نقائش ومفردها نقيشة، والنقيشة كتابة يسطرونها بحروف تختلف باختلاف اللغة. قد تكون في البلدان المغربية بونية، أو لاتينية، أو لوبية، أو إغريقية.
وللحرف البونية أشكال عديدة، منها الهندسية أو المعمارية "Monumental" والحرف النسخية تعريف نقترحه لأول مرّة لتبيان الفرق بين حرف ترسم بحركة بطيئة متأنية، متمعنة، قد تستخدم لزخرفة العمارة. وحرف ترسم بسرعة واختزال، تستخدم للكتابة بالحبر والقلم، على حوامل رهيفة، كالجلد والبردي وغيرها. وكتابة هذا الصنف توصف غالبا بالبونية الحديثة. يعتقد بعضهم أنها كتابة نشأت بعد سقوط "قرطاج" سنة 146 قبل ميلاد المسيح، وهو خطأ منتشر بين الناس بل حتى بين أهل الاختصاص.
فلا بد من التذكير بوجود ذلك الصنف من الحروف السريعة المختزلة الأشكال، في نصوص تعود إلى ما قبل الغزوالروماني. فالمرجّح أن القرطاجيين والبونيين عامة كانوا يكتبون بخطّ معماري، حروفه هندسية، وخط نسخي سريع، حروفه مختزلة. ومن خصوصية هذه الكتابة النّسخيّة تشابه بين بعض الحروف.
هذا ويمكن الحديث عن كتابة خطيّة تلك التي تسعى إلى جمالية الحروف وبيانها، وكتابة نسخية تستند إلى الاختزال، وتستهدف السرعة. ونشير انه كثيرا ما ينجرّ عن الاختزال غموض، يزيد العجم والقراءة عسرًا ومثال ذلك أن لحروف الباء والدّال والرّاء نفس العلامة أحيانا. يرسم كلّ منها في شكل مطّة قصيرة تصوّر من أعلى إلى أسفل مع ميل طفيف نحو اليمين حتّى أن كلمة "بد" وكلمة "رب" تكتب على نفس المنوال، هنا يتدخل عامل السياق للتمييز بين حرف وآخر.
فلا يصح الحديث إذن عن كتابة او حروف بونية حديثة، نظرا لوجودها في نصوص قرطاجية تعود إلى ما قبل سقوط "قرطاج" إثر الحرب الرومانية البونية الثالثة. فهي صفة لا يجوز سحبها إلاّ على نصوص تكون لغة تحريرهابونية، تعود إلى ما بعد سقوط "قرطاج" فهي نصوص بونية حديثة.
ويمكن سحب نفس الصفة على حوامل تلك النصوص كالأنصاب. فهناك أنصاب بونية، تلك التي تعود إلى ماقبل سقوط قرطاج الأولى. وأنصاب بونية حديثة وهي التي أقيمت في المعابد، بعد سقوط الدولة القرطاجية.
فأنصاب مكثر أنصاب بونية حديثة Néopuniques، تشير إلى وجود فضاء مقدس في المدينة من فصيلة ما يسمّى بالتوفاة. ولمثل هذا الفضاء المقدس، انتشا را في عديد المدن والقرى النوميدية، سيما في تونس والجزائر. كما له حضور في "صقلية" وفي "سردينيا"، ومن اللافت أن الشعيرة بقيت حية في بعض المدن والقرى زمنا طويلا، بعد الغزو الروماني. وان تغيرت الحركات والأقوال وأصبحت اللغة لاتينية وأصبح "بعل حمّون" يسمّى "ساتورنوس".
على أنصاب تطورت أشكالها ومِصورتها دون إقصاء الموروث. كان لمدينة مكثر فضاء مخصوص لعبادة "بعل حمّون"، فيه أنصاب ذات لغة بونية، وحروفها نسخية، أشكالها مختزلة، ثمثل كل ما بقي من توفاة مكثر. هذا ولم يتمكن الآثاريون من تحديد موقع هذا الفضاء المقدس بالدقّة المطلوبة.
فالأنصاب الدّالة على وجود معبد في مكثر من فصيلة ما يسمى ب التوفاة، لم تكن في موقعها الأصلي. بل يبدو أنها بعثرت أثناء الفترة الرومانية في ظروف نجهلها، والتقطها المولعون بالمعالم القديمة والأثاريون، هنا وهناك، أثناء تجوالهم في تلك الربوع، او اسفرت عنها الحفريات والتنقيبات التي قاموا بها بصفة شرعية أو غير شرعية.
ولعل الكثير منها استخدمت أحجارا لإقامة بعض البنايات، دينية كانت أو مدنية. كما انه من المؤسف أن الذينعثروا عليها لم يروا من المفيد وصف سياقها الأثري، وصفا دقيقا بل اكتفوا بالإشارة إليها، ودراسة ظروفها المسطورة بالحرف البونية النسخية كما أشاروا أحيانا إلى مِصوَرورتها.
وتوزّعت هذه الأنصاب على عديد المتاحف الوطنية والأجنبية ومازال الكثير منها قابعا في المخازن والمستودعات دون إحصاء دقيق، مما يجعلها عرضة للإتلاف والضياع. فهناك أنصاب مكثريّة بمتحف "باردو" وأخرى في مستودعات مكثر ومتحفها الجميل. وفي ممتلكات المتحف البريطاني بلندن، باقة من الأنصاب تعود إلى رصيد مكثر، كما ان هناك ما استأثر به متحف "اللّوفر" "بباريس". فالبحث عن هذه الأنصاب المكثرية المشتتة يستوجب رحلة طويلة، بين متاحف المدن الأوروبية، الكبيرة والصغيرة.
ولا يستغرب أن تجد بعضها في متاحف الولايات المتحدة أو حتى في روسيا. ذلك ان للأنصاب القديمة والتحف عرفت سوقا نافقة خلال القرن التاسع عشر، والقرن الذي تلاه، فكانت لها المجموعات تنقل من بيت إلى بيت ومنها هاو إلى هاو.
فمجموعة الأنصاب التي أقامها سكان المدينة العتيقة، أو المترددون عليها قديما لزيارة صاحب التوفاة المحلّي معروفة منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد أشار إليها المولعون بالأطلال، وتواصل الاهتمام بها بعد انتصاب الحماية الفرنسية. ففي السنة التي سجلت خضوع الإيالة التونسية لهيمنة فرنسا، شرع الضابط "ديزيري بوردياي" "Désiré Bordier" تنفيذ حفريات هدفها كشف الغطاء عن كنوز "مكتريس". وهو الضابط العسكري الذي كلف بإقامة أول مراقبة مدنية في مكثر ثم تعاقب عليها الرحالة، والسيّاح يريدون التعرّف على معالمها. كما تعددت نتائج الحفريات، على أنّ القسط الأوفر يحسب لحفريّات الباحث الفرنسي "جيلبار بيكارGilbert Picard " وهو ممن ترأسوا إدارة الآثار التونسية في عهد الحماية الفرنسية، وأفرد لمدينة مكثر وأطلالها، دراسة مطولة دقيقة نشرتها مجلّة كرطاغو "Karthago" في جزئها الثامن الصادر سنة 1957 اين يجد القارئ المصادر والمراجع التي استند إليها الباحث، تجدر الإشارة انه كان قد ركز على معالم تعود إلى الفترتين النوميدية والرومانية، ولم تحظ أنصاب التوفاة إلا بإشارات عابرة لا تمكّن القارئ من التعرف عليها بالدقّة المطلوبة.
من حسن حظ المهتمين بالأنصاب، لاسيما أنصاب توفاة مكثر، أنهم يجدون دراسات أخرى تناولتها، ونشرت اغلبها خلال القرن الماضي. نشير في هذا المقام إلى ديوان "كولات بيكار Colette Picard إلى مجموعة الأنصاب البونية، والبونية الحديثة الموجودة في متحف "باردو" وقد تم ذلك سنة 1958.
فأحدث ما نشر حول النصوص المسطورة على أنصاب مكثر، ندين به إلى الباحث الهولندي "كاريل يونجيلينج Karel Jongeling. وهو كتاب جمع فيه باقة من النقائش البونية الحديثة، وتناولها بقراءة نقديّة انطلاقا " مما نشره بعض الدارسين في عديد المجلاّت والدّواوين المختصّة. ومن بين أنصاب توفاة مكثر، مجموعة كبيرة عثرعليها في النصف الثّاني من القرن العشرين، إثر ترميم بوابة معروفة باسم "قوس باب العين".
فلمّا كان أعوان البلديّة يرممون هذا المعلم بالتعاون مع مصلحة الآثار، تم العثور على مجموعة من الأنصاب استلت من سياقها التاريخي الأثري واستخدمت لأسس البوابة.
والمؤسف أنها وجدت مهشمة الى شظايا، فلعلّهم فعلوا ذلك ليتسنى ترصيفها مصطبة، تنتصب عليها قوائم البوابة في شموخ، بعيدا عن خطر الانجراف والانزلاق. فكان من حكمة المشرفين على الحظيرة الحديثة أن يأخذوا أشلاء تلك الأنصاب ويعوّضها بالإسمنت المسلح. فبالتقاطها تكونت مجموعة بعضها يحمل الصّورة والحرف وبعضها لا يحمل سوى نصّ مسطور. وهناك أنصاب أخرى لا تحمل إلاّ أثرًا لصور، كانت تتحلى بها قبل تهشيمها. فماذا عن هذه الأنصاب وما هو عطاؤها؟
ليس المجال هنا لتقديم مجموعة الأنصاب التي كانت في توفاة مكثر، فتلك عملية تستوجب بحوثا مطوّلة معمقة، بل لا يستقيم تقديمها إلاّ في ديوان متكامل، يجمع بين الوصف المادي والتحاليل اللغويّة والأيقونوغرافية والتّاريخية والدّينية. مع محاولة التعرّف على معاني الصور وخبايا الرموز وجرد دقيق لمعاجمها المختلفة. وفي مثل هذه البحوث المطولة، يتوجب استعراض ما كتب حول الموضوع المتناول، ومناقشة تحاليل السابقين والتفاسير التي اقترحوها. أمّا هنا، فسوف نقتصر على نماذج خمسة تساعد على رسم الملامح العامة استنادا إلى النصوص والصور.
نصب من كلس أشخم، صلب مكسور، أتلف منه أسفله وما بقي منه يمثل شكلا يتكون من مستطيل يعلوه مثلث. فلعل النصب نحت في شكل مِسَلّة أو واجهة ناووس، يتعذر قيس أبعادها كاملة فطول الجزء الباقي 60 سم وعرضه 40 سم وسمكه ينيف عن 12 سم.
قسّم مهاد النصب La face polie إلى جداول ثلاثة بعضها فوق بعض. فلم يبق من الجدول السفلي إلا جزء طفيف يوحي بمحراب مقوس القمّة. فهل كان يحتضن عابدا أو معبودا؟ سؤال تعسر الإجابة عليه. وفي الجدول الأعلى نقوش تتوزع هي الأخرى على جداول ثلاثة عموديّا، دون فواصل. وهذه قراءتها من أسفل إلى أعلى: طائران متناظران قد يكونان من فصيلة الحمام، ثم نرى فوقهما دلفينين متناظرين. ورسم النحات في قمة المثلث، هلالا يضمّ نجما سداسي الأشعة، فهي نحوت من صنف المنبسط Méplat .
النصب الأول: الصورة الأولى
تشير أو ترمز إلى الأرض والبحر والسماء حتّى كأنها وصف مجازي لمسيرة الإنسان التي تبدأ برّا، ثم تتواصل بحرا قبل العروج نحو السّماء. أو هي صور ورموز تتناول عالم الجسد، وعالم الروح وهو السماء، حيث توجد مدينة الأرواح. هذا ولا بد من إشارة إلى رمّانة، رسمت ملامحها حفرًا بالمنقاش في زاوية، تقع على يمين المحراب، تحت ثالث سطورالنقيشة وأواخر حروفها. والرمانة ترمز إلى الخصب والرخاء، وهي من الثمار الموعودة في ديانات المتوسط. وخصص الجدول الأوسط لنقيشة سطرت بالحرف البوني النّسخي أو السريع، لم يترك لنا الكسر منها إلاّ أسطرا ثلاثة وحرفا واحدا من الرّابع قد يكون لامًا.
النقيشة:
عوّدنا الباحثون المختصّون في دراسة النقائش السامية بنقلها إلى الحرف اللاّتيني، حسب معادلات صوتية. من وضع بعض المستشرقين، تحقيقا للمتن وتيسيرًا لقراءتها لمن لا خبرة له في الميدان. وقد كان المستشرقون في الجامعات ومراكز البحوث، خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يستخدمون الحرف العبري لتشخيص حروف اللغات السامية، كالفينيقية، والسبئيّة. هو ما يتجلّى في الأجزاء الأولى من ديوان النقائش الساميّة، وفي مختلف الدراسات التي نشرت قبل منتصف القرن الماضي في فرنسا. وبقي الحرف العبري مرجعا في البلدان الأوروبية إلى حوالي سنة 1970 . على أن بعض الدارسين بقوا متشبثين بالحرف العبري، لاسيما في جامعات إسرائيل ومراكز البحوث فيها. فالإسرائيليون يستخدمون الحرف العبري لنقل النصوص السّامية، أيّا كانت. ونظرا ليسر إقامة المعادلة الصوتيّة بين الحرف البوني، والحرف العربي، انتهزنا الفرصة لنقل حروف هذه النقائش البونية إلى ما يقابلها في الأبجدية، العربية ونقترح هذه الطريقة على أهل الاختصاص في العالم العربي.
نص النقيشة بالحرف العربي:
لأدن بعل حمن كع شمع قلم بركم بعلا
همكتعريم عتر حملكت بن رعوتو جعص
يوعنبن أرشلمات بن متنبعل بن معص
يجب في البداية التذكير بأن حروف الحلق في هذا النص وفي غالب النصوص البونية الحديثة، تكون تارة جذريّة أي أنها من صميم المادّة أو الكلمة. فحرف العين وهو من حروف الحلق يبدو جذريّا في اسم "بعل" وفعل "شمع" وله قيمة صوتيّة في "كع" وفي "همكتعريم"
ففي هذا السّياق، يستخدم حرف العين لرسم الفتحة، أو رسم صوت قريب منها. فكأن السّاطر أراد مساعدة القارئ، حتّى يحسن نطق لفظة "كعكَ " مفتوحة فحرف العين في "كع" أضيف للمساعدة على القراءة. خاصة لدى قرّاء لا ينتسبون إلى أصول سامية، هم من "أرومة لوبية نوميدية" . وكذلك الشأن بالنسبة للعين في اسم المدينة "همكتعريم" حرف قراءة Materlectionis لا علاقة له بالجذر.
هذا، وقد ترسم الفتحة في شكل حرف الحاء وقد يرسم صوت "O" اللاّتيني في شكل ألفٍ فهذه من خصوصيات النصوص البونية الحديثة. التي نجدها في غالب المدن والأرياف النوميدية، وتنضاف إلى اختزال الحروف في الكتابة النسخيّة مما يزيد قراءتها عسرٍا. ولهذه الكتابة النسخية مميّزات أخرى، لابدّ من معرفتها، لمن أراد قراءة النصوص البونية الحديثة وفهم مضامينها.
تعريب النقيشة:
إلى المولى بعل حمون إذ سمع قولهم باركهم
بعول همكتريم زمن إدارة خملكت بن راوتو جص
يون بن أرشلمات بن متنبعل بن معص (أومص...)
مضمون النقيشة:
تمثّل هذه النقيشة البونية المسطورة بالحرف المختزل، أو بالخط البوني النّسخي نصّا لنذرٍ أو إهداء توجه به "بعول همكتريم" إلى "المولى بعل حمون". وكان ذلك زمن إدارة "خملكت بن روتوجص"... "يون بن أرشلمات بن متنبعلبن مصون" فهو نذر أو دعاء جماعي. فهل كان ذا صبغة رسمية؟ لا يمكن الجواب عن هذا السؤال إلاّ بمعرفة منهم "بعول همكتريم"؟ فلا شك أنهم من كبار القوم ومن أعيان المدينة. وإذا كان ذلك كذلك، فما هي مكانتهم في المحافل السياسيّة والإداريّة والدّينية؟ هل كانوا يمثّلون هيكلا أو هيئة من هيئات الإدارة في المدينة؟ والجدير بالذكر أن "للبعول" حضور في عديد النصوص في مكثر وفي مدن أخرى "كدقة" و"مدّد" وكانت تسمى "همدديم" وغيرها.
ليس المجال هنا لإثارة "مسألة البعول(31)"في المدن النوميدية بين القرن الثاني قبل ميلاد المسيح، والقرن الأول أو الثاني بعده. علما أن أقدم إشارة لهذا الهيكل وردت في نقيشة تتحدث عن معبد أقامه "بعول دقة" لروح الملك "مسّنسنMassinissa". وكانت تسمى في لهجة النوميديين "تبجج" أو "تبجّ". أمّا إقامة المعبد المذكور فقد تمت في السنة العاشرة من سلطان "مكوسن" المسمى عند الرومان "ميقبسةMicipsa" أي سنة 138 فبل الميلاد. وقد ورد في النقائش المكثريّة ذكر هيئة "البعول" في النقيشة التي نحن بصدد التعرّف عليها. لكنها عسيرة التوريخ نظرًا لعدم معرفتنا لسياقها الأثري، ويمكن تنزيلها فيما بين القرن الثّاني قبل الميلاد والقرن الثاني بعده.
ولكن لابدّ من كلمة حول اسم المدينة وقد جاء في صيغة "همكتريم". فالهاء تمثل هنا أداة التعريف، مثل ما هو الحال في اللغة العبرية القديمة والحديثة. فالهاء تمثل أداة التعريف في كلتا هاتين اللغتين السّاميتين، وتساويها في اللغة العربية الأداة المركبة من الألف واللاّم. ولذلك نعرّب "بعلا" البونية فنقول "بعول" في حالة مضاف، وبالتالي "همكتريم" تكون مضاف إليه. ثم لا بدّ من الوقوف عند صيغة الجمع في "همكتريم" فهل يمكن تعريبها بــــــــ"المكتريين" فالبعول هم "بعول المكتريين". ولكن لماذا استعمال صيغة الجمع المذكر في هذا العلم الجغرافي؟ وهو ما نلاحظه أيضًا في اسم مدينة أخرى قريبة من مكثر وهي "همدديم"؟ ويرجح أننا نجد نفس الصيغة في الاسم البوني لمدينة سوسة وهو "هدريم". فبالنسبة لاسم "هدريم" فقد يكون جمع "در" أي الدّار أو البيت. تشير كلمة "دريم" إلى مجموعة من الديار، وعلى هذا الأساس يمكن تعريب "هدريم" بقولك "الديار". والدار قد تكون بيتا أو مجموعة من البيوت، تسكنها عشيرة وتحاط بجدار مستدير الشكل. وهو ما يستوحى من المادّة نفسها. هذا، وتوجد في فلسطين قرية تحمل اسم " Dor در ".24
أمّا "مكتريم" و"مدديم"، فالمسألة تبدو مختلفة فمفرد الأولى مكتر أو مكثر ومفرد الثانية "مدد". ولكن يبقى السؤال مطروحا حول معنى مكتر و"مدد" في اللغة اللوبيّة واللهجة النوميدية الشرقية على وجه الخصوص. فهل يجوز اعتبار "مكتريم" اسم عشيرة نسبة إلى مسمى مكتر أو مكثر حسب النطق؟ ذلك أن اللغة البونية لا تفرق بين التاء والثاء في مستوى الكتابة. وقد يكون الاسم النوميدي مكتر أو مكثر يعني شيئا آخر ذو صلة بالمحيط. كالنبات والحيوان والتضاريس وغيرها. هكذا تبقى مسألة "مكتريم" مطروحة علّها تجد حلا في ضوء بحوث أخرى، ومعلومات جديدة حول التوبونيميا Toponymie أي علم الأسماء الجغرافية(33).
وأيّا كان الأمر من مسألة اسم المدينة، فثابت أن "بعول" مكثر وجّهوا دعاءهم إلى "بعل حمون"، الإله الأكبر في "قرطاج"، وصاحب الفضاء المقدس المسمى توفاة عند المؤرخين المعاصرين. "وقدسبعل حمون" عند القرطاجيين وهو فضاء مقدس، لم يكن مخصصا لتقريب الأطفال، كما تدّعي بعض الأوساط المشحونة عداء تجاه قرطاج وحضارتها. بل هو فضاء يؤمه البونيون وغيرهم للنذور والأدعية، أيا كان الموضوع ومضمون الدعاء. فكل من له طلب يريد التوجه به إلى "بعل حمون" فله ذلك وتكون الرسالة، غالبا، مشفوعة بقربان أو تقدمة. وهذه شعيرة ذات أصناف عديدة، منها القربان الدّموي، وهو الذي يتمثل في تقريب حيوان يذبح حسب طقوس لا يعرفها إلاّ الكهنة. ولعهم كانوا يريدونها سرًا لا يبوحون به لغيرهم، فهم الذين يقومون بعملية التقريب ولعلهم يتولون، عند الحاجة، تلقين صاحب القربان ما يجب قوله وفعله لتكون الرسالة مضمونة الوصول.
وفي هذه النقيشة معطيات توثق تاريخ القربان أو النذر أو الدعاء، وتثبت أنّه تمّ في زمن إدارة "خملك" 25المعّرف باسم أبيه وجدّه. والجدير بالملاحظة أنّ رئيس الإدارة المشار إليه في هذا النص يحمل اسما بونيا ومن أسلافه من له اسم بوني "متنعل". هذه عناصر تلقى ضوء، وتنير طريق من قد يريد الوقوف على تطور المجتمع، وعلى تسّرب الحضارة البونية في الأوساط النوميدية.
كسر النصب واتلف أعلاه وأسفله والباقي أبعاده كالتالي: 12 سم من أعلى إلى أسفل وعرضه 30 سم وسمكه ينيف عن 12 سم. وزّع المهاد على جداول ثلاثة منتصة عموديّا، وهيئ الجدول الأعلى لتصوير طائرين متناظرين. وفي منقار كيلهما قرن خصبCorne d’abondance، الأرجح أنهما من فصيلة الدّيكة. فالعرف مرفوع وللذيل ريش طويل وفير وهي من مواصفات هذه الفصيلة من الدّواجن.
ونحت الجدول الأسفل في شكل محراب محفوف بشريط مصقول في سمك المهاد، وقد انتص فيه شخص لم يبق من صورته إلا رأس كري الشكل. له عينان مستديرتان جاحظتان، يعلوهما حاجبان مقوّسان. ورسم الفم حزا أفقيا يشرف عليه أنف عمودي، وله أذنان طويلتان ويبدو أمردا لا لحية له ولا شارب. وعلى رأسه قبعة تبدو حافتها
على الجبين كالهلال. فالأرجح أن المحراب نحت ليتجلّى فيه العابد، صاحب النصب، أو ذاك الذي من أجله أقيمت الشعيرة وأنجز النّصب.
النقيشة:
خصص الجدول الأوسط إلى نقيشة بونية نسخية الكتابة. وقد أسكنها الساطر في خرطوش مستطيل الشكل، مصقول، في سمك المهاد. ورسم محيطه حزّا بالمنحت. أمّا النقيشة، فسطورها ثلاثة وهذا نقلها بالحرف العربي:
النصب الثاني: الصورة الثانية
لأدن بعل حمن كح شمع
قلا بركا معرعو
كني بن بركبعل بن ايكنع
تجدر الإشارة إلى استعمال حروف الحلق لرسم الحركات26 في بعض الكلمات، واستعمل بعضها لرسم ضمير الغائب المذكر. وهو ما نجده في السطر الثاني ملحقا باسم "قل" وقد جاء في صيغة "قلا". فالألف تمثل الضمير "فقلا" تعني "قوله" أو "صوته". ونجد الألف ملحقا بفعل "برك" ، وفي السطر الثاني نجد "بركا"، حيث يمثل الألف هنا أيضا ضمير الغائب المذكر، فعلى هذا الأساس، "بركا" تعني باركهُ.
وما دمنا نتحدث عن قيمة حروف الحلق في النصوص البونية الحديثة، فلا بدّ من إلاشارة الى مضمونها. حيث أن الفتحة رسمها الساطر هنا حاء، فحاء "كح" ليست جذرية بل هي حرف قراءة Mater lectionis ، يساعد على النطق الصحيح. فالحاء في "كح" تساعد القارئ ليضع فتحة على الكاف، ويقرأ "ك" بالفتح.
وقد تكون الفتحة خفيفة أو مفخّمة، والجدير بالتذكير هنا أن ساطر النقيشة السابقة استخدم حرف العين لمثل هذه الوظيفة. مما قد يشير إلى عدم "التقعيد" في هذا المجال، وفي زمن هذه الأنصاب، مع اعتبار محيطها حتّى كأن قواعد الشكل مازالت غير ثابتة.
أما صاحب هذا النصب فهو "معرعوكني بن بركبعل بن ايكنع". جاء اسمه في ثوب قد يوحي بالرومنة، لأنه ينتهي بحرف الياء كغالب الأسماء الرومانية، التي نقلت نقلا صوتيا إلى اللغة البونية. فهل هو من تلك الأسماء الرومانية التي تنتهي بالياء عوض اللاّحق اللاتيني"ius" "كيوليوسIulius"و "سيقيليوسSicilius". هذا ولا يستبعد أن يكون نوميدي الأصل، وهو ما ذهب إليه كريل يونجيلنج Jongeling Karel ، في كتابه "أسماء في النقائش البونية الحديثة". في حين أنّ والد صاحب النصب يحمل اسما بونيا "بركبعل" ، وهو من الأسماء المنتشرة في "قرطاج". واللافت أيضا أن لجدّه إسما لوبيّا نوميديّا "ايكنع" وهو من الأسماء النوميدية المعروفة27.
إلى المولى بعل حمون إذ سمع
قوله باركه، مروكني بن بركبعل بن ايكنع
تعريب النقيشة:
لم ينج هذا النصب من الكسر، وانعدم جزء كبير من أسفله، ولكن ما بقي منه يثبت أنّه كان مهيأ في شكل محراب. قوسه يتحلى بضفيرة من سعف، يعلوها ساكف زخرفته خطوط متقاطعة. ومن نقوش هذا الجدول رمانة على يمين قوس المحراب، ورأس ثور أو "جمجميّة Bucrane (37)" على يساره. ويتحلى الجدول الأعلى وهو في شكل مثلث بصور، منها طائران متناظران، وفي منقار كيليهما سعفة يبدو أنّهما من فصيلة الحمام.
وللحمامة حضور في المصورة البونية، لها علاقة بإلهة الحب والخصب والجمال. كما أنها تسهر على سكينة الموتى. وهي الآلهة "عشترت" عند القرطاجيين، أصبحت لاحقا تسمّى "فينوس" أو "وينوسVenus"في ظلّ الرّومنة.
أما السعفة فهي تشير إلى النخلة، والنخلة شجرة الحياة في مختلف الحضارات السامية. من دجلة والفرات إلى البحر الأحمر ومنه إلى "قرطاج". وللنخلة حضور في مخيال بلاد النيل والربوع اللّوبية. وعلاقة الحمامة بعرف الشجرة، زيتونة كانت أو نخلة، كرستها مصورة السّاميّن الأول، وجسدتها بالحرف والصورة في دنيا الشعوب السامية منذ أقدم العصور، فالنخلة حياة والحمامة حبّ وسلام.
وفي قمة المثلث "ورديةRosace" سداسية البتيلات، تحيط بها دائرة حفرت في سمك المهاد، وحولها نقر ثلاث. حفرتها يد النحات بعناية فائقة، مستخدمة آلة كالمشعاب فما هي وظيفتها؟ وهل جعلت لتستوعب أزرارا أو رؤوس مسامير، تكون كالدرر تزيد النّصب ألقا؟
وتحت الوردية شكل كالهلال في جوفه خطوط كفريضات متوازية صفّين متداخلين. فماذا تمثل هذه الصورة بعناصرها المتكاملة؟ وهل هي وعاء أو سلة من سعف مضفور؟ لقد رأت فيها كولات بيكارColette Picard صورة الهلال مع ضفائر من سعف رسمت في تجويفته.
النصب الثالث: الصورة الثالثة
النقيشة:
لأدن بعل عمن كح شمع
قلا بركا بعصا بن
بركبعل بن معصجريعن
اسكنها الساطر في الجدول المتوسط وقد هيئ خرطوشا مستطيل الشكل، محاطا بخطوط متعامدة محفورة في سمك المهاد. وتحتوي النقيشة على أسطر ثلاثة، كتبت بالخط النسخي أي بحروف بونية مختزلة وهذا نصها بالحرف العربي:
لا بدّ هنا من العودة إلى مسألة حروف الحلق في لهجة المكثرين. فنرى ساطر هذه النقيشة يستخدم حرفي العين والحاء لرسم الفتحة، خفيفة كانت أو مفخّمة، ونلاحظ أن كلمة "حمن" كتبت "عمن" حتى كأن "الحاء" تحولت إلى "عين". والأرجح أن حروف الحلق سقطت وأصبحت وظيفتها مقصورة على رسم الحركات. فهل كان اللّسان النوميدي عاجزا على نطقها حتى يقول "بل" عوض "بعل"؟ وهل كان النوميدي يكتب "بعل" وينطق "بل" عوض"بعل"؟ قد يكون! مع العلم أنّ الرومان كانوا هم أنفسهم ينطقون "بل" وهو ما تثبته عديد النقائش المسطورة بالحرف اللاّتيني. كالتي تم العثور عليها بين أطلال معبد "لساتورنوس" خليفة "بعل حمون".
وكان هذا المعبد يتوج قمّة "جبل بوقرنين".28 وفي بعض النقائش نجد "بحل" عوض "بعل". وأيّا كان الأمر، فلا بدّ من التحري: فالحاء في "بحل" لا تعني أنّ النوميدي ينطق العين حاء، بل قد يفيد ذلك أن العين اختفت لأن اللسان النوميدي لا يستطيع أو لا يستسيغ نطقها. فالحاء في "بحل" وضعت لمساعدة القارئ على فتح الباء، حتى ينطق "بَل" لا "بُل" ولا "بِل" بكسر الباء. ففي هذه النقيشة نجد "عمن" عوض "حمن"، والأرجح أنّ الساطر يكتب "عمن" ويقرأ القارئ "مَن". وكذلك الشأن بالنسبة لأداة التعليل "كح"، فوظيفة الحاء فيها مقصورة على مساعدة القارئ لينطق "كَ" بالفتح. ويبقى سؤال مشروع بالنسبة لفعل "شمع": فهل كان القارئ النوميدي ينطق "شمع" مع اعتبار العين جذرية، أم كان ينطق "شم" بميم مفتوحة حتى ولو كتب شمع؟ تلك إشكالية يعسر حلّها بصفة قطعية، والمرجّح أن العين في "شمع" لا تعدو أن تكون سوى حرف نطق يوصي بفتح ما قبلها.
إلى المولى بعل حمون إذ سمع
قوله باركه، بصوس بن
برك بعل بن مصجرين
تعريب النص:
الجدير بالملاحظة في هذه النقيشة أن صاحب النص يحمل اسما لاتينيا لا غبار، عليه "فبصوس" من الأسماء المعروفة في المعلمة اللاّتينيّة. وله حضور في مختلف ولايات الإمبراطورية. وكان أبو "بصوس" يحمل اسما بونيا "بركبعل" وهو اسم منتشر في قرطاج وفي غيرها من المدن البونية، أما الجد فاسمه "مصجريَن" ويبدو من أرومة لوبية.
هكذا نلتقي بعائلة مكثرية أحسنت التأقلم مع الظروف وتطورت: فالجد عاش نوميدِيّا في زمن انتشار الحضارة البونية. فلما رزق ابنا، أعطاه اسما بونيا يساعده على الاندماج في المحيط الجديد، وييسّر له التفاعل مع حداثة ذلك الزمن. ومع الرومنة، نشأ جيل ثالث يحمل أسماء رومانية: فهذه عائلة أصولها نوميدية فتكنعنت بانتشار الحضارة البونية في المملكة، وكان ذلك بإرادة الملوك أنفسهم. وما أن تسلط الرومان وتسربت الرومنة في الربوع النوميدية الخاضعة لسلطان روما حتى ترومنت بعض العائلات. سيما تلك التي كانت تريد الحفاظ على مكانتها، وحماية مصالحها دون تفريط في عناصر هويتها. أليس من الطريف أن نرى نفس العائلة تعيش ثلاث حضارات متعاقبة؟
نصب هيئّ في شكل مستطيل يعلوه مثلث، وبالكسر أتلف جزءه السفلي وبترت قمة المثلث. وزع مهاد النصب جداول ثلاثة: ففيما بقي من المثلث وجها آدميّا، يحيط به إكليل من سعف مضفور. تتكون ملامح الوجه من عينين لوزيتين، يعلوهما حاجبان، وبينهما أنف طويل، حتى كاد يمس منبت الشارب. أمّا الشفتان، فهما هدْلوان وتحف بتلك الطلعة رمّانتان. ولعلّ قمة المثلث، كانت مسكونة بالأزهرين Les luminaires، الشمس والقمر. ولكن لم يبق منهما إلا أثر طفيف، يتمثل في جزء من تقويرة الهلال. على أنّ قرص الشمس لا مبرر له سوى حضوره المتاوتر، على الأنصاب في مكثر وفي غيرها من المدن النوميدية وتواجده مع الهلال. وينتهي النّصب بالجدول الأسفل ولكن لم يبق منه إلا شريط عرضه لا يتجاوز 4 سم، فيه سمكتان من فصيلة المرجان، ممدودتان في اتجاه معاكس، وتفصل بينهما وردية سداسية وزيمها كثيف ناتئ.
النصب الرابع: الصورة الرابعة
النقيشة:
تحتلّ النّقيشة الجدول الأوسط وقد سطرت في مساحة محفوفة بخطين أفقيين متوازيين، يفصلانها عن الجدولين الآخرين. لغتها بونية نسخية تتوزع على سطرين، وهما كالتالي نقلا بالحرف العربي وعلى أساس المعادلات الصوتية:
لأدن بعل حمن كع شمع قلا
بركا نعدر بن وعرجام
لا جديد يذكر في هذه النقيشة القصيرة. فحروف الحلق موظفة لرسم الحركات على ما قبلها. وصاحب النّصب يحمل اسما نوميديا قد يكون "نبر" أو "ندر" والشك "مأتاه" تجانس الباء والدال من حيث الرسم. وكلاهما يكتب في شكل مطة قصيرة من أعلى إلى أسفل، مع تقوير وميل طفيف نحو اليمين. أمّا أبو صاحب النصب فهو يحمل اسما نوميديا. فالواضح أن انتشار الحضارة البونية، لغة ودينا، لم يقص الأصول النوميدية. بل الغالب على الظن أن المجتمع في مدينة "همكتريم" بقى متأصلا في محيطه، محافظا على هويته وموروثه، مع تفتح على حداثة أهم عناصرها إذ ذاك بونية.
نصب مكسور أتلف جزءه الأعلى وما تبقّى منه يتوزع على جدولين: نحت الأول ناووسًا أو محرابا محفوفا بعمودين مجرّدين، من القاعدة والتاج. وقد انبرى في المحراب شخص واقفا وقفة طقوسية Hiératique ، لا تخلو من الورع والرهبة وهو ينظر إلى الأمام. ولئن أتلف الكسر أعلى رأسه، فقد ظلّت ملامحه واضحة: فهي عينان لوزيّتان، وأنف مستقيم طويل حتّى كاد يلتصق بمنبت الشّارب. والفم ذو شفتين دقيقتين، والعنق كشبه المنحرف يزداد كثافة نحو الأسفل. هذا، وقد ارتدى العابد ثوبًا طويلاً يمتد إلى الكعبين، نسيجه رهيفٌ تتدلّى تجاعيده عموديّا على الجسم. وتتمطّط أفقيّا على الكمين الضيّقين. كما امسك بيمينه ثمرة أو برعم زهرة، يعسر تشخيصها ومسك بيساره جريدة تبشر بالفوز والحياة. أما الجدول الثاني، فقد نزّلت فيه نقيشة ذات سطرين، لغتها بونية وحروفها من الصنف السريع المختزل، وهو ما اقترحنا تسميته بالخط النّسخي وهذا نصّها نقلا بالحروف العربية:
لأدن بعل عمن كع شمع ق
لا بركا روفينا بن فودا
فوظيفة حروف الحلق هي التي ذكرناها بالنسبة للنقائش السابقة، فحاء "حمن" عوّضت بعين وهو ما لاحظناه في نقيشة النصب الثالث وعلقنا عليه. أما الألف في "روفينا وفودا"، فهو يمثّل صوتا بين الضمّة والفتحة المفخّمة. ما قد يساوي الصوت اللاّتيني "o" مع العلم أن الألف البوني في هذا السياق يعوض اللاّحق اللاّتيني"us"
النصب الخامس: الصورة الخامسة.
إلى المولى بعل حمون إذ سمع ق
له باركه وفينوس بن فودوس
تعريب النقيشة:
فصاحب النصب يحمل اسما رومانيا وأبوه كذلك وكلاهما من الأسماء المعروفة في المعلمة اللاتينية Latine Onomastique في شمال إفريقيا29 وفي ولايات أخرى من الإمبراطورية.
فهذه عائلة مكثرية ترومنت لكنها بقيت ملتزمة بالديانة البونية، شعائرًا ولغة، مما يثبت أن الرومنة لم تقص ما قبلها. بل ظلّ النوميديون يمارسون شعائر ديانتهم بكل حرية. ولعل الذين ترومنوا كانوا يتخاطبون باللهجة النوميدية في بيوتهم، وفي الأرياف ويستخدمون اللغة البونيّة في المعابد، وفي الإدارة مجال مفتوح للغة الغزاة الجدد.
الخاتمــــــــــــة:
هذه أنصاب أقيمت بفضاء مقدّس مخصوص لعباده "بعل حمون" وهو رئيس مجمع الآلهة والالهات في "قرطاج" وفي عديد المدن البونية والنوميدية الأخرى. اين أقيمت له المعابد في صقلية وسردانيا، تقدم فيها القرابين والهدايا، كما وتقام الأنصاب حمدا وشكرا للمولى "بعل حمون". لأنّه سامع دعاء الداعي ومنه قريب، يمكّنه من الحصول على رغباته وأمانيه. فلم يكن قدس "بعل حمون" مقصورا على قبول الأطفال الذين يموتون صغار السن، أو المعجلين من الأجنّة، بل كان مفتوحا أمام الناس جميعهم دون إقصاء. ومن اللاّفت أن بعض الإغريق كانوا يزورون قدس "بعل حمون"30 ويقدمون القرابين ويقيمون أنصابًا عليها نصوص بالحرف الإغريقي.
تحمل الأنصاب التي يفردها العابدون لمعبودهم، رسالة تخط بالحرف والصورة. وقد يكتفي هذا العابد بالحرف ويقتصر آخر على الصورة. أما في الأنصاب الخمس التي أردناها نماذج، فالنص والصورة متواجدان على المهاد. ومعلوم أن المصورة البونية النوميدية غزيرة العناصر، وهي مقتبسة من عوالم مختلفة كالنبات والحيوان والإنسان والفلك وغيرها. فمن عالم الحيوان تم تشخيص الحمامة والديك والسمكة من فصيلة المرجان والدلفين ورأس الثور أو جمجمة الثور bucrane. ومن زخارف النبات الوردية والسعفة والرمانة ومن عالم الفلك الهلال والنجمة السداسية في شكل ورديّة. أما قرن الخصب Corne d’abondance فهو من فصيلة الرموز، وهناك صور عسر علينا تشخيصها.
ولا شك أن لعناصر هذه المصورة معان يعرفها الذين رسموها، وقد لا يعرفونها أحيانا، إذ هي من الموروث. وكثيرا ما تختفي مفاتيح الرّموز، ويكتفي الوارثون بنقل الظروف دون تقديم المفاهيم والمعاني. فتكون بذلك ظروف فارغة، فمثلهم في ذلك مثل الذين يرددون كلمات، وعبارات دون وعي معانيها، ومقاصدها، مع نسيان أصولها وثنايا وصولها إليهم. مثال الحرفيين الوحرفيات حيث يرسمون صورا ورموزا لزخرفة زريبة، أو وعاء من فخار، أو جدار أو سلّة، دون إدراك مدلول تلك الزخارف. بل ترى بعضهم لا يستطيع تشخيص رسومه وتسميتها بأسمائها.
فتتقزّم الأشكال وتتفكّك حتى تصبح ألغازا بدون مفاتيح، فضلا عن جهل الحرفي لأصولها ومصادرها وطرق رحلتها حتى وصلت إليه محفوفة بالغموض.
أما النصوص المسطورة على هذه الأنصاب، فقد كتبت بحروف بونية مختزلة وهو ما سميناه بالخط النسخي السريع، على أنّ بعض الحروف لا تختلف عن الحروف الفنيقية الأصلية التي أدخلها الذين أقاموا مدينة "قرطاج". فبتلك الحروف الفنيقية الأصلية سطّرت غالب النصوص التي تحملها أنصاب التوفاة في قرطاج. وأنصاب معابد أخرى بسوسة وصقلية وسردانيا وقسنطينة وغيرها. هذا، والحروف البونية المختزلة، تلك التي تستعمل للخط النسخي السريع والمهيّأة للحبر والقلم، عرف لها وجود في "قرطاج" منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح. فهي تختلف عن أشكال الحروف الهندسية اختلافا كليّا. اسبقنا الاشارة إلى تجانس حروف الباء والدال والراء أحيانا، فهذه الحروف الثلاثة ترسم كمطة قصيرة من أعلى إلى أسفل مع تقوير وميل طفيف نحو اليمين. وحرف النون يرسم خطا طويلا نسبيا من أعلى إلى أسفل مع ميل نحو اليسار. والميم ترسم خطين قصيرين مائلين متقاطعين. والكتابة النسخية لا تخلو من العقبات والمزالق وتبقى عسيرة العجم والقراءة والفهم.
ومن مميّزات النصوص البونية الحديثة، أن حروف الحلق ترتدي قيمة صوتية فحسب، حتّى قيل إنّها حروف نطق أو قراءة Matres lectionis . فالعين والحاء لرسم الفتحة، والألف ترسم صوتا يشبه الضمّة في العربية. بل هي أقرب من حرف "0"اللاّتيني في قولك"do" في اللاّتينية، وفي الفرنسية تجده في كلمة Trop. وتسمّى هذه الحركة في اللغة العبرية "حوليم" ، وترسم نقطة فوق الحرف العبري. هذا، والألف في النصوص البونية الحديثة يمثل أحيانا ضمير الغائب المذكّر المفرد وهو الهاء، متصلا كان أو منفصلا. فكلمة "قلا" في البونية الحديثة تعني "قولهِ".
فاستعمال حروف الحلق لشكل بعض الحروف في الكلمة، أو لرسم ضمير الغائب يطرح إشكالية القائمين على الشأن اللّغوي. فهل وُجد نحاة في المجتمع البوني وفي المجتمع النوميدي المتكنعن، يشرفون على مثل هذه القضايا اللغوية ويستنبطون لها حلولا؟ فمن اقترح العين والحاء لرسم الفتحة، والألف لرسم صوتا شبيها بالضمّة، بل هو أقرب إلى صوت " o " اللاّتيني كما سبق ذكره. والمؤسف أننا لا نعرف شيئا عن المتخصصين في شؤون اللغة البونيّة والقائمين على قوانينها معجما ونحوا وصرفا ورسما.
وبعد هذه الملاحظات اللغوية، نأتي إلى مضامين هذه النصوص المسطورة على الأنصاب الخمسة التي تم عرضها. إنّ صبغتها الدينية لا غبار عليها ولا أدل على ذلك من ذكر "بعل حمون". فالأدعية والنذور موجّهة إليه مشفوعة بالقرابين وممّا لابد من الوقوف عنده قليلا، أن الأدعية والنذور تكون أحيانا جماعية.
كتلك التي تقدّم بها "بعول همكتريم" ، فكأننا مع هيكل من هياكل المجتمع في تلك المدينة النّوميديّة. ولكن لا ندري ماهي الشروط التي ينبغي أن تتوفّر لدى المواطن ليلتحق بفئة البعول: الثروة؟ العلم والمعرفة؟ الحضور الاجتماعي؟ لا ندري. ما هو دور البعول في الحياة السياسية والاجتماعية؟ هل يقتصر دورهم عل القيام بالشعائر الدينية؟
ولمّا كان لقب "بعل" يفيد السيادة والوجاهة، فهم إذن أعيان المدينة وكبار القوم فيها. وما دام قربانهم "لبعل حمون" مؤرّخا بزمن إدارة القاضي فلان، أفلا تضفي هذه التوريخ على الحدث صبغة رسمية مدنية، وبالتالي سياسية؟ وأيّا كان الأمر، فالقضية مازالت تستوجب مزيدا من الدراسة والتحقيق النظامي.
والجدير بالذكر، أن هذا الهيكل أو هذه الهيئة أو الفئة الاجتماعية، لم يتعرض لها المؤرخون الذين تناولوا بالدرس مجتمع "قرطاج" ونظمها وهياكلها السياسية والإدارية. فيبدو أن "البعول" من مميزات المجتمع النوميدي ونظمه. هكذا يبقى ملف "البعول" في المدن النوميدية مفتوحا، مع اعتبار أن أقدم إشارة تخصّهم وردت في إحدى نقائش "دقة"، "فبعول تبجج" أو "تبجّ" أقبلوا على بناء معبد للملك "مسنسن Massinissa" ، في السنة العاشرة من سلطان ابنه "مكوسن Micipsa" أي سنة 138 قبل ميلاد المسيح. فالبحث حول "مؤسسة البعول" يكون إسهاما في التعرّف على مجتمع المدن النوميدية، ونظمها وصلتها بالسلطان أو بالسلطة المركزية.
وفي نصوص هذه الأنصاب عناصر تساعد على معرفة المجتمع النوميدي، لاسيما في المدن الكبرى، فهي تمثّل مصدرًا لمعرفة مدى انتشار الحضارة القرطاجية في صلب ذلك المجتمع. فالمعلمة L’onomastique تبوح بقدرة النوميديين على التطور والتأقلم. فتراهم يمهرون أبنائهم وبناتهم بأسماء بونية، في سلطان الملوك الذين فتحوا أبواب ممالكهم لانتشار الحضارة البونية. كما يتجلّى ذلك في اللّغة الرّسميّة والدينيّة وفي المعلمة. ولمّا كان الغزو الروماني وضمت المملكة النوميدية إلى الممتلكات الرومانية في أفريقة، بعد "معركة تابسوس" سنة 46 قبيل ميلاد المسيح. وأصبحت الغلبة للرومان وللمستفيدين من حضورهم وهيمنتهم، بادر بعض النوميديين بتبني عناصر الحضارة الجديدة، فتعلموا اللغة اللاّتينية، وسمّوا أبنائهم بأسماء لاتينية دون إقصاء الأسماء البونيّة النوميدية إقصاء كاملا. ولئن كانت الأسباب مواتية لتيّار الرّومنة، فلقد بقي المجتمع النوميدي زمنا طويلا محافظا على الإرث البوني النوميدي، لغة ودينا ومعلمة ومصورة مع تفتح على الجديد.
قائمة المصادر والمراجــع:
Benichou-Safar Hélène. (2004). Le tophet de Salammbô. Essai de Reconstitution. Ecole Française de Rome.
Bartoloni, P., (1989). Sulcis. Roma: Libreria dello Stato.
Benichou-Safar, H., A propos du tophet de Carthage : Réflexions sur le sens du terme Mlk, in Actes du IIIè congrés international des études phéniciennes et puniques. Tunis: 11-16 Novembre 1991.
Benz, Frank L., Personal Names, in the Phoenician and Punic Inscriptions (1972). Rome.
Benzina Ben Abdallah, Z., Catalogue des Inscriptions latines païennes du musée du Bardo .(1986). Rome.
Camps, G., Aux origines de la Berbérie, Massinissa ou les débuts de l’histoire .(1960). T. VIII. Libyca: Archéologie et épigraphie. Décret, F. et Fantar, Mh.
Camps, G., (1995). Encyclopédie berbère. vol. XVI. Edisud. Aix-En Provence.
Cintas, P. Le sanctuaire punique de Sousse .la Revue Africaine. n° 410-411. 1er et 2ème trimestre 1947.
Cintas, P., (1970). Manuel d’archéologie punique. Paris.
Decret, F. et Fantar Mh., (1981). L’Afrique du Nord dans l’Antiquité Paris.
Desanges, J., Pline. (1980). L’Ancienne Histoire Naturelle. Livre V. 1ère partie. L’Afrique du Nord. Paris: les Belles Lettres.
Desanges, J., La toponymie de l’Afrique du Nord antique. Bilan des recherches depuis 1965, in l’Afrique dans l’Occident Romain. Ier siècle avant J.C.- IVè siècle ap. J.C., Actes du Colloque organisé par l’Ecole française de Rome, sous le patronage de l’Institut national d’archéologie et d’art, Rome, 3-5 Décembre, 1987. Rome. 1990.
Dictionnaire de l’Antiquité : mythologie, littérature, civilisation . (1993). M.C. Howatson. Paris: Edition Robert Laffont.
Dictionnaire encyclopédique de la Bible. (1960). Paris: Ed. Brepols .
Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique. (1992).Brepols.
Fantar Mh. H., (2002). Le tophet de Salammbô, in L’Afrique du nord antique et médiévale, Mémoire, identité et imaginaire. Textes rassemblées par Claude Briand-Ponsart et Sylvie Crogiez, Rouen.
Fantar Mh., (1990). A "Baal Hammon" dans Reppal Xella, P., Baal Hammon, recherches sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico-punique (1991). Roma.
Fantar Mh, H., (1993). Carthage, Approche d’une civilisation. Vol. 2. Tunis.
Fantar, Mh., (1986). A propos du toponyme Hadrumetum, in Réppal. vol. II.
Fantar, Mh., (1991). Encyclopédie berbère. vol. IX. Edisud.
Février, J. G., (1953). La prononciation punique des noms latins en us et en ius. in Journal Asiatique.
Février, J.G., (1960). Essai de reconstitution du sacrifice Molek. in Journal asiatique.
Ghaki, M., Les inscriptions puniques d’elles, in l’Africa Romana, 14, Sassari, 7-10 décembre 2000.
Gsell, S., Fantar, Mh., (1978). La cite punique de Thapsus, in Actes du IIè Congrès international d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale Alger.
Gsell, S., (1918). Histoire ancienne de l’Afrique du Nord .Vol. III. Paris.
Hours-Miédan, Magdeleine. (1951). Les représentations figurées sur les stèles de Carthage. in Cahiers de Byrsa. vol. I.
Halff, G., (1965). L’onomastique punique de Carthage. in Karthago, vol. XII.
Jeddi, N., (1994). Les dieux, les déesses et les héros. in. Fantar, Mh., Tunis: édition La mosaïque en Tunisie.
Jongeling, K., (2008). Handbook of Neo-Punic Inscription. Tübingen.
Lepelley, C., (1981). Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire. vol. II. Paris.
Ladjimi, L, Balmelle, C., Relbourg, A. L, De Los Llanos, J., Didon et Enée . (1995). La fondation de Carthage, in Carthage, l’histoire, sa trace et son écho Paris: Musée du Petit Palais.
Leglay, M. , (1961). Saturne africain. Monuments. vol. I. sur la stèle n° 12. Paris.
Leglay, M., Saturne Africain, Histoire. Ferjaoui, A., le sanctuaire de Henchir El-Hami, De Baal Hammon au Saturne africain (2007). Ier siècle avant J.C.- IV siècle Après J.C., Tunis.
Lipinski Ed., (1992). Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique. Paris: édition Brepols.
Moscati, S., Gli adoratori di Moloch, Jaca Book, Milano. (1991).
Dictionnaire encyclopédique de la Bible .Paris: édition Brepols.
Picard, G., Le couronnement de Venus , in Mélanges de l’Ecole Française de Rome (1941- 1946). Vol. LVIII.
Picard, G. ch., (1954). Les religions de l’Afrique antique. Paris.
Picard, C.G., (1958). Catalogue du Musée Alaoui. Nouvelle série. Collections puniques. 2 Vol. Tunis.
Picard, Colette. (1976). Les représentations de sacrifice Molk sur les ex-voto de Carthage, in Karthago. Vol. XVII.
Pflaum, H.G. Dir., (1961). Index onomastique des Inscriptions latines d’Afrique, in Karthago, vol. XI.
Salluste, Bell. (1971). Iugurthinum. (Alfred Ernout traducteur). Paris: Les Belles-Lettres.
Sznycer, M., (2002-2004). Les Inscriptions néopuniques d’Ululas. Tunisie.
Zeghal-Yazidi, Samia. (2009). Le bestiaire dans l’imaginaire des puniques. Tunis.
24 Ciasca, A., Mozia, S.V. tofet, Roma, 1989, P. 44-47.
25 Bartoloni, P., Sulcis, Roma, Libreria dello Stato, 1989 : pour le tophet, voir P. 51-56.
26 Picard, G. Ch., Les religions de l’Afrique antique (1954). Paris. P. 118-125. Leglay, M., Saturne Africain, Histoire. P. 412 où nous lisons "Historiquement Baal Hammon meurt en 146 avant J.C., théologiquement, il survit dans Saturne. Ferjaoui, A., le sanctuaire de Henchir El-Hami, De Baal Hammon au Saturne africain (2007). Ier siècle avant J.C.- IV siècle Après J.C., Tunis.
27 Picard, C.G., Catalogue du Musée Alaoui, Nouvelle série, Collections puniques, 2 Vol, Tunis, 1958. P. 273 – 292. Il s’agit d’environ 85 stèles ou fragments des stèles.
28 Jongeling, K., Handbook of Neo-Punic Inscription (2008). Tübingen.
29 Cette particule est ainsi écrite dans d’autres inscriptions néopuniques à Maktar et ailleurs.
30 Fantar, Mh., A propos du toponyme Hadrumetum (1986). In Réppal II. P. 267-275.
دراسة تحليلية للقيم المتضمنة لكتاب مبحث
التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي
أ.د. عبد الفتاح عبد الغني الهمص الجامعـــــــة الإسلاميـــة – غـــــــــــزة
أ.د. زيــــــاد علــــــي الجرجـــــاوي جامعة القدس المفتوحة
أ. ولاء عبد الفتاح الهمص الجامعة الإسلامية - غزة
ملخص الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف على القيم المتضمنة لكتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي، الجزء الثاني، وقد استخدم الباحثون في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي، وقد أسفرت الدراسة عن نتائج كان أهمها: وجود قيماً تربوية لكنها غير كافية فكانت محدودة ويفضل أن يتناول الكتاب قيماً تربوية أكثر ممّا ذكر، بينما هناك قيماً نفسية حول هذا الجزء وضعت بعناية، لكن لابد من محاكاة نفسية الإنسان المراهق لقضايا أخرى تفيد الطالب في حياته اليومية، أمّا القيم الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لطلبة الصف التاسع الأساسي وما قدّم للطالب في الكتاب المقرر فهو يفي بالغرض. كما أوصت الدراسة بتوصيات أهمها: ضرورة التوازن في طرح القيم لطلبة الصف التاسع الأساسي في مبحث التربية الإسلامية، وكذلك توضيح مراد الشارع في القيم المطروحة وخاصةً عند ذكر الآيات، كما يفضل زيادة القيم والتي يحتاجها الطالب في مرحلة المراهقة.
الكلمات المفتاحية: القيم - كتاب مبحث التربية الإسلامية - الصف التاسع الأساسي.
مقدمة: تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً في المناهج التعليمية وتضع لمناهجها خبراء في الميدان ومشاركين آخرين وموجهين ومعلمين وأولياء أمور وطلبة لتخرج المناهج بعامة مناهج تتوافق مع السياسة الفلسطينية والفلسفة التربوية والأهداف التعليمية المنشودة، وتهتم خاصةً بمبحث التربية الإسلامية اهتماماً كبيراً وتضع له المشرفين أو الموجهين الذين يزورون المدارس بصفة مستمرة، ليطمئنوا على تطبيق تدريس المقررات تدريساً سليماً وذلك من خلال مكاتب الإشراف الموجودة في المديريات المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم، كل ذلك من أجل توصيل القيم الإسلامية لطلبتنا بشفافية وموضوعية وسلامة من الأفكار والعقائد المنحرفة وذلك من أجل تهذيب عقلية الإنسان الفلسطيني وصولاً إلى إنسان مسلم يقوم بكافة الأعباء التي تناط به حينما يتخرج من المدرسة إلى المجتمع حاملاً معه القيم الأخلاقية والدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية والنفسية ليتعامل مع بني البشر معاملة سليمة بعيدة عن الشذوذ والفكر غير المتوافق، فمن مبحث التربية الإسلامية يحاول بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة للطلبة في مراحلها المتنوعة وكذا ترسيخ العقيدة المحمدية والقيم الإسلامية، وتوجيههم وإرشادهم إلى حياة واقعية بعيداً عن التطرف الفكري الذي نشهده في المجتمعات.
وقد حاولت وزارة التربية والتعليم في وضع تسعة عشر درساً موزعة على ستة وحدات متنوعة لتغطي أغلب القيم المنشودة لتدريس طالب هذه المرحلة، وقد حاول الباحثون في تحليل محتوى هذا الكتاب المقرر على الصف التاسع الأساسي وذلك من أجل وضع لبعض التوصيات أمام المسؤولين سواء كانت إيجابية أو غيرها من أجل الرقي بمناهجنا والإفادة لطلبتنا وأولياء أمورنا.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: تسعى الدول المتقدمة في غرس القيم في نفوس طلبة المدارس الأساسية، ذلك من أجل ترسيخ المفاهيم والمعلومات القيّمة في نفوس الناشئة؛ وذلك لأن الطلبة في هذه المرحلة يمكن تنشئتهم على الفضائل النبيلة التي يرتئيها لهم دينهم، وعادات وتقاليد مجتمعاتهم، وذلك من أجل التماسك للنسيج الاجتماعي وعمليات الضبط للقيم والمفاهيم المستقاة من تعاليم دينهم الحنيف، ولمّا كانت فلسطين من الدول الفتيّة التي اعتمدت على سواعد خبرائها وعلمائها في وضع المناهج لأبنائها بدلاً من استيرادها من دول أخرى، وفي ذلك خير كثير، لذلك كانت المقررات التي تقدم لطلابنا هي حصيلة الجهد الذي قدمه المختصين في هذا المجال.
وبناءً على ما تقدّم ذكره فإن الباحثين وهم من العاملين في حقل التربية والتعليم ارتأوا القيام بهذه الدراسة والتي تنحصر في التساؤل الرئيس التالي:
ما القيم المتضمنة لكتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
س1: ما القيم التربوية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
س2: ما القيم النفسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
س3: ما القيم الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
س4: ما القيم الثقافية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
س5: ما القيم السياسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
أهداف الدراسة-تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي:
- الكشف عن القيم التربوية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.
- بيان القيم النفسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.
- معرفة القيم الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.
- إبراز القيم الثقافية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.
- الكشف عن القيم السياسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.
أهمية الدراسة: تكتسب الدراسة أهميتها من خلال:
- تكمن أهمية الدراسة في كونها الأولى من نوعها والتي تناول فيها الباحثين مبحث التربية الإسلامية للصف التاسع الأساسي وذلك حسب – علم الباحثين واطلاعهم-.
- يعد موضوع القيم من المواضيع المهمة في تدريسها في مرحلة المراهقة ولمّا كان طلبة الصف التاسع من مرحلة المراهقين؛ فإن هذه الدراسة تأتي في وقتها المناسب للطلبة في هذه المرحلة.
- تعد هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات؛ خاصةً في مجال القيم.
- قد يستفيد من هذه الدراسة المعلمين، والمشرفين التربويين، وأولياء أمور الطلبة في تنظيم القيم قد يستفيد من هذه الدراسة المعلمين، والمشرفين التربويين، وأولياء أمور الطلبة في تنظيم القيم اللازم تدريسها في هذه المرحلة.
حدود الدراسة: تتحدد هذه الدراسة من الحدود الآتية:
الحد الموضوعي: تتحدد هذه الدراسة بموضوعها دراسة تحليلية للقيم المتضمنة لكتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي، وقد اعتمد الباحثون الجزء الثاني من مبحث التربية الإسلامية المقرر للصف التاسع الأساسي.
الحد الزماني: فهي تنحصر بحدود وقت إجراء هذه الدراسة الفصل الدراسي الأول 2018/ 2019.
مصطلحات الدراسة: يعرض الباحثون لتعريفات لأهم المصطلحات التي وردت في دراستهم إجرائياً على النحو الآتي:
القيم: ويعرفها الباحثون بأنها: محددات للسلوك الإنساني والذي له قيمة علمية تعلمية.
كتاب مبحث التربية الإسلامية: ويعرفه الباحثون بأنه أحد المباحث التي تدرسها وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف التاسع الأساسي والمحصور في كتاب التربية الإسلامية.
الصف التاسع الأساسي: ويعرفه الباحثون بأنه مجموع الطلبة المسجلين الذين وصلوا إلى الصف التاسع وفقاً للمعايير التي تضعها وزارة التربية والتعليم لمثل هذا الصف.
دراسات سابقة: من خلال الاطلاع على الأدب التربوي، استطاع الباحثون أن يستعرضوا بعضاً من الدراسات السابقة التي عالجت مشكلات قريبة من مشكلة دراستهم وهي على النحو الآتي:
- دراسة إيهاب عبد المعطي الأغا (2010) بعنوان: " القيم المتضمنة في منهاج المطالعة والنصوص للصف التاسع في محافظات غزة دراسة تحليلية"
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع في محافظات غزة بجزأيه، وما يجب أن يشتمل عليه من قيم من وجهة نظر خبراء المناهج وتحديد القيم التي تحتاج إلى إثراء واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم أداة تحليل المحتوى للوقوف على هذه القيم، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن الكتاب قد اشتمل على مجموعة كبيرة من القيم، في المجال العقائدي، والمجال التعبدي، والمجال الأخلاقي، والمجال الاجتماعي، والمجال السياسي، والمجال الاقتصادي، والمجال العلمي، والمجال البيئي، والمجال الجمالي، وقد حصل المجال العلمي على أعلى نسبة مئوية، وكان ترتيبه الأول من بين المجالات التسعة، تلاه المجال الأخلاقي، ثم الاجتماعي، ثم العقائدي، ثم السياسي، ثم الاقتصادي، كما أشارت النتائج على وجود خلل في توزيع القيم داخل المجال الواحد، فقد اتضح من خلال المقارنة بين النسب أن هناك تفاوتاً في توزيع القيم داخل كل المجالات باستثناء المجال الأخلاقي حيث أشارت النسب إلى وجود اعتدالية في التوزيع داخل فقرات المجال.
- دراسة شريف علي حمّاد (2011) بعنوان: " جودة محتوى كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية العليا بفلسطين في ضوء معايير جودة المحتوى وتنظيمه"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى توافر معايير جودة تنظيم المحتوى ومعايير جودة المحتوى في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية العليا "السابع والثامن والتاسع "بفلسطين ،ولتحقيق ذلك قام الباحث ببناء أداة البحث "الاستبانة" ، وطبق الأداة على عينة قوامها 43 معلماً ومعلمة ممن يدرسون الصفوف والكتب محل البحث بمدارس محافظة خان يونس، مستخدما المنهج الوصفي، وقد توصل البحث إلى أن مجال المحتوى حصل على أعلى متوسط في الصف السابع يليه مجال إخراج الكتاب للصف الثامن ،في حين أن تنظيم المحتوى حصل على نسب متوسطة في بعض المعايير وضعيف في البعض الآخر أما باقي المجالات فقد حصلت على متوسطات عالية ومتوسطة وضعيفة، مما يدلل على أن الكتب الثلاثة كانت متوسطة الجودة في التنظيم والمحتوى .
- دراسة سمية سلمان العجرمي (2012) بعنوان: " دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي بفلسطين"
هدفت الدراسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية وكتب التربية الاجتماعية (التربية الوطنية والتربية المدنية) وكتب حقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي بفلسطين، كما هدفت إلى معرفة مدى ملائمة القيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان لتلاميذ الصف الرابع الأساسي بفلسطين واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي، بأسلوبه تحليل المحتوى ، وتكونت عينة الدراسة من كتب مبحث التربية الإسلامية ومبحث التربية الاجتماعية والتي تضم كتب) التربية الوطنية والتربية المدنية (، ومن كتب مبحث حقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي، واستخدم الباحث في دراسته أداتين ، قائمة اشتملت أهم أبعاد القيم ، والقيم الفرعية المندرجة تحتها، و أداة تحليل المحتوى ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :تبين من خلال تحليل كتب التربية الإسلامية أن " القيم الدينية " قد احتلت المرتبة الأولى، ويليها "القيم الاجتماعية " ، ويليها "القيم الجمالية " ، ويليها "القيم السياسية والوطنية ، ويليها في المرتبة الأخيرة "القيم العلمية " .
- دراسة نجاة نوري نصير (2013) بعنوان: " القيم الإسلامية وأثرها في تعديل سلوك التلاميذ من وجهة نظر المعلمين " دراسة مقرر التربية الإسلامية للصف التاسع بمدينة طرابلس – ليبيا – نموذجاً"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تضمين مقرر التربية الإسلامية للصف التاسع على مجموعة من القيم الإسلامية، كما هدف البحث إلى التعرف على مدى تحقيق القيم الإسلامية الموجودة داخل مقرر التربية الإسلامية للأهداف المنشودة، وكذلك التعرف على معرفة الفروق ذات دلالة إحصائية تعزى للجنس في إجابات إفراد العينة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت استبانة من إعدادها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن مقرر التربية الإسلامية المقرر على تلاميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي يتضمن العديد من القيم الإسلامية ، كما إن التربية الإسلامية عملية قيمة تسعى إلى تحقيق القيم الإسلامية الموجودة داخل المقرر للأهداف المنشودة، بينما بينت عدم وجود فروق جوهرية في آراء أفراد عينة البحث حول محاور الاستبانة وفقاً لمتغير الجنس.
- دراسة شاهر أبو شريخ، وعمر بني مصطفى (2014) بعنوان:" القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشرعية في كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن"
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى مراعاة محتوى كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن للقيم التربوية في ضوء الإطار العام للمناهج والكتب المدرسية باستخدام وحدة التحليل (الآية، الحديث) وتكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المتضمنة في كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في ضوء الإطار العام للمناهج والكتب المدرسية، وقد بلغت (43) قيمة، موزعة على أربعة مجالات، وأن أكثر القيم التربوية تكراراً في المرحلة الثانوية جاءت ضمن مجال القيم "الإيمانية والعقدية" بتكرار (471) وبنسبة (14%) من مجموع القيم في المرحلة الثانوية.
- دراسة بكر المواجدة، ومحمد الزبون، ورضا المواضية (2015) بعنوان: " مفاهيم التربية السياسية في الإسلام ومدى تضمينها كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية في الأردن"
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مفاهيم التربية السياسية في الإسلام ومدى تضمينها في كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية في الأردن، واستخدم الباحثون في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة مجتمع البحث من كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية. وقام الباحثون بتصميم استبانة لهذا الغرض اشتملت على ( 72 ) مفهوماً للتربية السياسية في الإسلام، وقد أظهرت النتائج توافر بعض المفاهيم السياسية بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة ومفاهيم لم يرد ذكرها نهائياً في تلك الكتب.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد الاطلاع على الدراسات السابقة تبين أن جميع الدراسات السابقة تناولت القيم من خلال مقررات أخرى، إلاّ دراسة ( نصير، 2013) والتي تناولت بعض القضايا التي تخص مقرر التربية الإسلامية في ليبيا لمدينة طرابلس، وبذلك افترقت الدراسة الحالية عنها في أنها تناولت مبحث التربية الإسلامية في فلسطين، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها موضوع التربية الإسلامية ، وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تناولت شريحة من المراهقين في فلسطين.
الطريقة والإجراءات
مقدمة:
نتعــرض إلى الإجــراءات والخطـوات المنهجيــة التي تمت في مجـال الدراسة الميدانية، حيث يتناول منهـج الدراسـة، ومجتمـع الدراســة، والعينـة التي طبقت عليهـا الدراسـة، إضـافـةً إلى توضيـح الأدوات المستخدمـة في الدراسـة وخطواتهـا، والأساليب الإحصائيـة التي استخدمت في تحليـل البيانـات للتوصـل إلى النتائج ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة، وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم:
منهــج الدراســـة: اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول الإجابة على السؤال الأساسي في العلم وماهيـة وطبيعة الظاهرة موضوع البحث، ويشمل ذلك تحليل الظاهرة، وبيئتها، وبيان العلاقة بين مكوناتها، ومعنى ذلك أن الوصف يتم أساساً بالوحدات أو الشروط أو العلاقـات أو الفئـات أو التصنيفات أو الأنساق التي توجد بالفعـل، وقد يشمل ذلك الآراء حولها والاتجاهات إزائها، وكذلك العمليات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها، ومعنى ذلك أن المنهج الوصفي يمتد إلى تناول كيف تعمل الظاهرة (الأغا، والأستاذ،2003، 21).
نتائـج تحليل فقرات الدراسة وتفسيرهـا
النتائج المتعلقة على السؤال الأول: ما القيم التربوية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
تبين من خلال اطلاع الباحثين في مبحث التربية الإسلامية من الجزء الثاني قيماً تربوية لكنها غير كافية فكانت محدودة ويفضل أن يتناول الكتاب قيماً تربوية أكثر ممّا ذكر، وفي السطور الآتية تتضح الحاجة إلى زيادة القيم التربوية التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة من حياته التعليمية.
ففي الوحدة الأولي والتي تضمنت قيماً تربوية في التدبر والتفكر وأخذ العظة من خلال ضرب الأمثال وقد تشكلت هذه الأمثال من خلال قوله تعالى :) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ( ( الحشر، الآية: 21)، وقوله: )وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ( ( العنكبوت، الآية: 43).
وقد وضح ذلك في أنواع ضرب الأمثلة كما وردت في الكتاب العزيز وذلك من خلال عرض
الغائب في معرض الحاضر المشاهد، قال تعالى: )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ( ( البقرة، الآية: 275) .
والترغيب في العمل والحث عليه وغير ذلك من الأمثلة فكان موضوع ضرب التمثيل موضوعاً تربوياً يحاكي طبيعة المرحلة التي يمر بها طلبة الصف التاسع الأساسي، وتحدثت هذه الوحدة في الدرس الثاني منها عن فتن الدين ( فتنة المال والولد ، فتنة العلم ، فتنة السلطان والملك )، قال تعالى: ) مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( ( البقرة، الآية: 261).
وقد وضّح ذلك في قصص تربوية عرضت بطريقة مسلية تتناغم مع مرحلة النمو في هذه المرحلة وقد ظهر من خلال التحليلات نموذجين واضحين: النموذج الأول، وتمثّل في: رجل أتاه الله المال وتعددت أصناف هذا المال ( الجنتان ، الأعناب ، الشجر .... إلخ )
والنموذج الثاني : ذلك الرجل الفقير المؤمن الذي عرف حقيقة الدنيا ولم يخدع بها وبزخرفتها .
من خلال العرض السابق يتبين أن هذا الجزء احتوى على مجموعة من القيم التربوية المفيدة لهذه المرحلة ولكنها غير كافية؛ ممّا يتطلب زيادة الأمثلة للقيم اللازمة لهذه المرحلة وخاصةً أن الطلبة في مرحلة المراهقة وهي مرحلة حرجة للمربين وأولياء الأمور.
النتائج المتعلقة على السؤال الثاني: ما القيم النفسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
ويمكن من خلال مراجعة ما كتب في الوحدة تبين أن هناك مجموعة من القيم النفسية مثل الإيمان بالعمل الصالح فهو مقياس التفضيل عند الله، والمؤمن يقدم النصيحة للآخرين ابتغاءً لوجه الله سبحانه وقد حذرت آيات وأحاديث الوحدة الأولي من الكبر والغرور والعجب وهذه جميعها تؤدي إلى الشرك والكفر بالله.
أما الدرس الثاني فقد ركز على القيم الدينية حيث دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الديان والدعوة إلى الاعتصام بدين الله تعالي وذلك من خلال ما ورد عن مريم في عبارتها لله عز وجل وبعرض أحداث غزوة أحد وقدرة الله على الخلق وهذا تبدّى من خلال الآيات التي دلت على معجزة ولادة عيسى عليه السلام وتأييده من الله عز وجل في حديثه وهو في المهد
وهذه الوحدة تناولت بعض القيم الدينية في الدرس السادس منها الحرص على الالتزام بطاعة الله والتمسك بالثقافة الإسلامية وحرص انتقاء الأصدقاء .
هذه القيم النفسية الواردة حول هذا الجزء وضعت بعناية، لكن لابد من محاكاة نفسية الإنسان المراهق لقضايا أخرى تفيد الطالب في حياته اليومية، وما ورد في هذا الجزء يحتاج إلى زيادة في التفصيل والبيان، خاصةً وأن القيم النفسية يحتاجها الطالب كثيراً لتواصله مع مدرسيه وزملائه وأولياء أمره، لذلك يجب أن تكون هذه القيم في سلّم القيم النفسية المقدمة للطالب، وهذا الأمر أصبح مهماً جداً؛ لأنه يطرق السلوكيات في المجتمع الفلسطيني فلذلك يرى الباحثون أنه لابد من زيادة القيم النفسية لطلبة الصف التاسع الأساسي والموجود جيد ولكنه غير كاف.
النتائج المتعلقة على السؤال الثالث: ما القيم الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
أما في الدرس الخامس فقد ركزت على القيم الاجتماعية فتناولت موضوع التكليف والمسئولية وهذا ما يسعى إليه اليوم العلماء في الدول المتقدمة كما أن هذه الوحدة بينت طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وطبيعة المساواة بينهما وقد تحدثت عن المسئولية الاجتماعية والمسئولية الشخصية فكان ذلك أن الإنسان مسئول عن نفسه وجوارحه وعلمه وعبادته وعمله ... إلخ.
أما الاجتماعية فتشمل رئاسة الدولة والمسئولية عن الأسرة والآباء والأمهات وركزت في الدرس السادس على التقليد الأعمى وهذا الأمر موضوعاً اجتماعياً بامتياز حيث تناولت أنواع التقليد المحمود والمذموم في الاعتقاد والسلوك ثم انتقلت إلى دوافع التقليد ومن دوافع هذا التقليد الجهل في الدين وضعف الشخصية كما تضمنت هذه الوحدة الحث عن دوافع التفكير وهو الجهل في الدين وضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس والانبهار في الثقافات الأخرى والانغماس فيها .
وفي الدرس الحادي عشر فقد بيّن الكتاب جوانب السلام حيث ركّز على صلح الحديبية وأهمية الصلح والسلم في الإسلام، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة، الآيتان: 159-160). وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (البقرة، الآية: 208)، وثال تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران، الآيات: 86-89)، وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: الآية:1).
ومن ذلك يستفاد في العفو عند المقدرة والخشوع لله والشكر على نعمة الانتصار.
أما في الدرس الثامن (الحلال والحرام) فقد ركز هذا الدرس على الحلال والحرام، فالحلال كما ورد في الحديث فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - :قال :-- سمعتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيهِ : «إنّ الحلال بيِّن ، وإن الحرام بيِّن، وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات ، استبرأ لدينه وعِرْضهِ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يَوشك أن يرتَعَ فيه ، ألا ولكِّ ملك حمى ، إلا وإنّ حمى الله محارمُه ، ألا وإنَّ في الجسد مضغة ، إذا صلَحتْ صلَحَ الجسدُ كلُّه ، وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كلُّه ، ألا وَهِي القلبُ" ( البخاري، د.ت: رقم الحديث 1946).
فالحلال لا يحتاج إلى اجتهاد كمعرفة الزواج والبيع والشراء...إلخ أمّا الحرام فقد وردت فيه نصوص بتحريمه كالقتل والسرقة والزنا ...إلخ، أمّا أمور المتشابهات مثل الغناء وأقل الحلال في الأمور الغنائية.
بينما في الوحدة الرابعة الدرس العاشر، ندب الإسلام الجهاد في سبيله والغزو لتكون كلمة الله هي العليا، فعن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض" ( البخاري، ب.ت: رقم الحديث 4659).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى" ( مسلم، د.ت: رقم الحديث: 3497).
بينما في الدرس الثاني عشر، ففيه تحدث عن الانتماء لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن والإسلام، والولاء لله عز وجل ونبذ الكفر وبيان الإخلاص الحميدة المستنبطة من الولاء والبراء والانتماء منها الإيثار والتواضع والبر وسعة الصدر والشجاعة والجرأة وغيرها من مكارم الأخلاق.
أمّا الوحدة الخامسة في الدرس الرابع عشر: حيث ركّزت على درس مهم بين المعاملات بين الناس ألا وهو الوديعة قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا( (النساء، الآية: 58).
وهذا ما ينقص مجتمعنا اليوم حيث الأمانة بين أبناء المجتمع الواحد على حفظ الأموال وتأمينها وإرجاعها إلى أهلها متى طلبها، وهذا الأمر يعين على وضع الأموال في الأماكن السليمة التي تسترد حينما يرجع صاحبها من السفر أو أن يشفى إن كان مريضاً فتعاد إلى صاحبها للاستفادة منها، وهذا حرز للمسلمين، بدلاً من المعاملات الربوية، كما ركزت هذه الوحدة على جانب من جوانب المعاملات منها قول الله تعالى:) وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ( (البقرة، الآية: 283).
وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاع من الشعير والرهن هذا في يد المرتهن، فلا يجوز التصرف به سواء ببيع أو هبة، فما أحوجنا إليه اليوم، ومن فوائده التخلص من القيود الربوية التي يذهب إليها المسلمون لاستجلابها من البنوك الربوية فهو عرض دون منفعة فقد قيل: كل قرض جرّ نفعا فهو ربا، وقد قيل أن هذا حديث نبوي، وبعد التحقق من قبل الباحثين واستفسارهما من أهل التخصص، فهو ليس بحديث لكن يؤخذ به لأن كلامه علمي منطقي.
أما في الدرس السادس عشر فقد ذكر أن المال الذي يعطيه المقرض إلى المقترض لينتفع به ثم يرده دون زيادة مشروطة فهذا يساعد على التعاون بين الناس وفعل الخيرات وتيسير أمور الناس وهذا طبعاً يساعد المسلمين عن الابتعاد عن القروض الربوية من البنوك سواء كانت إسلامية في مسماها أو غير إسلامية، فعن عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظاً، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل" ( الطبراني، 2008: رقم الحديث: 88).
وقد قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( (البقرة، الآية: 280).
من خلال الاطلاع على وحدات الجزء الثاني فإنه قد استوفى جميع القيم الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لطلبة الصف التاسع الأساسي وما قدّم للطالب فهو يفي بالغرض.
النتائج المتعلقة على السؤال الرابع: ما القيم الثقافية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
ومن خلال معجزة عيسى عليه السلام وضح لنا تأييد المولى عز وجل له بتشكيل الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصبح طيراً بإذن الله وكان عليه السلام يمسح على أعين الأعمى والأبرص فيبرئان بإذن الله، وهذه الثقافة الطبية وغيرها كإحياء الموتى بإذن الله وإخبار الناس بما يأكلون ويدخرون من أصناف الطعام قال تعالى: )إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ( (آل عمران، الآيات: 45 – 48).
أما في الوحدة الثالثة، الدرس السابع: فقد ظهر من خلال دراسة الباحثين للكتاب أن هناك اهتمام للحفظ والضبط والتثبيت كما واهتمت هذه الوحدة بالتصنيف والتأليف حيث أظهرت للطلبة تصنيف الكتب إلى أبواب الصحيحين وكتب السند، وكذلك بينت الوحدة أن بعض العلماء صنف كتبه وفقاً لأسماء الصحابة كالمسانيد وكذلك هناك تصنيف يظهر من خلال أسماء الشيوخ والمعاجم فهذه الوحدة كانت مخصصة لبيان كيفية استخدام علمائنا الأوائل لمناهج البحث العلمي الخاصة التي لم يسبقهم بها أحد، فبينت منهجية مصادرنا الإسلامية وكتبنا ومعاجمنا فلكل عالم منهجه الخاص في تأليف كتبه، فهذه القيم العلمية والثقافية التي لم يسبق أسلافنا الأوائل أحد في ذلك فعلى سبيل المثال لا الحصر موطئ الإمام مالك فقد اجتهد في تصنيفه، فصنفت أحاديثه وفقاً لاجتهاده الخاص وفتواه، وهي عبارة عن جملة أحاديث مرفوعة وأثار موقوفة، أمّا مسند الإمام أحمد بن حنبل حيث جمع أحاديث كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدى فرتبه وكان يتحرّى السند وهكذا لكل علمائنا فكل له طريقته ويطول الحديث فيها.
أمّا الدرس التاسع، فقد اهتم هذا الدرس بالبيئة حيث اهتم المسلمون الأوائل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالنظافة والنظام والزراعة والإضاءة ...إلخ وغيرها من الأمور الأخرى، ففي النظافة: الوضوء في الفروض الخمسة وغسل الجمعة، فعَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم (ابن ماجة، د.ت: رقم الحديث: 98).
أمرنا الحبيب مُحمد صلي الله عليه و سلم بإطفاء المصابيح بالليل, و بعد سنوات عديدة من البحث العلمي حول تأثير الضوء علي الإنسان و البيئة, قال العلم صدق رسول الإسلام, فإظلام المصابيح إعجاز نبوي يقي الإنسان و بيئته من التلوث الضوئي الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء في الليل، كما حذرنا الحبيب صلي الله عليه و سلم من خطر المصابيح إذا تركناها موقدة عند النوم و ذلك في عدد كبير من الروايات, منها ما ذكر علة التحذير و هي الخوف من الاحتراق بنارها, و منها ما جاء بدون ذكر لعلة الأمر بإطفاء المصابيح لتعم النصيحة و الرحمة النبوية كل المخلوقات في كل زمان و مكان، فعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لا تَتْركوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُون") البخاري، د.ت: رقم الحديث: 3935).
وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُم)"البخاري، د.ت: رقم الحديث: 6294).
أمّا في الزراعة: فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمٍ يغرسُ غرساً أو يَزْرَعُ زَرْعاً فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به صدقة" (البخاري، د.ت: رقم الحديث: 2320).
عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، قال: "أرض المحشر، والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره"، قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: "فتهدي له زيتًا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه" (ابن ماجة، د.ت: رقم الحديث: 429/1-430).
تبين لدى الباحثين أن هناك قيماً ثقافية مفيدة لطلبة الصف التاسع الأساسي، وقد تناول الكتاب مجموعة من القيم الثقافية المتنوعة التي لها فائدتها في حياة الإنسان الفلسطيني من خلال تمسكه بدينه ليعرف الجوانب الثقافية التي وضعها الإسلام لأتباعه وما توفر في الجزء الثاني من الكتاب من قيم ثقافية لهو أرقى ممّا كتبه علماء الغرب الذين يوهموننا أنهم من أصحاب الثقافة والحضارة، وديننا الحنيف فيه الكثير من القيم الثقافية التي تصقل شخصية الإنسان وتجعله يتناول هذه القيم باعتزاز وافتخار.
النتائج المتعلقة على السؤال الخامس: ما القيم السياسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟
ففي الدرس الثالث عشر ركّز على قيم الشجاعة والإقدام المتمثلة في شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد المحنك ومنها يستلهم السمع والطاعة والاقتداء بسلفنا الصالح وبيان بذل الجهد الذي أقدم الصحابة في سبيل الله وجعل الجهاد في سبيله ذروة سنامه، وعدم الاعتراض على القرارات المصيرية كوضع الرجل المناسب في المكان المناسب امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيف الله المسلول استله الله على رقاب أعدائه.
كما جاء في الوحدة السادسة، الدرس السابع عشر، مجموعة من الحقوق التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان بغض النظر عن أنواعها، فقد تحدثت هذه الوحدة في الحق عن الحياة، وكرامة الإنسان والحرية والموازنة بين الحقوق والواجبات، وقد اشترط الإسلام لممارسة هذه الحقوق ضوابط دون أن تلحق أضراراً بالممتلكات.
بينما في الدرس التاسع عشر فقد تحدثت هذه الوحدة عن عزة الإسلام والشموخ والشجاعة والقوة والرحمة والمودة، كقوله تعالى:
) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ( (الفتح، الآية: 29).
اتضح من العرض السابق أن الجزء الثاني من كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر لطلبة الصف التاسع الأساسي تضمن مجموعة من القيم السياسية والتي لها عظيم الأثر على الشخصية الإسلامية بصفة عامة، وعلى الشخصية الفلسطينية بصفة خاصة، فها هم مؤلفو الكتاب وضعوا لطلبتنا أمثلة للإقدام والشجاعة، ونحن بحاجة إليها اليوم كثيراً، خاصةً ونحن نجابه ثيراً، خاصةً ونحن نجابه أعتى دولة أعتى دولة ذات جبروت لا تقيم للإنسانية وزناً، وقد تمثلت هذه في شجاعة أبنائنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمؤامرات التي تحاك ضدنا، فلذلك كانت لهذه الوحدة في مكانها السليم ولا تحتاج إلى زيادة، ولكنها تحتاج إلى بعض الأمور والاستراتيجيات والتي تبسط توصيل هذه القيم إلى أبنائنا.
التوصيات
انطلاقا ممّا خلصت إليه الدراسة من نتائج، أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات يلخصها الباحثون فيما يلي:
- ضرورة التوازن في طرح القيم لطلبة الصف التاسع الأساسي في مبحث التربية الإسلامية.
- توضيح مراد الشارع في القيم المطروحة وخاصةً عند ذكر الآيات.
- يفضل زيادة القيم والتي يحتاجها الطالب في مرحلة المراهقة.
- ضرورة عقد مؤتمرات وورش عمل لموضوع القيم وذلك لزيادة الأبحاث والنتائج المنبثقة عنها والتي تساعدنا في وضع القيم المناسبة لكل مرحلة من مراحل التعليم وفقاً لمراحل النمو.
- ضرورة التركيز على متطلبات مرحلة النمو التي يمر بها طلبة مرحلة الصف التاسع الأساسي ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنمية القيم في هذه المرحلة وفقاً لتطور ونمو الطالب.
- ضرورة التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمدارس والجامعات وكليات التربية في الجامعات الفلسطينية في إعادة دراسة منظومة القيم خاصةً في مرحلة المراهقة التي يمر بها الطلبة.
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم ) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (
-
الأغا، إيهاب عبد المعطي (2010): القيم المتضمنة في منهاج المطالعة والنصوص للصف التاسع في محافظات غزة دراسة تحليلية، كلية التربية، رسالة ماجستير، قسم المناهج وطرق التدريس، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
-
الأغا، إحسان، والأستاذ، محمود (2003): مقدمة في تصميم البحث التربوي، ط3، مطبعة الرنتيسي، غزة، فلسطين.
-
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (د.ت): صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
-
حمّاد، شريف علي (2011): جودة محتوى كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية العليا بفلسطين في ضوء معايير جودة المحتوى وتنظيمه، المؤتمر الوطني للتقويم التربوي، رام الله، فلسطين.
-
أبو شريخ، شاهر، وبني مصطفى، عمر (2014): القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشرعية في كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد 15، العدد 3، البحرين.
-
الطبراني، سليمان بن أحمد أبو القاسم (2008): معجم الطبراني الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.
-
العجرمي، سمية سلمان (2012): دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي بفلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين.
-
ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (د.ت): سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
-
مسلم، الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري (د.ت): صحيح مسلم، مؤسسة البلاغ، بيروت، لبنان.
-
المواجدة، بكر، والزبون، محمد، والمواضية، رضا (2015): مفاهيم التربية السياسية في الإسلام ومدى تضمينها كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية في الأردن، مجلة دراسات العلوم التربوية، المجلد 42، العدد 3، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص ص 947 - 961
-
نصير، نجاة نوري (2013): القيم الإسلامية وأثرها في تعديل سلوك التلاميذ من وجهة نظر المعلمين " دراسة مقرر التربية الإسلامية للصف التاسع بمدينة طرابلس – ليبيا – نموذجاً"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اللغات الرئيسة، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، نيلأي، ماليزيا.
واقع ومكانة المرأة في الحضارات القديمة والمغرب القديم
الدكتورة: مالية بصال المركز الجامعي مرسلي عبد الله -تيبازة
الأستاذ: أحمد سايح مرزوق خميس مليانة
الملخص:
تعد المرأة أهم مكون لكيان المجتمعات، وقد شغلت عبر العصور أدوار هامة بل وكانت فاعلة ونشيطة في التأثير في مختلف جوانب ومناحي الحياة، فضلا عن تسيير الحركية السياسية كما أنها تحملت أعباء تفوق قدراتها وإمكانياتها، ونحاول في هذه الورقة البحثية تقصي مكانة المرأة في مختلف الحضارات القديمة من فرعونية وصينية واغريقية ومغاربية، وصولا الى الفترة الإسلامية التي أعطت المرأة حقها الفعلي والمشروع.
مقدمة:
على مر العصور وتعاقب الأمم والحضارات، كانت المرأة ممسوخة الهوية فاقدة الأهلية منزوعة الحرية، لا قيمة لها تذكر، أو شأن يعتبر، بل كانت تقاسي في عامة أحوالها باستثناء عصور الرسالات السماوية، ألونا من الظلم والشقاء والذل، صاغتها أهواء ضالة أو عقائد فاسدة. ولقد اختلفت معاملة الشعوب للمرأة وتباينت نظرتهم إليها، لذلك جاءت الدراسة لتبين الأوضاع السيئة التي عاشتها المرأة في المجتمعات القديمة قبل ظهور الإسلام، لبيان مدى تكريم الإسلام بها، وما قدمه لإعلاء مكانتها الاجتماعية، حيث أعطاها كل حقوقها، والتي تتفق مع فطرتها ومع رسالتها في الحياة الإنسانية.
لا شك أن المرأة شطر النفس الإنسانية وأنها صانعه الجنس البشرى، ولكن هل كانت نظرة الرجل للمرأة على هذا النحو على مر العصور في مختلف الحضارات البشرية التي سبقت الإسلام؟
I/ نظرة مختلف الحضارات حول المرأة :
1/ مكانة المرأة في بلاد الرافدين: رغم أن المرأة في بلاد الرافدين كان لها الحق في أن تدير بيتها ومزرعتها، وأعطت الشرائع الميزوبتامية للمرأة حقوقا من أهمها حق البيع والتجارة والتملك، إلا أن الرجل كان هو المسيطر في كل الأحوال، وكان من حقه بيع زوجته لسداد لما عليه من الديون، كما أن الحكم الأخلاقي على الرجل يختلف عن المرأة، فزنا الرجل كان يعد من النزوات التي يمكن الصفح عنها، أما زنا المرأة (الزوجة) فكان عقابه الإعدام[1].
وفي قوانين حمورابي التي تعتبر أقدم نص تشريعي ظهر حتى اليوم، أعطى فيه للأب سلطة بيع أفراد أسرته أو هبتهم للغير مدة من الزمن، كما نص القانون بأن المرأة إذا أهملت زوجها أو تسببت في خراب بيتها تلقى في النهر، ونص كذلك على أنه عند اتهام الزوجة بالزنا دون دليل على ذلك وتناولتها ألسنة الناس تلقي في النهر وتغطس في الماء، فإذا عامت على وجه الماء كانت بريئة وإذا غطست اعتبرت آثمة[2].
أما شريعة القصاص فقد تدنت بمنزلة المرأة تدنياً كبيراً، فمن قتل بنتا رجل كان عليه أن يسلم له ابنته ليقتلها أو يمتلكها[3]، والمرأة البابلية لم يكن لها أن ترث إلا في حالة عدم وجود الذكور، أو كانت المرأة كاهنة، أما الأرملة فلم يكن لها من الميراث شيء إلا بقاءها في منزل الزوجية أما إذا تركت الزوج فلا ترث منه شيئا[4].كما كان يتصل بالهياكل عدد من النـساء، مـنهن الخادمـات، ومـنهن السراري للآلهة أو ممثليهم، الذين يقوموا مقامهم على الأرض، ولم تكن الفتاة في تلك الفترة ترى شيئاً من العار في أن تخدم الهياكل على هذا النحو، وكان أبوها يفخـر بـأن يهـب جمالهـا ومفاتنها لتخفيف ما يعتري حياة الكهان المقدسة من ملل وسآمة، وكان يحتفل بإدخال ابنته في هذه الخدمة المقدسة، ويقرب القرابين في هذا الاحتفال[5].
2/ مكانة المرأة في الحضارة المصرية: كانت للمرأة في الحضارة الفرعونية حقوق لم تحصل عليها مثيلاتها في الحضارات الأخرى، فقد وصلت إلى الحكم وأحاطتها الأساطير، وكانت المرأة المصرية لها سلطة قوية على إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، غير أن الفراعنة في كثير من الأحيان يضحون بأفضل بأجمل فتاة كقربان رضا الآلهة[6].
3/ المرأة عند الإغريق : كانت المرأة عند الإغريق محتقرة مهانة، وقد عوملت معاملة المخلوقات الوضيعة، وحتى اعتبروها رجسا من عمل الشيطان، وكانت كسقط المتاع تباع وتشتري في الأسواق[7]. وما يدعم هذا الكلام ما قاله الفيلسوف سقراط قائلا: «إن وجود المرأة هو أكبر منشأ، ومصدر الأزمة والانهيار في العالم، وإن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلا، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا»[8].
كما كانت مسلوبة الحقوق محرومة من الميراث وحق التصرف في المال، وكانت في غاية الانحطاط وسوء الحال، فيقول أرسطو: «ثلاث ليس لهم القدرة على التصرف في أنفسهم العبد فليس له إرادة، والطفل له إرادة ناقصة، والمرأة لها إرادة لكنها عاجزة»[9].
وكانوا يعتبرون أن المرأة لا تساوي الرجل إنسانياً، بل كانوا يعتبرونها كائنا أدنى من الرجل وأقل سموا من الناحية الأخلاقية، ولم يكن ذلك مقصورا على عامتهم بل كان الرأي السائد لدى شعرائهم وكتابهم وفلاسفتهم، ولم يقتصر ذلك على فترة معينة من تاريخهم بل استمر طيلة قرون عديدة ففي الإلياذة كان المحارب إذا أراد أن يسب آخر وأن يعبر له عن احتقاره كان ينعته بأنه امرأة[10]
فلم يكونوا يحفلـون بمـشاعرها أو أحاسيسها، حتى النظام الثقافي اليوناني لم يجعل للمرأة أي مراعـاة، فـأفلاطون فـي جمهوريته الفاضلة قال: بمشاعية النساء والأولاد، خاصة بين فئتي الجنـود والحكـام[11].
4/ المرأة عند الرومان : الرومان هم ورثة حضارة اليونان، فنجدهم التزموا بالموقف اليوناني من المرأة وهو موقف الاستهتار بها، واعتقادهم بأنها أقل قدرة من الرجل، لذلك لابد من بقاء سلطة الرجـل عليها وتحكمه بها[12].
فلم تكن المرأة في الإمبراطورية الرومانية أحسن من غيرها في ظل الجاهلية، فقد كانت أقبح حالا وأكثر ذلك، لأنهم يعتقدون أن المرأة أداة للإغواء وسيلة للخداع وإفساد قلوب الرجال، لذلك كانوا ينظرون إليها نظرة احتقار واستذلال[13]، حيث اعتبر الرومان المرأة متاعا للرجل وسلعة رخيصة يتصرف فيها كيف ما شاء، وحياتها ليست ملكا لها، وإنما لأبيها ثم لزوجها من تاريخ زواجها ثم لأبنائها بعد وفاة زوجها، وملكيتهم لها ملكية السيد للرقيق[14].
ووصل الأمر بهم إلى حد عدم مراعاة إنسانيتها، فأجازوا للرجل قمع أمومتها ساعة يشاء بأن ينتزع أولادها منها وتركهم يتعرضون للمرض والموت بعيدا عنها وربما أمامها، وكانوا يعتبرون أن المرأة والعبد من جملة أدوات الرجل الضرورية التي لابد منها[15]. ومن شرائعهم: أن العمل الذي يقوم به إنسان تحت تأثير المرأة عمل باطل قانونا، وأن المرأة إن مات زوجها لم ترث من ماله أي شيء.[16]
ومن عجيب ما ذكرته بعض المصادر، أن ما لاقته المرأة في العصور الرومانية تحت شعارهم المعروف " ليس المرأة روح" فيتم تعذيبها بسكب الزيت الحار على بدنها، وربطها بالأعمدة، بل كانوا يربطون بعضها بذيول الخيول، ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت[17].
والأغرب من ذلك كله ما يروي التاريخ في ذلك أن الرومان عقدوا مؤتمر للبحث شؤون المرأة، وانتهى بالقرارات الآتية:
- أن المرأة ليس لها نفس، لذلك فإنها لا تستطيع أن تنال الحياة في الأخر.
- يجب على المرأة ألا تأكل اللحم، وألا تضحك، ويجب عليها أن لا تتكلم.
- المرأة رجس من عمل الشيطان، تستحق الذل والهوان في المجتمع.
- على المرأة أن تقضي حياتها في طاعة الأصنام وخدمة الزوج.
وقد طبق الرومان هذه القرارات فكانوا يضعون قفلا على فم المرأة لمنعها من الكلام، وتمشي في الطريق على فمها قفل من حديد يسمي "موزلير" لأن كلامها أداة للإغراء[18].
وفي الحياة العامة كانوا ينظرون للمرأة على أنها مجرد متعة للرجل حيث أنهم شجعوا العهر وأباحوه دون أن يراعوا حرمة أو دينا، وكانت هذه المهنة ينظمها القانون ويشرف على تنظيمها وتحديد أجورها[19].
5/ المرأة عند الفرس: كانت التقاليد الفارسية تحط من قدر المرأة وتهينها، وتنظر إليها نظرة تعصب وتتشاءم منها، ففي الديانة الزرادشتية يحقرون شأن المرأة، ويعتقدون أنها سبب الشر الذي يستوجب العذاب والسخط لدى الآلهة، فلم تكن المرأة الفارسية في مكانة تختلف عن مثيلاتها في المجتمعات القديمة، حيث قرر الفرس بعد جدال ونقاش أن المرأة إنسان إلا أنها خلقت للذل والهوان، ولتكون في خدمة الرجل وتحت أمره ونهيه يتصرف فيها كتصرفه في السلعة، وله أن يحكم عليها بالموت[20].
كما عليها أن تعيش تحت أنماط الظلم، فكان للزوج السلطة الكاملة والتامة في التصرف في زوجته، وكان تعدد الزوجات دون قيد وشرط تشجيعا للنسل[21]. وكانت ولادة البنت عند الفرس تجلب اللوعة والحسرة، لأنهم يربوهن لمنزل رجل أخر يجني الفائدة.
6/ المرأة عند الهنود : كانت نظرة الهنود إلى المرأة بين الإفراط والتفريط، فهي ذليلة مهينة ليس لها حق الاستقلال عن أبيها وزجها أو ولدها، فإذا مات هؤلاء وجب أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها، وهي قاصرة طيلة حياتها، وتحرم من الحقوق الملكية والإرث، وتبقى ملكا للرجل مدة حيازته حتى آخر أنفاسها[22].
كما اعتبروا المرأة دون الرجل منذ الولادة والخلق الأول، ففـي أسـاطيرهم أن المبدع الإلهي عندما أراد خلق المرأة وجد أن مواد الخلق قد نفذت كلها في صـياغة الرجـل، ولم يبق لديه من العناصر الصلبة بقية فحل هذه المشكلة عن طريق البقايا المتناثرة من خلـق الرجل، فصاغ المرأة من ما تبقى من القصاصات التي تناثرت من عمليات الخلـق الـسابقة، يختار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك[23].
والمرأة عند الهنود مادة الإثم وعنوان الانحطاط الخلقي والروحي، ولا خير فيها، ومما ورد شرائع مانو على أن الوباء والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة[24]. كما جاء أن الزوجة الوفية يجب أن تخدم زوجها كما لو كان إلها، وألا يأتي شيء من شأنه أن يؤلمه حتى وإن خلا من الفضائل، وعلى المرأة أن تخاطب زوجها في خشوع قائلة له: " يا مولاي وأحيانا يا إلهي"، وتمشي خلفه بمسافة ولا تتكلم معه، ولا تأكل معه، بل تأكل مما يتبقى من الأكل[25].
كما لم يكن لها حق الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم موت زوجها، وأن تُحرق معه وهي حية على موقد واحد، واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر ميلادي[26]، حيث أبطلت هذه العادة على كره من رجال الدين الهنود، وإذا رضيت أن تعيش بعد زوجها، فهي قد تخففت من الموت المادي إلى نوع من أنواع الموت المعنوي، فعليها أن تحلق رأسها أو تجدع أنفها أو تصلم أذنها، أو تشوه وجهها، لكي تضمن ألا ينظر إليها بعد زوجها رجل آخر[27]. كما كانت تقدم قربانا لآلهة من أجل كسب رضاها لهطول المطر والسعة في الرزق[28].
7/ المرأة في الصين: كانت المرأة في الصين تتجرّع كؤوس المهانة صباحا ومساء. وقد رسمت أغنية صينية قديمة صورة وضع المرأة الحقيقي في الصين وقد تضمنت: «ألا ما أتعس حظّ المرأة، ليس في العالم كله شيء أقلّ قيمة منها. إن الأولاد الصبيان يقفون متكئين على الأبواب كأنّهم آلهة هبطوا من السماء، أما البنت فإن أحدا لا يسرّ بمولدها وإذا كبرت اختبأت في حجرتها تخشى أن تنظر وجه إنسان ولا يبكيها أحد إذا اختفت من منزلها».
ولقد كان الأب الصيني مثلاً إذا بشّر بالأنثى ذهب إلى السوق عارضا إياها للبيع بأبخس الأثمان، فإن لم يجد من يشتريها أعطاها لأول عابر سبيل بدون مقابل، أو عمد إلى قتلها خنقا في مكان مهجور أو إغراقها أو وأدها في التراب. والتي لم يتم التخلّص منها بوسيلة من الوسائل، يصار إلى تشويه أقدامها لمنعها من الخروج من بيت أبيها أو زوجها، وكانت المرأة دائما تحت الوصاية إما من أبيها أو من زوجها أو حتى من ابنها، أو من رجل من أقارب زوجها في النسب[29].
8/ المرأة عند العرب قبل الإسلام: إن المرأة عند العرب في الجاهلية الأولى لم تلقى التكريم اللائق بها، بل كانت مهانة ومحتقرة، وقد كانوا يحرصون على كثرة إنجاب البنين في حين يكرهون ولادة الإناث، لأنهن لا يستطعن أن يمنعن الحمى، ولا فائدة منهن عندما تتأزم الأمور، وهن بعد ذلك هدف العدو. لذلك لاقت المرأة ألوانا من الظلم والاضطهاد والمهانة والإذلال[30] منها:
* / وأد البنات: وقد شهد القرآن الكريم بهذا المشهد البغيض الذي كان ينتظر الأنثى ساعة ولادتها في قوله تعالى: ﴿إِذَّا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ بِسُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُرَابْ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونْ﴾[31]، ولم تكن مهانة المرأة تقف عند الوأد فقط، فقد كانت تشمل كل جوانب حياة المرأة.
*/ الجرمان من المهر: فقد كانت تحرم من المهر، حيث كان الولي يأخذ المهر ولا يعطيها شيئا.
*/ تعدد الزوجات والحرمان من الإرث: وكان تعدد النساء بلا حدود ودون قيد أو شرط، فضلا عن الطلاق التعسفي[32]، وكذا الحرمان من الميراث.
فهذه صورة بشعة لحالة المرأة قبل الإسلام عند العرب قبل الإسلام وغيرها من الحضارات القديمة، من قتل ووأد وإذلال وحرمان[33].
9/ المرأة عند اليهود: رغم أن اليهودية دين سماوي إلا أن اليهود آمنوا ببعض هذا الدين وكفروا ببعضه، وحرفوا كثير من الحقائق، فكانت حالة المرأة سيئة ومهانة، وكانت متاعا يورث فإذا توفى شخص بدون أن ينجب أولادا ذكورا تصبح أرملته زوجة تلقائية لشقيق زوجها، رضيت بذلك أم كرهت، ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق مهما كانت الأسباب[34].
اعتبرت الديانة اليهودية المحرفة المرأة مصدر الإثم واللعنة، فحملتها التوراة غواية آدم وإخراجه من الجنة[35]، وجعلته يتملص من المسؤولية فتقول على لسانه: «هذه المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت»[36].
كما كانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحق في أن يبيعها قاصرة، ولم يكن لها حق في الميراث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، وإلا ما كان يتبرع به لها أبوها في حياته. ففي الإصحاح الثاني والأربعين من سفر أيوب: «ولم توجد نساء جميلات كنساء أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثا بين أخوانهن»، وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج، إذا كان الأب قد ترك عقاراً، أما إذا ترك مالا منقولا فلا شيء لها من النفقة والمهر ولو ترك القناطير المقنطرة، وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها ذكر لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها[37].
وكانت المرأة في المجتمع اليهودي تعتبر مملوكة لأبيها قبل زواجها وتشتري منه عند نكاحها لأن المهر كان يدفع لأبيها أو لأخيها على أنه ثمن الشراء، ثم تصير مملوكة لزوجها وهو سيدها المطلق، فإذا مات زوجها ورثها وارثه لأنها جزء من التركة، وله أن يبيعها، وكان الزواج بالأخت ذائعا عندهم، ثم بعد ذلك حرموا الأصول والفروع، وكان طبيعياً أن المرأة التي تورث كالمتاع لاحق لها في الميراث، والزوجة لا نصيب لها من تركة زوجها بل ظلت جزءاً من متاعه يرثها ذوي قرباه[38] .
كان اليهود يحتقرون المرأة ويعتبرونها نجسة طوال مدة حيضها، فلا يأكل الرجل من يدها ولا ينام معها في فراش واحد، وقد بين الحديث النبوي الشريف ذلك، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضـت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي المَحِيضِ﴾[39]، فقال صـحابة رسـول الله صلى الله عليه وسلم : ما نصنع يا رسول الله، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح »[40]. (رواه مسلم).
10/ المرأة عند النصارى:
يرى النصارى أن المرأة باب من أبواب الشيطان، وأنها يجب أن تستحي من جمالها لأنها سلاح إبليس للفتنة والإغراء، وأن المرأة ينبوع المعاصي، فهي للرجل من أبواب جهنم[41]. ويقول ترتليانوس أحد كبار القساوسة عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله، ومشوهة لصورة الرجل. كما صرح بولس بأن المرأة منبع الخطيئة، وأصل كل شر، وراء كل إثم ومصدر كل قبيح، وفي مجمع نيكون عام 586 م ومما خلص إليه النصارى فيه أن المرأة جسد به روح دنيئة، خالية من الروح من الناجية، واستثنوا مريم عليها السلام فقط لأنها أم المسيح عليه السلام[42].
II/المرأة في المغرب القديم :
كان المغرب القديم تسكنه غالبية من الأمازيغ على هذا النحو، لوحظت المرأة الأمازيغية قد اتخذت على أدوار كبيرة في المجتمعات المحلية. وكان هذا واضحا بشكل خاص من خلال شخصية الكاهنة.
كان للمرأة اللوبية دور بارز في المجتمع القبلي اللوبي حيث مثلت دور الزوجة والأم، فضلا عن مساعدتها للرجل في عدة مهام ولعل أبرزها خلال فترة الحروب حيث أدت دور الممرضة بإسعاف الجرحى، فارتدت زي الرجال عند تقليدها لمنصب قيادي[43].
أولا/ مكانة المرأة اللوبية:
كانت المرأة اللوبية ذات مكانة رفيعة فهي الطرف الفاعل في تقوية أواصر المصاهرة والقرابة بين الأسر والعائلات، كانت المرأة المتزوجة تعنى بأطفالها عناية كبيرة.
وتذكر الأدلة التاريخية أعمالها التي كانت تمارسها حيث لم تقتصر في إعداد الطعام وحلب المواشي وغزل الصوف فقط، وإنما كانت لها وظائف طقوسية وعلاجية تنفرد بها، حيث كانت المرأة تقوم بكي عروق الصدغ عندما يبلغ الطفل الرابعة كي لا يمرض طيلة حياته ويتقي شر الأرواح الخفية.
إن هذه الممارسة تعكس أن المجتمع اللوبي مجتمع تسلطت عليه فكرة تقديس السلف والتدين، ولابد أن تكون قد تولدت له هذه العادات من نظم الزواج[44].
ثانيا/ المرأة النوميدية:
كانت المرأة النوميدية ذات ملامح جميلة وكانت تتزوج في سن مبكرة، ويشترط فيها العفة قبل الزواج[45]. نظرا للمهام الكثيرة المنوطة بالمرأة النوميدية كانت تهرم بسرعة قبل الرجل، فإلى جانب الحمل والولادة المتكررة فإنها تعمل في الزراعة وأعمال يدوية متعبة مما يجعلها تبدو أكبر من سنها. وكانت مكانة المرأة عند زوجها بقدر ما لها من أبناء فكلما زاد عدد مرات الإنجاب كلما زادت مكانتها لما للأولاد من فائدة للعائلة في مساعدتها في أشغالها[46].
كما كانت ظاهرة المصاهرة بين مختلف القبائل عادة منتشرة بشكل كبير، فعززت أواصر القرابة بل واستخدمت في فض النزاعات بينهما وإحلال السلام، كما بلغت المرأة في الجانب الديني مرتبة كبيرة الكاهنات ما يعادلها عند الرجال بكبير الكهنة، ومن الأمثلة على ذلك والدة ماسينيسا[47].
ثالثا/ القيم السلوكية الاجتماعية عند المرأة المغاربية القديمة:
كان على المرأة النوميدية أن تلتزم بالأخلاق الحميدة التي تبعدها وتميزها عن أخلاق الرجال، فمثلا كان من المحرم على الزوجة أن تشرب الخمر[48].
يذكر ترتليانوس حول عاقبة احتساء المرأة للخمر أن رجلا نوميديا زوجته عن طريق تجويعها، وهذا بسبب فتحها مخزن النبيذ فقط فكيف باحتسائه[49].
أما الإجهاض فكان فعلا ممقوتا في العرف الاجتماعي، فحسب ترتليانوس الذي يقول: ''عندنا قتل النفس محرم إلى الأبد فلا يحل لنا إسقاط الجنين من رحم أمه وهو لا يزال في طور التكوين لأنه تعجيل بالقتل[50].
رابعا/ لباس المرأة:
كانت المرأة النوميدية تلبس ثوبا طويلا يغطي كامل جسمها يعرف بثوب الستولا (stola)، كما كانت تنتعل الصنادل وحذاء الكاكي الذي يغطي كامل القدم فضلا على تزينها بالحلي.
خامسا/ عمل المرأة:
من المهن التي مارستها المرأة المغاربية القديمة نذكر ما يلي[51]:
- السيدة بيتيليا التي كانت بائعة متجولة من فاسمبوس (نواحي تبسة حاليا)
- صافيديا بائعة الخبز من كاستيليوم.
- دوناتة صانعة الطبل من سطيف.
- إيميليا بائعة الفول من كيرتا.
كما تذكر المصادر ممارسة النسوة بعض الأعمال الإقتصادية مثل السيدة أوزنوفة التي لقبت بأونووي بمعنى المرأة العطوفة، وهي زوجة الملك الموري (بوغود) التي اشتغلت في التجارة أين كانت تتاجر بالخشب فضلا عن امتلاكها لفرقة من العازفات بتأجيرها لتنشيط مختلف الحفلات.
سادسا / نماذج من نساء المغرب القديم
أ/ الملكة عليسة: تعد شخصية عليسة من أشهر الشخصيات النسوية بل وأكثرها تأثيرا في المجتمع القرطاجي والمغاربي القديم، اسمها الحقيقي (إليشات)، واشتهرت باسمين هما عليسة ديدون، زوجها (عشرباص) كبير الكهنة، قامت بتأسيس قرطاجة المعروفة في اللغة الفينيقية (قرط حدشت) لما وافق سكان المغرب القديم على ذلك مقابل دفعها ضريبة سنوية لهم.
وتذكر الأسطورة التي يرويها جوستينيوس أنها أنهت حياتها بالانتحار نظرا لطلب الملك المحلي (هيرباص) الزواج منها وكان رفضها بإنهاء حياتها.
سلوكات عليسة:
تتميز عليسة بصفات كثيرة فهي امرأة ناضجة عقليا، وتمتعت بمجموعة من المبادئ والقيم استطاعت نقلها بعد تأسيسها لقرطاجة لأبناء شعبها الصغير.
أما الجانب الإقتصادي فكان لها حس فعال في مواصلة النشاط التجاري البحري، وتمكنت من خلق ثروة كبيرة مكنتها من توسيع رقعة مدينتها.
ب/ شخصية صفونيسب:
يعني اسمها الأصلي (صفنبعل) راعية الإله بعل، وهي من أصول أرستقراطية والدها عزربعل بن جيسكون، ولدت حوالي 221 ق.م .
لم تذكر لنا المصادر أنها أسندت لها مناصب سياسية، إلا أنها لعبت دور في الصراع الخفي بين الملك صفاكس وماسينيسا، نظرا لجمالها وأدبها. فقد ظفر بها الملك صفاكس عن طريق الزواج السياسي المصلحي عام 205 ق.م لكنها ماتت مبكرا عن طريق تجرع السم في سن العشرين عام 201ق.م بمساعدة من ماسينيسا رافضا بذلك تسليمها للرومان، وهو ما يبرز نبالتها ونبالته.
أصل هذه القصة قصة حب أين اختلطت المصلحة والسياسة، هسدروبعل ابن جيسكون هذا القائد القرطاجي كانت له هذه البنت المسماة صفونيسب، كان كل من ماسينيسا وصفاكس يكنون حبهما لها، فتواجها الخصمين في السياسة وفي الحب.
ولما تواجها الخصمين في معركة السهول الكبرى أفريل 203 ق.م ونتج عنها انهزام صفاكس ففر إلى مملكته، ولحق به ماسينيسا ولايليوس وأسروه بالقرب من قسنطينة أما صفونيسب أسرها ماسينيسا وخطط ليتزوجها وطالبت منه وتوسلت بعدم تسليمها للرومان حية نظرا لطلب لايليوس تسليمها للرومان كأسيرة حرب.
فأعطى ماسينيسا لصفونيسب كمهر كأس من السم وشربته بدون تردد وهكذا وضعت حد نهايتها مما يبين رفض المرأة المغاربية الخضوع للأجنبي وهذا على مر العصور
سلوك صفونيسب:
كانت شابة في مقتبل العمر، لكن عرف عنها شدة تدينها بعبادتها للآلهة القرطاجية في مدينة سيقا عاصمة زوجها صفاكس، كما كانت وفية لزوجها ذلك أنها انتحرت مكررة تصرف جدتها عليسة، مما يبين لنا تمسكها بالتقاليد والأعراف البونية المحافظة.
خاتمة:
بعد هذا العرض الموجز للمرأة في الشرق والغرب القديم خلصنا إلى النتائج التالية:
- للمرأة مكانة متباينة منذ القدم وعلى مر العصور عند مختلف الشعوب.
- احتقار الإغريق والرومان للمرأة والتي اعتبرت كسلعة تباع وتشترى.
- المرأة عند الفرس والهنود والصينيين لم تحظ بمكانتها بل تم الحط من قيمتها بأبشع التصرفات
- دور المرأة في الحياة الاجتماعية موغل في القدم ولم تكن مجرد كائن حي ولازالت قيمتها إلى يومنا هذا.
- المرأة المغاربية القديمة تبوأت مكانة كبيرة وكانت سندا للرجل في مختلف أعماله على عكس المرأة في باقي الحضارات.
- حظيت المرأة المغاربية القديمة بعفتها حتى قبل دخول المنطقة الإسلام.
وصول الإسلام إلى مختلف المناطق التي غطتها الدراسة زاد من قيمة المرأة وإعلاء شأنها فهو الدين الوحيد الذي أعطاها قيمتها الحقيقية.
[1] - أميمة محمد الحسن على النقى، حقوق المرأة بين الإسلام وأهواء الغرب، معهد العلوم والبحوث الإسلامية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ص 4.
[2] - Pierre Cruveilhier, Commentaire du code d' Hammourabi, Librairie Ernest Leroux, Paris, 1938, p 129.
[3] - مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص 17.
[4] - عبد الباسط محمد حسن، مكانة المرأة في التشريع الإسلامي، ج4 ، مركز دراسات المرأة والتنمية جامعة الأزهر (كلية البنات الإسلامية)، القاهرة ، ص 15.
[5] - ول ديورانت، قصة الحضارة ، ترجمة زكي نجيب محمود وآخرون، ط 1988 ، ج2، دار الجيل، بيروت، ص 32.
[6] - مريم إبراهيم أبو كشوة، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام ومقارنتها مع واقعها ومكانتها بعد الإسلام، من أعمال الملتقى الدولي الأول للسيرة النبوية الشريفة، الخرطوم( السودان)، جانفي 2013، ص 119.
[7]-محمد على سكيكر، حقوق المرأة وواجباتها في الشرائع، كتاب الجمهورية، مصر، ص21.
[8] - باسمة كيال، تطور المرأة عبر التاريخ، عز الدين للطباعة و النشر، بيروت ( لبنان)، 1971، ص 37.
[9]- أبو الأعلى المادودي، الحجاب، تعريب محمد كاظم السباق، ط2، دار الفكر، دمشق( سوريا)، 1964، ص8.
[10] - محمود سلام زناتي، المرأة عند قدماء اليونان، الإسكندرية، 1957، د د ن، ص 30.
[11] - ول ديورانت، المرجع السابق، ج 3، ص 114.
[12] - نفسه، ج 10، ص 368.
[13]- عبد الباسط محمد حسن، مكانة المرأة في التشريع الإسلامي، مركز دراسات المرأة والتنمية، القاهرة، جامعة الأزهر، ص8.
[14]- أميمة محمد الحسن على النقى، حقوق المرأة بين الإسلام وأهواء الغرب، معهد العلوم والبحوث الإسلامية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ص 3.
[15] - عاطف مصطفي البراوي التتر، حقوق الزوجة المالية في الفقه الإسلامي (مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني)، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 2006، ، المرجع السابق، ص19.
[16] - ول ديورانت، المرجع السابق، ج7، ص118.
[17]- محمد ابن أحمد إسماعيل المقدم، عودة الحجاب، ط10، ج2، دار طبية للنشر والتوزيع، الرياض (السعودية)، 2006، ص47.
[18]- أحمد شلبي، مقارنة الأديان، ج3 ، مكتبة النهضة الإسلامية، مصر، 1973، ص207.
[19] - عاطف مصطفي البراوي التتر، المرجع السابق، ص20.
[20]- صفاء عوفى حسين عاشور، قضايا المرأة المسلمة والغرو الفكري، رسالة ماجستير، جامعة غزة ، فلسطين، 2005، ص8.
[21]- أميمة محمد الحسن على النقى، المرجع السابق، ص3؛ محمد فريحة، حقوق المرأة المسلمة في القرآن و السنة، المكتب الإسلامي، بيروت، 1996، ص 12.
[22]- مصطفى السباعي، المرآة بين الفقه والقانون، ط1، مكتبة الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، 1999، ص 18.
[23] - ول ديورانت، المرجع السابق، ج3، ص 178.
[24] - نفسه.
[25]- صفاء عوني حسين عاشور، المرجع السابق، ص 10.
[26] - عمر رضا كحالة، المرأة في القديم والحديث، ط 1، ج2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1979م، ص8؛ محمد فريحة، المرجع السابق، ص 12.
[27]- مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص18.
[28] - ول ديورانت، المرجع السابق، ج3، ص 108؛ مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص 18.
[29]- غادة الخرسا، المرجع السابق، ص 21.
[30]- صفاء عونى حسين عاشور، المرجع السابق، ص20
[31]- سورة النحل، الآيات 58-59.
[32] - Faryal Abbas Abdullah Sulaimani, The Changing Position of Women in Arabia
Under Islam During the Early Seventh Century, A Thesis Submitted For The Degree of Master of Philosophy, University of Salford, International Studies Unit, 1986, p17
[33]- صفاء عونى حسين عاشور، المرجع السابق، 21-28.
[34]- أحمد شلبي، المرجع السابق، ص ص41-42.
[35]- نوال بورحلة ، مكانة المرأة في الحضارات القديمة، مجلة العلوم والإنسانية والاجتماعية، العدد 31، ديسمبر، 2017، ص98.
[36] - التوراة، سفر التكوين، الإصحاح 3/ 12.
[37]- أحمد بن عبد العزيز الحصين، المرأة المسلمة أمام التحديات، ط1، دار المعارج الدولية، الرياض، 1998، ص 23.
[38]- محمد حامد ناصر، المرجع السابق، ص 4.
[39] - سورة البقرة، الآية 222.
[40]- صحيح مسلم، كتاب الحيض، الحديث رقم 302، ص 38.
[41] - مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص ص 18- 19.
[42] - أحمد بن عبد العزيز الحصين، المرجع السابق، ص ص 24-25.
[43]- مها عيساوي، المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم، أطروحة دكتوراه، إشراف محمد الصغير غانم، جامعة قسنطينة، الجزائر 2009/2010، ص 119.
[44]Jehan desange,catalogue des tribus africaines de l’antiquite classique a l’ouest du nil, ed. P.U.B, dakkar, 1962 p81.
[45]Gsell(s), H.A.A.N, t5, librarie Hachette, Paris 1927, p42.
[46]Gsell(s),op.cit, p46.
- محمد الصغير غانم، سيرتا النوميدية، ط1، دار الهدى-عين مليلة، الجزائر 2008، ص 230.[47]
- مها عيساوي، المرجع السابق، ص 415.[48]
- ترتليانوس، المنافحة، (دفاع عن التوحيد)، ط1، تر.عمار الجلاصي، طرابلس 2001 ج2، ص 30.[49]
- مها عيساوي،المرجع السابق، ص 416.[50]
- نفسه، ص 422.[51]
وسائل الإصلاح عند الإمام عبد الحميد بن باديس
من خلال أبرز تلامذة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
د/ لهلالي إسعد - جامعة سطيف2
ملخص
تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما يتعلق برائد من رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر ألا وهو؛ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه دفاعا عن الدين الإسلامي واللغة لعربية ضد السياسة الاستعمارية التي حاولت طمس معالم الشخصية الجزائرية ،ونشر المسيحية واللغة الفرنسية ، وحسب بعض تلامذة الشيخ بن باديس فإن هذا الأخير اعتمد في مشروعه الإصلاحي على المدارس والمساجد إضافة غلى النوادي، ولم يهمل دور الصحافة فقد كانت لسان حال جمعية العلماء المسلمين التي أسسها مع ثلة من العلماء الذين ركزوا في نشاطهم على إحياء كل ما له علاقة بالدين واللغة والوطن.
الكلمات المفتاحية: الحركة الاصلاحية، المدارس ، المساجد، النوادي، الصحافة.
مقدمــــة
يتناول يعتبر الإمام عبد الحميد بن باديس أحد أقطاب الحركة الإصلاحية في الجزائر ورائد النهضة الجزائرية، والحقيقة أن هذا الرجل قدم خدمات جليلة في مواجهة السياسة الاستعمارية الفرنسية شعاره في ذلك " الإسلام ديننا ، العربية لغتنا والجزائر وطننا"،وقد عاش مع أبناء جلدته في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية واجتماعية وثقافية مزرية ، وحاول الاستعمار الفرنسي طمس كل ما له علاقة بثوابت الهوية الوطنية .
لقد كان ظهور العلامة عبد الحميد بن باديس انتصارا للدين واللغة والوطن وهو الشعار الذي رفعته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسسها الإمام مع ثلة من العلماء لمواجهة السياسة الاستعمارية، التي عاث من خلالها المستعمر فسادا في الأرض واستغلالا لخيراتها وثرواتها.
وسنركز على الوسائل التي اعتمد عليها الإمام ابن باديس في نضاله الإصلاحي وذلك من خلال أبرز تلامذة الجمعية الذين التقينا بهم ومن بينهم: الشيخ محمد الصالح رمضان، الشيخ عبد الرحمن شيبان، عمار مطاطلة، إبراهيم مزهودي ومصطفى بوغابة. فماهي الوسائل التي اعتمد عليها الإمام بن باديس في سبيل تجسيد أهداف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟
مفهوم الإصلاح عند الباحثين وتلامذة العلامة عبد الحميد ابن باديس:
والحقيقة أن مفهوم الإصلاح مرتبط بالحركة الإصلاحية التي ظهرت في الجزائر وتزعمتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي تأثرت بتيار الجامعة الإسلامية الذي كان وراءه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا الذين دعوا إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الصحيح ومحاربة البدع والخرافات وكل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله. (1) وحسب أبو القاسم سعد الله فإن الكثير يربط الإصلاح في الجزائر بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لكن الإصلاح أوسع من مفهوم الجمعية، ويستدل بعدد من المثقفين من أصحاب الثقافة العربية الذين كانوا مصلحين ولم ينضموا إلى الجمعية، حيث خالفوها في بعض المبادئ والأهداف ن كما ان الجمعية قد شخصت الحركة الإصلاحية في الجزائر وكونت مدرسة جديدة لم يقم بها الإصلاح القديم والجمعية ولدت نتيجة الحركة الإصلاحية.
(2) وليس العكس ويرى مصطفى الأشرف أن الجمعية اقتصر عملها على الصعيدين الثقافي والديني بقوله:" إن التراث السياسي الثقافي الذي تولى الرعيل الأخير من النخبة المثقفة القسنطينية 1887 نقله إلى الخلف من خطوطه العامة قد انشق أو يكاد عندما انتقل إلى جمعية العلماء التي خففت أو أهملت جوانب السياسة الصرفة وركزت على جوابه التربوية (نشر اللغة العربية) والروحية (محاربة العقلية الخرافية التي يروجها المرابطون والمطالبة بفصل الدين عن الدولة) والشريعة (العمل من أجل استقلال القضاء الإسلامي الأصيل".
إن الإصلاح الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو في الحقيقة من وضع الامام عبد الحميد بن باديس وهذا الإصلاح انطلق من آلام وآمال الشعب الجزائري ويقول في ذلك الدكتور عبد الكريم بوصفصاف." والحق أن ابن باديس لم يفصل في حركته بين النظرية والتطبيق أو بعبارة أدق لم يفرق بين العقيدة والعمل، وقد بدأ الإصلاح سهلا هينا جعل المستعمر يظن أن لا خطر فيه، ذلك أنه بدأ يتكلم عن الدين والأخلاق والعقيدة وضرورة الإصلاح الديني، والنصيحة من أجل الآخرين والشورى عند الملمات (1) استعدادا لمرحلة الجهاد والكفاح ، أي أنه وضع البذرة وتعهد النبتة".
(2) ويرى الشيخ عبد الرحمن شيبان أن الإصلاح بدأه الإمام عبد الحميد بن باديس وأقرانه من العلماء أمثال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، والشيخ الطيب العقبي، وغيرهما فيقول:" الفكر الإصلاحي عند ابن باديس هو فكر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، ومبارك الميلي والعربي التبسي، وشعارهم في ذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، ومن صفاء العقيدة لا تشوبها البدع والضلالات"
لقد كان الإصلاح عند العلماء عبارة عن عمليات متواصلة ركزت على إصلاح النفس بإتباع الدين الصحيح بالكتاب والسنة، كما ركزت على إصلاح المجتمع بنشر الفضائل والآداب وكذا إصلاح الشباب وذلك بضرورة تعلمهم ومعرفتهم بلغتهم وإحياء تاريخهم وأمجادهم وليس معنى هذا أن العلماء لم يكونوا معنيين بالسياسة بل كانوا كذلك كما يقول أبو القاسم سعد الله:" والإصلاح بالمعنى الشامل قد يبدأ بالثقافة أو بالدين أو بالمجتمع ولكنه في نهاية الأمر يغطي كل مظاهر الحياة في مجتمع ما بما في ذلك السياسة ، فالإسلام كما هو معروف دين ودولة ،
ولا يمكن أن نتحدث عن الإصلاح في الإسلام مجردا من معنى الدولة وهذا حتما هو عين السياسة ".(3)
لقد اعتمد الإمام ابن باديس على عدة وسائل في نشاطه الإصلاحي حيث ركز على المدارس والمساجد والنوادي والصحافة وهذا ما أكده تلامذة الجمعية الذين التقينا بهم ومن بينهم الشيخ محمد الصالح رمضان، الشيخ عمار مطاطلة ، الشيخ عبد الرحمن شيبان ، الشيخ إبراهيم مزهودي ، والشيخ مصطفى بوغابة.
ولا – المدارس:
(1) كان المظهر الرئيسي لنشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على المستوى التربوي والتعليمي هو تأسيس المدارس العربية التي لم تكن تحت سيطرة الفرنسيين ، حيث (2)كان العلماء أكثر تمسكا بإنشاء هذه المدارس، فقد عمل الإمام بن باديس على بناء المدارس التعليمية الحديثة في كل ناحية من نواحي القطر الجزائري محاولا بذلك إخراجها من التعليم التقليدي المألوف الذي كان يتم في الكتاتيب القرآنية والزوايا المعروفة إلى تجهيز المدارس بوسائل تعليمية تتماشى وطرق التربية الحديثة فذاع صيت هذه المدارس فأصبحت أخطر منافس للمدارس الفرنسية.(3)
(4)كما شجع الإمام ابن باديس العلماء للحصول على رخص لفتح المدارس في جهات متعددة من الوطن ، وكانت مدارس العلماء في أغلبها مدارس ابتدائية لتعليم الأطفال (5)الصغار نهارا والشباب والكهول ليلا، وتستغرق الدراسة في المدارس الابتدائية ست سنوات وتتكون من ثلاث أقسام هي القسم التحضيري، القسم الابتدائي والقسم المتوسط، وكل قسم مدته سنتان، أما المناهج الدراسية المتبعة في مدارس الجمعية فكانت تحتوي على ثلاث أسس هي التربية الاسلامية والثقافة العربية ومبادئ أولية للمعارف العلمية.
وخلال لقائنا- الباحث- مع الشيخ عمار مطاطلة – تلميذ الإمام عبد الحميد بن باديس- ذكر لنا أن الإمام كان يجلس على كرسي ويحضر معه كراسه ، وفي بعض المواد لا يحضر كراسته، وكان عدد التلاميذ حوالي 300 تلميذ ، وفي القاعة أكثر من 50 تلميذ ، ومن التلاميذ الذين درسوا مع الشيخ مطاطلة الفضيل الورثيلاني ، الشيخ صالحي، رشيد أمير ، عمر دردور وأكد أن الإمام بن باديس كان يقول لهم دائما " تعلموا، تحابوا ، تعاونوا"،ويضيف الشيخ مطاطلة أنه كان يدرس صباحا الموطأ ثم مقدمة ابن خلدون ثم (1)الألفية أما مساءا فدروس أخرى، كما أن أستاذهم الإمام بن باديس كان له بيت خاص بمدرسة التربية والتعليم ، ويقوم أخوه الأصغر عبد الحق بن باديس بإحضار الأكل والقهوة إليه لأن الإمام كان يعطي أهمية كبيرة للوقت ، وقد أكد لنا أخوه عبد الحق في لقائنا معه ما ذكر عمار مطاطلة بأنه فعلا يحضر ما يحتاجه في الصباح الباكر ، وحتى طريقة التعامل كانت مثل بقية تلامذته (2)
وقد استمر النشاط التعليمي لابن باديس في إطار جمعية العلماء التي عرفت تطورا ملحوظا وتزايد عدد مدارسها ، إذ تذكر المصادر أن عدد مدارس الجمعية قد بلغ ما بين سنتي 1931 و1934 حوالي سبعين مدرسة ذات القسم الواحد أو القسمين وحسب إحصائيات عامل عمالة قسنطينة سنة 1938 فإن مدارس الجمعية قد بلغ عددها في عمالة قسنطينة وحدها خمسة وثمانين مدرسة فيها حوالي أربعة آلاف تلميذ ، أما في عمالة الجزائر فقد بلغ في نفس السنة حوالي ثمانية وستين مدرسة ، وهذا ما يبين أن نشاط الإمام بن باديس كان مكثفا لأنه كان يدرك أهمية المدرسة في مواجهة الساسة الاستعمارية القائمة على الفرنسة والإدماج ، فقد تفانى هو وأقرانه من العلماء في بناء المدارس وواصلوا نهجهم في خدمة العلم وإعداد جيل مثقف انطلاقا من فكرتهم الراسخة بضرورة تعليم الشباب وتثقيفه لأن تحرير الجزائر لن يكون إلا بإنشاء جيل يحمل فكرة الجمعية (3)
ورغم أن مدارس الجمعية كانت كثيرة في تلك المرحلة إلا ان أهمها كانت مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة التي أسسها الإمام بن باديبس، حيث كانت المدرسة معهدا للنشاط التربوي والتعليمي إضافة إلى صرح آخر عرف بمدرسة دار الحديث بتلمسان والتي افتتحت في صيف 1937، حيث أشرف الشيخ محمد البشير الإبراهيمي على تأسيسها ووضع تصميمها، واشتملت على عدة أقسام كل قسم مختص لعمل معين كالصلاة والمحاضرات والتعليم، وعين لإدارتها محمد الصالح رمضان.(1)
ثانيا-المساجد والنوادي:
رغم اهتمام الجمعية الكبير بالمدارس إلا أنها لم تهمل المسجد الذي كان له دور كبير في بلورة فكرة الإصلاح التي تبنتها جمعية العلماء، وقد بين الإمام بن باديس أهمية المسجد في مقالاته المنشورة في الشهاب بقوله:"إذا كانت المساجد معمورة بدروس العلم فإن العامة التي ترتاد المساجد تكون من العلم على حظ وافر وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر العقيدة وبصيرة صحيحة، بالدين فتكمن هي في نفوسها ولا تهمل وقد عرفت العلم وذاقت حلاوة بتعليم أبنائها وهكذا ينشر العلم في الأمة ويكثر طلابه من أبنائها ". (2)
لقد اتخذ الامام عبد الحميد بن باديس المسجد وسيلة لتربية النشء تربية دينية وترسيخ تعاليم الدين الصحيحة لدى العامة من الناس إذ أن المسجد مقصد للجميع ولم يخصص لفئة معينة ولذلك عملت الجمعية منذ أول عهدها على تقديم دروس الوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي العام للكبار والصغار.
وكانت تعقد لهذه المهمة الرحلات والجولات في أنحاء الوطن حيث تجوب وفود العلماء في كل المناطق الجزائرية، واعتادت جمعية العلماء على أداء هذه المهمة التربوية إذ أكد) العلماء أن إصلاح الأمة مرهون بدروس الوعظ والإرشاد والتعليم المسجدي. (4
وكانت تلك الدروس مستمرة طوال أيام السنة دون انقطاع مع تكثيف النشاط في شهر رمضان المبارك حيث تعمم الدروس على كل مدينة وقرية، ويتوزع العلماء على قرى ومدن العمالات الثلاث ومن أهم المساجد التي ركز ابن باديس نشاطه فيها: المسجد الكبير، الجامع الأخضر، سيدي قموش وغيرها من المساجد التي كانت من أهم وسائل الإصلاح عند العلامة عبد الحميد بن باديبس إلى جانب المدارس.
أما النوادي فقد ركزعليها ابن باديس نظرا لأهميتها لأنها كانت تجمع الشيوخ والشبان واهتمت بتربيتهم تربية دينية ، إضافة إلى ما كانم يقدم من نشاطات تثقيفية وأهم النوادي نادي الترقي الذي تأسس سنة 1927 وكان مقرا لجمعية العلماء كذلك نادي السعادة ونادي الاتحاد ونادي الإرشاد وغيرها وكلها كانت تهذيبية ، كم أكد لنا تلامذة الجمعية كالشيخ عمار مطاطلة والشيخ محمد الصالح رمضان وعبد الرحمن شيبان ومصطفى بوغابة وإبراهيم مزهودي أهمية تلك النوادي وكيف أن الإمام بن باديس كان يراها مكملة لنشاط المدرسة والمسجد ، وذلك لم يكن سهلا في ظل الظروف التي كانت تعيشها الجزائر لأن السلطات الاستعمارية لم تغفل عن نشاط الجمعية وكان رد فعلها بغلق المدارس والمساجد وملاحقة المدرسين .
ثالثا – الصحافة:
لقد كانت الصحافة من أهم الوسائل التي اعتمدها الإمام عبد الحميد بن باديس في نشاطه الإصلاحي في إطار جمعية العلماء، فبالإضافة إلى تركيز العلماء على المدارس للحفاظ على اللغة العربية وتخريج العلماء المثقفين والمساجد للوعظ والإرشاد فالصحافة هيأت الأرضية المناسبة للمصلحين لاقتناع المجتمع بالتغيير وقبوله بالابتعاد عن الخرافات والأباطيل والدفاع عن الدين واللغة والوطن.
وحسب تلامذة الجمعية الذين التقينا بهم – الباحث- فإن الإمام ابن باديس قد برز نشاطه الصحفي قبل تأسيس جمعية العلماء مع جريدة المنتقد سنة 1925 وكذا الشهاب، ثم تأسيس (1) ، جريدة السنة النبوية سنة 1933تحت إشراف الإمام ابن باديس وكانت تصدر يوم الاثنين من كل أسبوع ، وتأسست الصحيفة لهدف أساسي هو نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى إتباع كل ما أتى به القرآن من أقوال أو أفعال وبعد صدور (2) ، قرار تعطيلها في جويلية 1933 خلفتها جريدة الشريعة النبوية المحمدية في جويلية 1933 ، وكانت آنذاك لسان حال الجمعية إلا أنها صودرت بعد مدة قصيرة وآخر عدد لها كان في 28 أوت 1933 ، وخلفتها صحيفة الصراط السوي التي ظهر عددها الأول في 11سبتمبر 1933 وتم تعطيلها هي أيضا بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية بعد صدور(3) سبعة عشر عددا منها ، وبعد تعطيل هذه الصحف الثلاثة لم تتمكن الجمعية من إصدار صحيفة أخرى إلا بعد سنتين، حيث أصدرت جريدة البصائر وقد صدر العدد الأول في27ديسمبر 1935 ، واستمر نشاطها إلى غاية 1939 وبسبب الحرب العالمية الثانية أوقفت الجمعية صحفها ونشاطها.وفي يوم 16 أفريل 1940 توفي الامام بن باديس لكن نشاطها استمر بعد الحرب العالمية الثانية برئاسة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي.
خاتمة
يمكن القول أن الإمام عبد الحميد بن باديس اعتمد على المدارس والمساجد والنوادي والصحافة لما لها من أهمية في إيصال أفكاره الإصلاحية ليس فقط كما كتب عنها الكثير وإنما من خلال شهادات من عايشوا المرحلة عن كثب من تلامذته الذين أجمعوا وأكدوا أن الرجل حقيقة هو رائد النهضة الجزائرية الحديثة.
كما أن الصحافة التي تبناها الإمام عبد الحميد بن باديس كانت من أهم وسائله في نشاطه الإصلاحي لأنها كانت تحمل راية البيان العربي، وكافحت من أجل إحياء اللغة العربية وتنقية الإسلام ونشر فكرة الإصلاح الديني كما عمل ابن باديس على محاربة الطرق الصوفية والإدارة الاستعمارية وإحياء الشخصية الوطنية الجزائرية وربطها بالوطن العربي والإسلامي، وحارب السياسة الفرنسية الرمية إلى التجنيس وإدماج وفرنسة الجزائريين.
ورغم تناول الباحثين لجوانب كثيرة متعلقة بحياة الرجل إلا أنها تبقى قليلة مقارنة بما قدمه الرجل كيف لا وقد صرح ذات يوم بأنه يعيش من أجل الإسلام والجزائر ، وكان بإمكان الرجل أن يعيش حياة هنيئة بالنظر إلى واقع أسرته الاجتماعية ومكانتها في قسنطينة ، إلا أنه فضل أن يكون في صف أبناء وطنه وواجه السياسة الاستعمارية ووظف جهده وعلمه وماله في خدمة مبادئ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتكوين جيل مدرك لهويته وجذوره التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، هذا الجيل الذي حرر الجزائر من قيود الاستعمار الفرنسي .
المصادر والمراجع المعتمدة:
1-أبو القاسم سعد الله: أفكار جامحة، م.و.ك، الجزائر 1988،
2- بو القاسم سعد الله:الحركة الوطنية الجزائرية،ج1،ط4،دار الغرب الإسلامي بيروت 1992،
3- أبو القاسم سعد الله:الحركة الوطنية الجزائرية،ج2،ط4،دار الغرب الإسلامي بيروت 1992،
4- مصطفى الأشرف:الجزائر الأمة والمجتمع، تر حنفي بن عيسى، م.و.ك ،الجزائر 1983،
5-عبد الكريم بوصفصاف: الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية في حركتي محمد عبده وعبد الحميد بن باديس، ج1، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة تونس، السنة الجامعية 1996-1997،
6 -عبد الكريم بوصفصاف:جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتها بالحركات الجزائرية الأخرى 1931-1945،رسالة ماجستير قسنطينة1983،
7 -محمد الطيب العلوي : مظاهر المقاومة الجزائرية من عام 1830 حتى ثورة نوفمبر 1954، ط1،دار البعث قسنطينة 1985،
8-Mahfoud kaddache : histoire du nationalisme Algérienne,1919-1951,t 2,S.N.E.D ,Alger.
9-رابح تركي: جمعية العلماء المسلمين ال تاريخية1931-1956ن ط1، م.و.ف.م،2004،
10-رابح تركي:الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر ، ط5،م.و.ك، الجزائر2001،ص399 .
11-العربي التبسي:مقالات في الدعوة إلى النهضة الاسلامية في الجزائر،القسم الثاني ،ط1، جمع وتعليق أحمد الرفاعي الشرفي ، دار الشهاب باتنة 1984،.
12--سليمان الصيد: نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار، ط1، الجزائر 1994،.
13-عبد الحميد بن باديس: "بواعثنا، عملنا، خطتنا، غايتنا"، جريدة السنة المحمدية،العدد: 1 ، 1933،
14-عمار الطالبي: ابن باديس حياته وآثاره، ج1.
15 -محمد خير الدين: مذكرات، ج2، مؤسسة الضحى، الجزائر 2002،.
16-عبد الرحمن شيبان: مقابلة شخصية، مقر جمعية العلماء بالجزائر العاصمة، يوم 4 أفريل 2005
17-محمد الصالح رمضان: مقابلة شخصية بمنزله بالقبة، الجزائر العاصمة يوم 21 جوان 2005
18--عمار مطاطلة: مقابلة شخصية بمنزله بالأبيار الجزائر العاصمة، يوم 12 نوفمبر 2008
19--مصطفى بوغابة: مقابلة شخصية:بمنزله بقسنطينة، يوم 25 ماي 2009
20-- عبد الحق بن باديس: مقابلة شخصية بمقر مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطبنة يوم 1 جوان 2009.
أبو القاسم سعد الله: أفكار جامحة، م.و.ك، الجزائر 1988، ص 100.(1)
مصطفى الأشرف:ا لجزائر الأمة والمجتمع، تر حنفي بن عيسى، م.و.ك ،الجزائر 1983، 243.(2)
عبد الكريم بوصفصاف: الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية في حركتي محمد عبده وعبد الحميد بن باديس ، ج1، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة تونس ، السنة الجامعية 1996-1997،ص 229. (1)
عبد الرحمن شيبان: مقابلة شخصية ، مقر جمعية العلماء بالجزائر العاصمة، يوم 4 أفريل 2005(2)
أبو القاسم سعد الله:الحركة الوطنية الجزائرية،ج1،ط4،دار الغرب الإسلامي بيروت 1992،ص 224.(3)
أبو القاسم سعد الله:الحركة الوطنية الجزائرية،ج2،ط4،دار الغرب الإسلامي بيروت 1992،ص 442. (1)
عبد الكريم بوصفصاف:جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتها بالحركات الجزائرية الأخرى 1931-1945،رسالة ماجستير قسنطينة1983، ص99.(2)
محمد الطيب العلوي : مظاهر المقاومة الجزائرية من عام 1830 حتى ثورة نوفمبر 1954، ط1،دار البعث قسنطينة 1985، ص115.(3)
(4) Mahfoud kaddache : histoire du nationalisme Algérienne, 1919-1951,t 2,S.N.E.D ,Alger,p338.
رابح تركي: جمعية العلماء المسلمين ال تاريخية1931-1956ن ط1، م.و.ف.م،2004، ص 99.(5)
عمار مطاطلة: مقابلة شخصية بمنزله بالأبيار الجزائر العاصمة، يوم 12 نوفمبر 2008.(1)
عبد الحق بن باديس: مقابلة شخصية بمقر مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطبنة يوم 1 جوان 2009.(2)
مصطفى بوغابة: مقابلة شخصية:بمنزله بقسنطينة، يوم 25 ماي 2009 .(3)
محمد الصالح رمضان : مقابلة شخصية بمنزله بالقبة ، الجزائر العاصمة يوم 21 جوان 2005.(1)
رابح تركي:الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر ، ط5،م.و.ك، الجزائر2001،ص399 .(2)
سليمان الصيد : نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار، ط1،الجزائر 1994، ص1. (4)
عبد الحميد بن باديس: "بواعثنا، عملنا ،خطتنا، غايتنا"، جريدة السنة المحمدية،العدد: 1 ، 1933، ص1.(1)
عمار الطالبي: ابن باديس حياته وآثاره، ج1، ص 87.(2)
محمد خير الدين: مذكرات، ج2، مؤسسة الضحى، الجزائر 2002، ص 92.(3)
جهود عروج وخير الدين بربروسا في إنقاذ الموريسكيين
910-953ه/1504-1546م
د. ناديـــــــة فتيسي
قســــــم: التاريــــخ قسنطينة
ملخص:
عرفت الدراسات الموريسكية في الفترة الأخيرة اهتماما واسعا في أوربا وخاصة بإسبانيا لبعث تلك الحقبة المفقودة من تاريخها التي حاولت طمسها لفترة طويلة، وفي الجزائر مازالت تلك الدراسات محدودة ومتأخرة عن باقي الدول العربية لتفرق ارشيفها في مختلف دول العالم، وتتناول هذه الدراسة لمحة عن مأساة الموريسكيين إثر سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين بإسبانيا سنة 1492م واستنجادهم بملوك المغرب والمشرق لترحيلهم إلى أرض الإسلام للعيش بأمان وكرامة ، بيّد أنهم لم يجدوا مساندة فعلية منهم نظرا للضعف الكبير الذي كانت عليه بلاد المغرب وبعد مقر الدولة العثمانية عنهم وانشغالها بالحروب في شرق أوربا. وكان وصول عروخ وخير الدين إلى سواحل تونس والجزائر مفتاح النجاة للآلاف منهم وكذلك للمسلمين في بلاد المغرب وقد سجلت المصادر المحلية والأجنبية بعض الجهود التي بذلها لنجدة المسلمين من قبضة الاسبان.
مقدمــــــة:
يرجع موضوع الموريسكيين[1] إلى القرن السادس والسابع عشر ميلادي وهو موضوع حي لا يموت لأنه مأساة إنسانية يذكرنا بمأساة الفلسطينيين في القرن العشرين القرن الحالي، ومآسي الآلاف من المسلمين الذين أجبرهم الاضطهاد العنصري والتعصب الديني على هجرة أوطانهم والتشرد كما حدث للجزائريين على إثر الاحتلال الفرنسي وحدث أيضا لمسلمي البوسنة والشيشان وأفغانستان والعراق وسوريا مؤخرا، وكأنهم يعيشون عصر محاكم التفتيش التي لاحقت الموريسكيين حينما أخفوا إسلامهم وأظهروا الكفر حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم، لكن الكثير هربوا من جحيمها وقرروا الهجرة من أرض آبائهم وأجدادهم إلى أرض الإسلام للحفاظ على أرواحهم والتمتع بالحياة الحرة الكريمة.
وكانت الدراسات حول الموريسكيين في إسبانيا مهملة بشكل يكاد يكون كاملا، لكنها عرفت في الفترة المعاصرة صحوة ثقافية وعلمية، حيث عمل مئات الباحثين والأكاديميين وعلماء الآثار الإسبانيين والأوروبيين لبعث تلك الحلقة المفقودة في التاريخ الإسباني والإسلامي إلى الحياة، من خلال البحث والدراسة والنقد والتحليل، حتى فاقت اليوم 1000 دراسة أكاديمية رصينة حول الأندلس، في طليعتها “تاريخ غرناطة” للباحث ميغيل لافوينتي ألكنترا، و”تاريخ مالقة” لـ”كيين روبليس” و”إسبانيا المسلمة في عهد النصرانيين” للباحثة الفرنسية “راشيل أريي”، علاوة على أعمال “لويس فرنانديث” و”خوان طوريس فوينتيس”، وإنتاجات “لويس سيكودي لوثينا باربديس” الذي كرس حياته في دراسة الأندلس، بالإضافة إلى الرسامين الإسبان الذي أرخوا لتلك الحقبة بلوحاتهم الفنية، وعلى رأسهم الرسامالكبير “دياغ ذا بالثكاث” الذي سطر ملاحم فنية في غاية التراجيديا، تؤرخ لتلك الحقبة الفاجعة بطلب من الملك خوان كارلوس.[2]
أما الدراسات العربية فقد كانت حتى النصف الثاني من القرن العشرين نادرة ما عدا د. محمد عبد الله عنان الذي نشر منذ أكثر من ستين سنة كتابه الهام الموسوم ب: دولة الإسلام في الاندلس، العصر الرابع نهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين، مكتبة المهتدين الاسلامية المقارنة للأديان، القاهرة، 1949. وحتامله، محمد عبده، محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة، منشورات، المؤلف، بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، 1779. وقشتيليو، محمد، محنة الموريسكيين في إسبانيا، منشورات الشويش، تطوان، 1980، ود. الحجي عبد الرحمن علي، محاكم التفتيش الغاشمةوأساليبها، منشورات مكتبة المنار الاسلامية، الكريت، 1987، رزوق محمد، الاندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، الرباط، 1989.
ولاشك أن هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأندلس بعد سقوط غرناطة إلى غاية الترحيل النهائي للموريسكيين (1492-1609م) لم تجلب اهتمام هؤلاء المؤرخين إذا قيس ذلك بالفترة الأندلسية خلال العصور الوسطى ذات الإشعاع الحضاري، وهو الأمر الذي دفع عددا من الكتّاب والمؤرخين والمتعاطفين للموضوع الموريسكي إلى الاهتمام بهذه الفترة الزمنية والكتابة حولها، وقد كانت مؤسسة عبد الجليل التميمي رائدة في نشر وترجمة البحوث حول الدراسات الموريسكية ذات القيمة العلمية سواء كانت عربية أو أجنبية؛ وقد نشرت حوالي 600 دراسة تمت أساسا بالإسبانية ثم الفرنسية والعربية والانجليزية وهو رصيد هام انجز في الفترة الممتدة من 1983-2009، كما نشرت عملا توثيقيا لأول مرة بعنوان: "البيبليوغرافيا العامة للدراسات الموريسكية سنة 1994م"، وحصر فيه 3577 عنوانا بين مرجع ومصدر وهي وسيلة عمل لا غنى عنها لأي باحث في هذا التخصص من الدراسات[3].
وفي الجزائر الوثائق المتعلقة بالجالية الأندلسية في سجلات المحاكم الشرعية تبقى محدودة والموجود منها موزعا عبر مختلف أرشيفات دول البحر الأبيض المتوسط بإسطنبول جعلت الدراسات الموريسكية الأندلسية تتأخر عن زميلتها بتونس والمغرب الأقصى.[4]
سنتناول في هذا الموضوع شقا فقط من تاريخ الموريسكيين حيث سنحاول الكشف عن سياق تهجيرهم في عهد الأخوين عروج وخير الدين، وليس غرضنا من هذه الدراسة أن نكرر الإدانة لمن ارتكبوا الأخطاء في حق شعب أعزل ومحاصر بين المتعصبين الإسبان وإنما غرضنا هنا توضيح بعض جهود الذين أحسنوا لذلك الشعب وأنقذوه من التعذيب والحرق بالنار ولو بعد مئات السنيين، ذلك أن أعمالهم تدل على مدى نبلهم وتقدمهم وسمو أخلاقهم.
والإشكالية المطروحة هي: ما صدى الجهود التي بذلها الأخوين عروج وخير الدين في المصادر الأدبية العربية والأجنبية؟ وهل قدموا فعلا ما يستحق الثناء والشكر عليه؟
وقبل الإجابة على الإشكالية المطروحة من المفيد أن نتعرف على الأخوين عروج وخير الدين بربروسا وكيف وصلا إلى الضفة الغربية من البحر الأبيض المتوسط.
أولا: نشأة عروج وخير الدين
والدهما هو يعقوب بن يوسف، كان جنديا محترفا في الجيش الإنكشاري المرابط في جزيرة مدللي[5] بعد فتحها من قبل العثمانيين سنة 1457م، تزوج فتاة من سكان تلك الجزيرة وانجبت له أربعة ابناء وهم بالترتيب: إسحاق، عروج، خير الدين، إلياس[6]، وقد أنشاهم والدهم على الدين الإسلامي وركوب البحر.
اشتغل الأولاد الأربعة بالتجارة؛ فإسحاق عمل في جزيرة مدللي وعمل عروج وإلياس بالسفن التجارية، وكانا يسافران إلى طرابلس، الشام والإسكندرية، أما خير الدين فكان يسافر إلى سلانيك لممارسة التجارة هناك فتحسنت أحوالهم المعيشية، وخلال إحدى رحلاته أسر عروج وسجن بجزيرة ردوس وحاول خير الدين افتداءه فلم يفلح، وخلص نفسه بفضل ذكائه وشجاعته، ثم سافر إلى أنطاليا ودخل في خدمة الشيخ زادة قرقود واليها وهي جزيرة باليونان تابعة للدولة العثمانية، وبعد ذلك انتقل إلى مصر أين قضى بها فصل الشتاء[7]، ومن هناك أستقر به المقام في جزيرة جربة عام 1500م غرب البحر المتوسط التابعة للحفصيين حكام تونس مقابل دفع خمس الغنائم والتحق به خير الدين سنة 1504م. وانتقلا معا إلى ميناء حلق الوادي[8].
ومن جربة وحلق الوادي ضاع صيت الأخوين كأكبر بحارة في حوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط يحاربون المسيحين ويدافعون عن المسلمين وينقلون الموريسكيين من إسبانيا إلى بلاد المغرب فكيف تمكنوا من تحقيق تلك الشهرة؟
ثانيا: جهود عروج وخير الدين في انقاذ الموريسكيين(1504- 1518م)
بعد أن استقر المقام بعروج وخير الدين في جزيرة جربة اشتغلا في ملاحقة سفن المسحيين في البحر وأحرزا عليهم انتصارات كبيرة وغنما أموالا معتبرة؛ فرقوا منها الكثير على فقراء تونس، فانتشرت شهرتهما كأكبر رياس البحر في الحوض الغربي للبحر المتوسط، وخاصة بعد المعركة البحرية الكبيرة التي وقعت بينهما وبين قطعة بحرية إسبانية استعمل فيها المدافع والبنادق النارية والسهام دامت من الصباح إلى المساء وأبدى فيها خير الدين شجاعة وبأسا كبيرين وأسر بارجة كبيرة مع من بقي فيها حيا وغنم بضائعها، وما إن دخلا بتلك الغنائم على أهل تونس حتى اهتزوا له مع سلطانهم[9].
ذلك أن بلاد المغرب في ذلك الوقت كانت تعاني من التمزق والتناحر وسيطرة الاسبان على سواحلها وخاصة المغرب الأوسط الذي كان عبارة عن فسيفساء سياسية متنوعة، حيث كانت سلطة الحفصيين في الشرق وملوك عبد الواد الزيانين لا تتجاوز مدينة تلمسان في الغرب وممالك متفرقة في الوسط والجنوب، وأمام هذا الضعف استولى الإسبان على أهم محطاته الساحلية حيث احتل أحسن مرفأ على الساحل الجزائري عام 1504م وهو المرسى الكبير، ثم مدينة وهران سنة 1509م ، واستولوا على بجاية في 1510 وعرضت على التوالي تنس ودلس وشرشال ومستغانم دفع اتاوة سنة 1511م، وحافظ سليم التومي أمير مدينة جزائر بني مزغنة على ملكه مقابل دفع جزية كبيرة وتسليم أحدى الجزر الصغيرة إلى "بيدرو نافارو" الواقعة قبالة مرساها فأقام عليها حصنا أصبح شوكة في حلق مدينة الجزائر يراقب سكانها وسفنها، كما حولوا المراسي المحتلة إلى مراكز محصنة ذات جدران عظيمة تقيم فيها الحاميات[10]، لكنهم لم يتوغلوا إلى الداخلربما لانشغالهم باكتشاف العالم الجديد.
كان هذا التفكك والتراجع لبلاد المغرب مشجعا للاحتلال من طرف الإسبان، الذي أيقن أن قوته تكمن في الاتحاد بين مملكتي آرغون وقشتالة، وقد تحقق له ذلك بفضل عقد زواج الأمير فرديناند الأرغوني من إيزابيلا القشتالية سنة 874ه/1469م وعرف بالملكين الكاثوليكيين[11]، لولائهما الكبير للكنيسة الكاثوليكية. وتمكنا سوية من القضاء على الوجود الإسلامي بإسبانيا وكان آخر معاقلها مملكة غرناطة التي استسلم أميرها أبو عبد الله محمد بن علي في 2 ربيع الأول 897ه الموافق ل 2 جانفي 1492م، وقبل الاستسلام أبرم معاهدة بينه وبين ملكي قشتالة وأرغون في 21 محرم 897ه/ 25 جانفي 1491م، تعهدا بموجبها الملكان لصالح مسلمي غرناطة بضمان حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وأن لا يولي على المسلمين أحد إلا منهم وحرية بقاءهم أو مغادرتهم الأندلس، والتزما الملكان أيضا بتنفيذ شروط المعاهدة جميعها دون أي تعديل أو تحريف مهما كانت الأسباب في حياتهما وفي حياة خلفائهم، ووقع عليها البابا في روما[12].
بيّد أن نشوة النصر إثر سقوط غرناطة دفعت بالإسبان إلى نقض شروط معاهدة الاستسلام شرطا شرطا وإصدار قرارا لتنصير المسلمين قسرا سنة 904ه/ 1499م، وتنصيب محاكم التفتيش في غرناطة عام 905ه/1499م وهو ما أدى إلى نتائج وخيمة على الموريكسيين فزالت حرمتهم وأدركهم الذل والهوان وأكرهم الإسبان على اعتناق المسيحية[13]. وكانت تهدف السياسة الإسبانية المتعصبة اتجاه الموريسكيين بنقضهالشروط المعاهدة إلى دفع المسلمين للثورة والتمرد ومن ثمة تتيح لها الفرصة للقضاء عليهم وتستولي على ممتلكاتهم وتتخلص من آثارهم نهائيا، وهذا ما تجلى في حرق الآلاف من المخطوطات العربية الإسلامية وتحويل المساجد إلى كنائس[14]. وبالتالي ضاع جزء كبيرا من تراث الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس.
كانت سياسة إسبانيا لا تعرف الرحمة من أجل تصفية المسلمين وتنصيرهم بالجملة وهو العامل البارز في اشعال نار الانتفاضة في حي البيازيين عام (1499-1501م) بغرناطة، وقد أبيد من أجل القضاء عليها قرى كاملة بسكانها قتل فيها آلاف المسلمين وشارك الملك فرديناند بنفسه في إخمادها. وعلى إثرها أصدر الملكان الكاثوليكيان مرسوما في سنة 908ه/ 12 فيفري 1502م يقضي بتخيير الموريسكيين بين التنصير أو ترحيلهم إلى شمال إفريقيا فمنهم من لجأ إلى الجبال واحتمى بها،[15] ومنهم من هاجر إلى مناطق مختلفة وكانت أعدادهم بالآلاف وعن تلك الهجرات يقول المقري[16]: " فخرجت ألوف الى فاس وألوف، وألوف أخر بتلمسان من وهران وجمهورهم خرج إلى تونس...وكذلك بتطاوين وسلا والجزائر...، وصلت جماعة إلى القسطنطينية العظمى وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام". ورضخ الباقي لقرار التنصير مرغما وخضعوا لمراقبة محاكم التفتيش لتحقق في صحة اعتناقهم للدين الجديد.
ونتيجة لضعف قوة الموريسكيين وانحصارهم في مناطق معزولة تكررت دعواتهم ووفودهم ورسائلهم إلى ملوك المسلمين في المشرق والمغرب لتخليصهم مما يعانونه، ومنهم السلطان العثماني حاكم الإمبراطورية العثمانية التي برزت خلال القرن السادس عشر كأقوى دولة في العالم مترامية الأطراف في القارات الثلاث ورفعت شعار حماية الإسلام والمسلمين في كل مكان، وكانت المنافسة بينها وبين الإمبراطورية الإسبانية على أشدها في مياه البحر الأبيض المتوسط[17]، وعلى سواحل شمال إفريقيا ولا عجب أن يستغيث بها مسلمي الأندلس، بعدما استحال على بلاد المغرب نجدتهم لما كانت عليه من ضعف وهوان كما أن هاته البلدان نفسها لم تكن بمنأى عن الخطر الإسباني والبرتغالي الذي سيطر على أهم سواحلها منذ نهاية القرن الخامس عشر.
وقد اتجهت أنظار مسلمي الأندلس إلى سلاطين الدولة العثمانية على إثر فتح القسطنطينية سنة 1453م في عهد محمد الفاتح(1429-1480م)، فأرسلوا سفارة إلى إسطنبول في منتصف سنة 1477م وناشدوه للتدخل لإنقاذهم غير أن انشغاله بالدفاع عن دولته من خطر التحالف المسيحي ضده منعه من التدخل، كما أرسلوا سفارة إلى سلطان مصر الملك الأشرف في أواخر القرن الخامس عشر، مستنجدة إياه في التدخل لإنقاذهم من ملوك إسبانيا، فأرسل وفود إلى البابا بروما وإلى ملوك أوربا يذكرهم بأن النصارى الذين هم تحت حمايته يتمتعون بكل الحريات بينما أن مسلمي الأندلس يعانون أشد أنواع الظلم، وهدد باستعمال سياسة القصاص تجاه رعاياه المسحيين إذ لم يكف ملك قشتالة وأرغون وغرناطة عن هذا الاعتداء وتهجير المسلمين عن بلادهم وعدم التعرض لهم وردّ ما أخذ من أراضيهم.[18] ولكنه لم يجد آذان صاغية لوفوده وتهديداته واستمر الاسبان في سياستهم المتعصبة ضد الموريسكيين.
ومرة أخرى استصرخ مسلمي الأندلس بالسلطان بايزيد الثاني (1480-1511م) وأرسلوا إليه رسالة في شكل قصيدة مطولة بالعربية سنة 1478م جسدت معاناتهم من الظلم والاضطهاد الاسباني وختم الشاعر قصيدته بتجديد الاستغاثة بالدولة العثمانية والرجاء لإنقاذهم وإجلائهم من البلاد.[19] فتمّ الاتفاق بين السلطان بايزيد الثاني وملك مصر على أن يرسل الأول أسطولا بحريا لمواجهة سواحل صقلية لكونها تابعة لمملكة إسبانيا، وأن يرسل ملك مصر جيشا من جهة شمال إفريقيا، تأخر السلطان العثماني لكنه في الأخير أرسل أسطولا بحريا بقيادة كمال ريس أغار على سواحل إسبانيا بعد سقوط غرناطة، فكان أول من قام بإجلاء عدد كبير من مسلمي ويهود الأندلس وتوطينهم في الأناضول[20]. وعليه قرر الملكان الكاثوليكيان حراسة كل السواحل الجنوبية لقطع الامدادات عن غرناطة[21]. وواصل الإسبان حربهم ضد المسلمين وصبوا عليهم جم غضبهم وحقدهم الدفين.
في هذا الوقت كان البحر الأبيض المتوسط مسرحا لانتصارات مدوية أحرزها عروج وخير الدين بربروسا في غارته على سفن وشواطئ إسبانية وجنوة وفرنسا وسردينا ومايورقة ومينورقة وصقلية، وصارا اسمهما كالأسطورة، يكفي ذكر "بربروسا" لتستلم أقوى السفن[22]. ولا شك أن الموريسكيين قد طلب مساعدتهما قصد نقلهم إلى بلاد المغرب، وحسب شارل "أندري جوليان" فإن السلطان الحفصي أعطى لعروج جزيرة جربة للإقامة فيها بعد أن ضاع صيته على إثر إنقاذه للآلاف من الموريسكيين وحملهم إلى الجزائر وتونس[23].
وتذكر المصادر أنه خلال سنة 1513 م أبحر عروج مع أخيه خير الدين بأسطولهما الصغير المتكون من ثمانية سفن وجنودهما (300-400 جندي) إلى سواحل الأندلس لنجدة الموريسكيين، ولا تذكر العدد المهجر بالتدقيق وتكتفي بالقول أنه تم "نقل عدد كبير من المسلمين " إلى الجزائر وتونس[24]، وهناك من المؤرخين من يذكر أنهم كانوا يزيدون عن عشرة آلاف موريسكي[25].
هكذا كان انقاذ عروج للموريسكيين ونقلهم إلى بر الأمان بالجزائر وتونس، وغاراته على السفن المسيحية والإسبانية بصفة خاصة سببا في شهرته والاستنجاد به في المغرب الأوسط والأندلس، ذلك لأنه حقق للسكان والموريسكيين ما عجزوا بمعية حكامهم عن تحقيقه وهو ضرب الإسبان ونجدة مسلمي الأندلس من الاضطهاد.
وعلى إثر استغاثة سكان بجاية بعروج حاول فتحها وطرد الاسبان منه إلا أنه فشل مرتين؛ الأولى سنة 1512 والثانية سنة 1515م لضعف سلاح مدفعيته أمام تحصيناتهم القوية، لكنه تمكن من تخليص جيجل من قبضة الجنويين عام 1514م بإعانة سكانها والقبائل المجاورة واستقر بها، وخلال نفس السنة طلب مساعدته سليم التومي أمير مدينة جزائر بني مزغنة لتخليصه من الإسبان وخاصة من حصن "البينون" الذي كان يراقب ميناء المدينة، ومن الإتاوة التي كانوا يدفعونها لهم[26]. لم يتأخر عروج وخرج مع جيشه وسفنه إلى مدينة الجزائر واستقبله السكان استقبال الفاتحين. توقف في المدينة عدة أيام ثم سار إلى شرشال التي أغلب سكانها من الموريسكيين[27] المعروفين بشجاعتهم، فحررها من الاسبان وجنّد منهم حسب "دوهايدو"، 500 جندي مسلحين كلهم تقريبا بالبنادق(Mousquets)[28]. وقد شاركوا معه ومع خير الدين من بعده في جميع المعارك ضد الاسبان أو الامراء الموالين لهم ومكنهم من الأخذ بثأرهم.
وعلى إثر عودة عروج إلى مدينة الجزائر حاول تحطيم حصن البينون بمعية القوات الموريسكية، ولنا أن نتصور الحماس والقوة اللّذان كان يعمل به هؤلاء الموريسكيين لتحطيم الحصن والقبض على حراسه الاسبان لكن ضعف مدفعته حال دون ذلك.
وعلى أية حال فقد نصبوا عروج حاكما لمدينة الجزائر، فشرع في تنظيم أمورها؛ فصك العملة باسمه وفرض الضرائب، ودعم التسليح وأضاف أعمال جديدة إلى القصبة ورتب لها حامية من رجاله المخلصين العثمانيين والعرب ونجح في فرض النظام والأمن في مدينة الجزائر وضواحيها[29].
اعتبرت الحكومة الإسبانية النجاح الذي حققه عروج في مدينة الجزائر بإقامة دولة وتحصينها خطرا يهددها، لأن هذه المدينة ستصبح وكرا لأكبر قراصنة البحر المتوسط وأعوانه يهددون أساطيلها في البحر المتوسط وسواحلها،[30] ويساعدون الموريسكيين في تهجيرهم وتحويلهم إلى محاربين ضدها إلى جانب آل بربروسا، لذلك لم يتأخر الكاردينال خمينيس (Cinseros Ximénés) الذي تولى حكم إسبانيا مؤقتا بعد وفاة الملك فرديناند سنة 1516 في تنظيم حملة عسكرية بحرية للقضاء على حكم الإخوة بربروسا وطردهم من الجزائر وكان قوامها 35 سفينة حربية تحمل أكثر من ثلاثة آلاف رجل تحت قيادة "ديقو ديفيرا" (Diego de Vera) أرست بميناء الجزائر في 30 سبتمبر 1516م، بيد أن عروج قد هزمهم مع جيشه وسكان المدينة هزيمة تامة لم ينجوا منهم أحد وحطمت العاصفة معظم أسطولهم، وعلى إثر هذا الانتصار أخذ عروج يوسع في ملكه، حيث استعان بأخيه خير الدين لفتح الجهة الشرقية من البلاد، وسار هو باتجاه الغرب إلى أن بلغ المدية ومليانة وكامل بلاد القبائل وتنس[31]. ومن هناك اتصل به وفد من تلمسان وطلبوا منه نجدتهم ضد حاكمها أبو حمو الزياني المتحالف مع الإسبان. هاجم عروج تلمسان وهزم أبو حمو ودخل مدينة تلمسان وقضى على بقية بني زيان[32]، وعلى إثر طرده توجه أبو حمو فورا إلى وهران وقطع البحر إلى إسبانيا قاصدا الإمبراطور شارل الخامس (1519-1556م) متوسلا إليه أن ينجده ويعينه على سكان تلمسان وعروج، فلبى دعوته وأرسل معه جيشا قويا استطاع أبو حمو بواسطته أن يرجع إلى مملكته ويقتل عروج وعددا من اتباعه وكان ذلك سنة 1518م[33].
ثالثا: خير الدين يواصل جهوده في التضييق على الإسبان ونجدة الموريسكيين:
ما إن وصل خبر استشهاد عروج حتى قام الجنود ورياس البحر الأتراك بتعيين خير الدين حاكما على الجزائر[34]، وافق خير الدين على المنصب وقرر المضي في نفس الطريق الذي سار عليه عروج وهي التضييق على الإسبان في الجزائر وفي البحر الأبيض المتوسط[35]، ولتحقيق هذه الغاية قرر مع أعيان مدينة الجزائر ربطها بالدولة العثمانية باعتبارها في ذلك الوقت أكبر دولة إسلامية تتوجه نحو حماية المسلمين في كل مكان[36]، وافق السلطان سليم الأول على انضمام المغرب الأوسط إلى دولته وتمتين العلاقات السياسية والعسكرية بينهما، فمنحه رتبة "بيلرباي" الجزائر وأمده بقوات وأسلحة عسكرية[37] كان في أمس الحاجة إليها لمواجهة الخطر الاسباني المتربص به.
وحسب مذكرات خير الدين فإنه قام باستعدادات كبيرة خلال فصل الشتاء لمواجهة قوات شارل الخامس الذي لم يتأخر وأرسى بقواته في خليج مدينة الجزائر، وكان عدد الإسبان المشاركين في الحملة عشرين ألف جندي قضى خير الدين وأتباعه على أغلبهم وأسر منهم حوالي 700 إ اسباني[38]. وهكذا تغيرت موازين القوى واستطاع خير الدين وجيشه تمريغ أنوف الاسبان في تراب مدينة الجزائر بعدما كان سكانها يهابونهم ويدفعون لهم الإتاوة مقابل سلامتهم، ولكن المؤامرات الداخلية التي دبرها زعماء القبائل بمساعدة حكام تونس وفاس ضد خير الدين دفعته إلى الانسحاب إلى جيجل لمدة ثلاث سنوات تاركا حكم البلاد لابن القاضي تفاديا لحرب أهلية[39].
وخلال ثلاث سنوات التي قضاها بجيجل[40] لم يتخل خير الدين عن مسلمي الأندلس، فحسب مخطوط غزوات عروج وخير الدين فإنه كان يسافر باستمرار "وعلى عادته إلى بلاد الاندلس" وينقل منهم الأعداد الكثيرة إلى بلاد المسلمين ولا ندري هل يقصد بلاد المغرب أو سائر بلاد الإسلام، وجاء أيضا في ذات المصدر أن رياسه كانوا يقتدون به في نجدة الموريسكيين حيث استأذنه أحد رياسه للسفر إلى سواحل إسبانيا فإذن له ورجع بعدد كبير منهم "جملة واسعة من أهل الاندلس المسلمين" [41].
وبعد أن رجع خير الدين إلى مدينة الجزائر سنة 1525م قام بتوحيد البلاد وتنظيمها والقضاء على كل معارضيه، ثم تفرغ لحصن البينون؛ فحاصره في 6 ماي 1529م وبدأت المدافع تطلق عليه النار واستمرت لمدة 25 يوم، دون توقف إلى أن هدمت أسواره وقتلت حاميته، وبدون انتظار أعطى خير الدين أوامره لتهديم الحصن وأنشأ بحطامه رصيف طويل شكل ميناء تحتمي إليه السفن. وبهذا الانجاز تخلصت مدينة الجزائر نهائيا من مراقبة الإسبان.
كان نبأ انتشار تلك الانتصارات التي أحرزها خير الدين في إسبانيا عاملا محفزا لإعلان الثورة من قبل الموريسكيين على الاسبان حيث نزل ثمانون ألفا من الذين كانوا معتصمون بالجبال وهاجموا الإسبان وألحقوا بهم هزائم معتبرة، وما كادت أخبار ثورة الموريسكيين تصل إلى الجزائر حتى أمر خير الدين أحد رياسه بالخروج على رأس أسطول مكون من 36 سفينة لنصرة الثوار، وبالجملة فإن أسطول خير الدين إلى غاية سنة 1529م قام بواحد وعشرين حملة على الأندلس في كل منها كان يخلص آلاف الموريسكيين رجالا ونساء وأطفالا وينقلهم إلى سواحل شمال إفريقيا، كما أن السلطان سليمان القانوني كان يحث خير الدين على مساعدتهم عبر رسائل عديدة وصلت إليه[42].
ولا نتصور أن عمليات إنقاذ الموريسكيين التي قام بها خير الدين ورجاله كانت تتم بسهولة، بل على العكس من ذلك؛ فقد كانت تتلقى من القوات الإسبانية المكلفة بحراسة الشواطئ الجنوبية مقاومة شرسة، وحسب "دوهايدو" فإن خير الدين ورياسه قد أظهروا شجاعة وإقدام كبيرين لنجدتهم ونقلهم إلى سواحل إفريقيا بأمان.[43]
وخلال سنة 1533م، جدد الموريسكيون ثورتهم ضد الاسبان وتحركوا للدفاع عن دينهم وتسلحوا وأخذوا معم نساءهم وأطفالهم وتحصنوا بجبل بالأندلس يسمى باردونا Pardona فحاصرهم المسيحيين وبعد معارك كثيرة أجبرهم الجوع ونقص الذخيرة على العودة إلى مدنهم وقراهم التي تركوها وبسبب تلك الظروف القاسية التي باتوا يعانون منها أرسلوا إلى خير الدين رسالة وشرحوا له أحوالهم، وفي الحال قرر تسليح 36 سفينة بالمدفعية والجنود، لإنقاذ المورسكين وبعد معارك كبيرة مع السفن الإسبانية انتصر الجزائريون، ورجعوا إلى الموريسكيين ونقلوهم مع نساءهم وأطفالهم وممتلكاتهم، وكان من المستحيل على تلك السفن أن تنقل الجميع في رحلة واحدة لأنهم كانوا بإعداد كبيرة ، فاتفقوا معهم أن يتحصنوا بجبل باردونا وتركوا لحراستهم فرقة من ألف جندي إلى غاية عودة المسلمين لترحيلهم جميعهم. وكان على هذا الأسطول أن يقوم بسبع رحلات متتالية نقلت إلى سواحل الجزائر سبعين ألف شخص[44].
هذه الجهود التي بذلها خير الدين ورجاله لتخليص الموريسكيين ونقلهم إلى بر الأمان بقوة السلاح رصدتها لنا بعض المصادر وغيرها التي ماتزال في دور الأرشيف وتحتاج لجهود الباحثين للكشف عنها خاصة في الأرشيف العثماني الذي يكتسي أهمية بمكان في كتابة التفاصيل المهمة في تاريخ العلاقات بين الجزائر والدولة العثمانية في إطار الصراع الدائر مع إسبانيا ومأساة الموريسكيين. وتوضح لنا النصوص التاريخية الأسباب التي جعلت الموريسكيين يكتبون رسالة إلى السلطان العثماني سنة 1541 ويطلبون منه إعادة خير الدين دون غيره إلى الجزائر لإنقاذهم من محنتهم بعد أن انتقل إلى اسطنبول سنة 1535م، ويثنون عليه كل الثناء حيث قالوا عنه: المجاهد في سبيل الله خير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين[45].
وتشير المصادر أن خير الدين ورياس البحر الجزائريين قد تعهدوا بالسفر إلى سواحل الأندلس ونجدة العائلات الموريسكية ونقلها إلى سواحل إفريقيا[46]. وجعلوها قانونا يلتزمون به هم وخلفائهم. هذا، وقد استمرت غارات رياس البحر الجزائريين على طول السواحل الاسبانية أكثر من مائة سنة، أي منذ سقوط غرناطة الى غاية الترحيل النهائي للمورسكيين 1609م، وقدر عددها ما بين 1528-1584م ب 33 غارة، سببت خسائر معتبرة للإسبان، وأنقذ فيها الآلاف من الموريسكيين الذين قدموا معلومات دقيقة ساعدت رياس البحر في نجدتهم وترحليهم عن المنطقة. وقد تمكن خلفاء خير الدين من انقاذ الاعداد التالية[47]:
تمكن الريس درغوث في سنة 1559 من ترحيل 2500 موريسكي، وفي سنة 1570 نقل جميع مسلمي بلمير (Palmire) وفي سنة 1574م، نقل أسطول جزائري 2300 موريسكي، وفي سنة 1575م نقل اسطول جزائري جميع سكان كالوسا، (Calosa)، وهذا الترحيل للموريسكيين اعتبره الاسبان إهانة لإسبانيا وتخريب لاقتصادها لأنه يفقدها العمال والحفريين.
الخاتمة:
من خلال ما تقدم يمكننا أن نستخلص النتائج التالية:
- كان تفكك بلاد الأندلس والمغرب إلى إمارات صغيرة متناحرة سببا في ضعفها وتسلط إسبانية عليها التي سعت في المقابل إلى وحدتها ومن ثمة قضت على غرناطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس سنة 1492م ولاحقتهم إلى سواحل المغرب.
- بروز الإمبراطورية العثمانية مع نهاية القرن الخامس عشر كأكبر دولة إسلامية في العالم تتوجه لحماية المسلمين في كل مكان لم يستفد منه الموريسكيون كثيرا بسبب بعد المسافة وانشغالها بالفتوحات على الجبهة الشرقية، وحروبها المستمرة.
- إنّ روح التسامح التي أبداها العثمانيون مع الشعوب الأوربية المغلوبة كانت روحا مثاليا حيث تركوا لهم حرية العبادة والمعتقد ولم يجبروا أحدا على ترك دينه، وهذا خلافا لما فعله الإسبان مع الموريسكيين حيث أجبروهم على التنصير وأقاموا لهم محاكم التفتيش التي أدت إلى حد القتل والحرق بالنار ومصادرة الممتلكات وتهجيرهم من أراضيهم وتذكرنا بما تفعله اليوم اسرائيل بالفلسطينيين.
- لعب عروج وخير الدين دورا بارزا في محاربة الإسبان وانقاذ الموريسكيين من الظلم والاضطهاد، حيث نقلوا إلى سواحل إفريقيا الآلاف منهم، وبعد استشهاد عروج واصل خير الدين مسيرته في التضييق على الإسبان في البحر الابيض المتوسط ونجدة الموريسكيين.
- مكّن عروج الموريسكيين ومن بعده خير الدين من الأخذ بثأرهم عندما ضمهم إلى جيشه في محاربة الإسبان والأمراء الموالين لهم.
- وضع عروج نواة الإيالة الجزائرية وأتمها خير الدين بعد أن ربطها بالدولة العثمانية وتحصل على دعمها السياسي والعسكري قصد التصدي للأخطار الداخلية والخارجية التي تترصده وخاصة خطر الإمبراطورية الاسبانية بقيادة شارل الخامس.
- كان هدف سليم الأول من ضم إيالة الجزائر إلى دولته هو الحصول على جبهة متقدمة للدفاع ضد الاسبان في الحوض الغربي للبحر المتوسط والتفوق عليه.
- لقد حقق خير الدين نجاحا كبيرا في الجزائر التي أصبحت حصنا منيعا يلتجئ اليه المهاجرون الاندلسيون بعدما ألزم رياس البحر الجزائريين ترحيلهم وجعله قانون دائم في دولته.
- كان خير الدين ورجاله رياس البحر عاملا بارزا في تحطيم الكثير من المشاريع الإسبانية في الأندلس والجزائر، إذ تمكنوا من إلحاق الهزائم بجيشه على أرض الجزائر وبسفنه في عرض البحر المتوسط وعلى سواحل بلاده، وأنقذوا الآلاف من الموريسكيين وأسكنوهم في قرى ومدن الجزائر، التي استفادت من خبراتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والعمرانية ومازالت بعض آثارهم واضحة في الحياة الجزائرية إلى غاية اليوم كالموسيقى الأندلسية وبعض الالفاظ والأطعمة والأقمشة وغيرها.
- ارتكب الاسبان جرائم بشعة في حق الحضارة والعلم باضطهاد الموريسكيين وحرق آثارهم وتشريد علمائها، ولم ينتبهوا وهم في غمرة الابتهاج بترحيل مسلمي الاندلس نهائيا من وطنهم أنهم أساءوا الى بلادهم إساءة كبيرة، لأن النفي ترك أثرا بالغا في النواحي الاقتصادية والسياسية والعلمية لأنهم كانوا من أفضل العناصر السكانية النشطة وأكثرهم إسهاما في خزينة الدولة لتطورهم في الزراعة واستئثارهم بالتفوق في العلوم والفنون والمهن، كما كانوا أبرع الاطباء والمهندسين والصناع والحرفيين، وبرحيلهم أغلقت الكثير من المصانع وهجرت الحقول وتعطلت نظم الري، وكثرت الغارات على الشواطئ الاسبانية نتيجة لتحول الكثير منهم الى مجاهدين في البحر[48] وزاد خطرهم أكثر بعد تأسيس خير الدين لإيالة الجزائر العثمانية وانضمامهم إلى رياسه.
- نجح عروج وخيرالدين في تحرير عدة مدن في الجزائر من الاحتلال وإفشال الحملات الحربية الاسبانيةعلى مدينة الجزائر سنة 1516و1519م والقضاء على الأمراء الموالين لهم ومنع الإتاوات والمعاملات الاقتصادية مع الاسبان في وهران بعد ضم تلمسان.
- استمرت الغارات البحرية التي كان يشنها رياس البحر الجزائريين على السواحل الإسبانية عنصرا يزعج الحكومة الاسبانية، وقد زاد عددها واشتد ضربها بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر، وكان هذا غريبا، ذلك لأن إسبانيا كانت يومئذ سيدة البحار وكانت أساطيلها الضخمة تجوب مياه الأطلنطي حتى بحر الشمال وجزر الهند الغربية وتسيطر على غرب البحر المتوسط، بيد أنها لم تستطع أن تقمع تلك الغارات الصغيرة المفاجئة يقوم بها رياس البحر الجزائريين وبمساعدة إخوانه الموريسكيون.
وفي الأخير يمكننا القول إن الجهود التي بذلها الاخوان بربروسا وخاصة خير الدين لإنقاذ الموريسكيين التي رصدتها لنا النصوص والوثائق التاريخية تستحق الشكر والثناء وكل التقدير من كل عاقل يؤمن بعدالة قضية الموريسكيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، كما أنهما يستحقا الشكر ولو بعد كل هذه السنوات من طرف كل شعوب شمال إفريقيا على التضحيات الجبارة التي بذلاها لتحرير بلدانهم من الاحتلال الاسباني والدفاع عنهم في الجزائر وتونس وطرابلس.
المصادر والمراجع:
- أولا: العربية
- أحمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج1، أعيد طبع الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، دون تاريخ.
- أحمد المقري التلمساني، نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب وذكر وزيره السان الدين ابن الخطيب، تحقيق وتعليق، مريم قاسم طويل، يوسف علي طويل، ج6، دار المعرفة الدولية، الجزائر، 2011.
- أحمد توفيق المدني، محمد بن عثمان باشا داي الجزائر 1756-1791، سيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة في عهده، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.
جمال يحياوي، سقوط غرناطة ومأساة الاندلسيين، تقديم، أبو القاسم سعد الله، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية، 2011.
- حتامله، محمد عبده، محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة، منشورات، المؤلف، بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، 1779.
- حسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، ترجمه من الفرنسية، محمد حجمي، محمد الاخضر، دار الغرب الاسلامي، ط2، لبنان، 1983.
- حنيفي هلال، الحضور الاندلسي بالجلال في العهد العثماني على ضوء سجلات المحاكم الشرعية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر،2016.
- شارل اندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية تونس الجزائر المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة 1830، ج2، تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة، ط2، الدار التونسية للنشر، تونس، 1983.
- عبد الجليل التميمي، تراجيديا طرد المورسكيين من الاندلس والمواقف الاسبانية والعربية منها، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، فيفري، 2011.
- عبد الجليل التميمي، رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة 1541م، المجلة التاريخية المغربية، عدد، 3، 1975، تونس.
- عبد الحميد بن أبي زيان بن اشنهو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، درا الجيش الشعبي، الجزائر ، 1972.
- عبد الواحد دانون، حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، المدار الإسلامي، ليبيا، 2004.
- عزيز سامح التر، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، ترجمة، محمود عامر، دار النهضة العربية، بيروت، 1989.
- فتحي زغروت، العثمانيون ومحاولات انقاذ مسلمي الاندلس (898-1115ه)/(1492-1609م)، الاندلس الجديدة، مصر، 2011.
- الفيكونت دو شاتوبريان، آخر بني سراج، ترجمة، شكيب أرسلان ومذيلة بخلاصة من تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة المنار، ط2، مصر، 1924.
- محمد رزوق، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرن السادس والسابع عشر، أفريقيا الشرق، ط4، الدار البيضاء، 2014.
- محمد عبد الله عنان، دولة الاسلام في الاندلس، العصر الرابع نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 1949.
- مذكرات خير الدين، ترجمة محمد دراج، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010
- مرمول كاربخال، إفريقيا، ج2، ترجمة، محمد حجي، محمد زينبر، محمد الأخضر وآخرون، الرباط: الجمعية المغربية للتأليف الترجمة، مطبعة المعارف الجديدة، 1408 -1409هـ/1988-1989م.
- مؤلف مجهول، غزوات عروج وخير الدين، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، رقم 1623.
- نبيل عبد الحي رضوان، جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداد ه في مطلع العصر الحديث، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1407هـ-1987م.
- هنري شارلي، العرب والمسلمون في الاندلس بعد سقوط غرناطة، ترجمة، حسن سعيد الكرمي، دار لبنان، بيروت، 1988.
- ثانيا: الفرنسية
- Don Diégo de Haedo, Histoire des rois d’Alger, 1612, Trad, H- D-DE Grammont, libraire- éditeur, Alger, 1881.
- H-D. De Grammont, Histoire d’Alger Sous La Domination Turque (1515-1830),éd. Ernest, Paris, 1887.
- Laugier de Tassy, Histoire de Royaume d’Alger, édition, Henry du Sauzet Amsterdam, 1725.
- Rozet et Carette, L’Algérie, éd., Firmin Didot Frères, Paris.1850.
- Sinan Chaouch, fondation de la régence d’Alger, histoire de frères Barbarousse, Arroudj et Kheir- edine, Tard. J.M.e verture de paradis, Tome I , édition, ANGÉ,PARIS.
المواقع الالكترونية:
خالد بن الشريف، هكذا طُرد الأندلسيون: القصة الكاملة لطرد أهل الأندلس من ديارهم، منذ 3سنوات، 13 أبريل 2015م،
https://www.sasapost.com/the-full-story-of-the-expulsion-of-the-people-of-andalusia
[1] الموريسكيون: هي التسمية التي أطلقها الإسبان على المسلمين المتبقين في شبه الجزيرة الإبيرية بعد سقوط غرناطة وأصبحت متداولة بين المؤرخين. جمال يحياوي، سقوط غرناطة ومأساة الاندلسيين، تقديم، أبو القاسم سعد الله، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية، 2011، ص. 17
[2]خالد بن الشريف،هكذا طُرد الأندلسيون: القصة الكاملة لطرد أهل الأندلس من ديارهم، منذ 3سنوات، 13 أبريل 2015م،
https://www.sasapost.com/the-full-story-of-the-expulsion-of-the-people-of-andalusia
[3] عبد الجليل التميمي، تراجيديا طرد المورسكيين من الاندلس والمواقف الاسبانية والعربية منها، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، فيفري، 2011، ص. 43
[4] حنيفي هلال، الحضور الاندلسي بالجلال في العهد العثماني على ضوء سجلات المحاكم الشرعية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 2016، ص.1
[5]جزيرة ميدللي: كانت تسمى قديما جزيرة ليسبوس وحاليا تسمى (Mitylène) الواقعة في بحر إيجا، عبد الحميد بن أبي زيان بن اشنهو، دخول الاتراك العثمانيين إلى الجزائر، درا الجيش الشعبي ، الجزائر ، 1972، ص. 38
[6] مؤلف مجهول، غزوات عروج و خير الدين، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، رقم 1623، ورقة رقم 1
[7] عزيز سامح التر، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، ترجمة، محمود عامر، دار النهضة العربية، بيروت، 1989. ص. 28
[8]Don Diégo de Haedo, Histoire des rois d’Alger, 1612, Trad, H- D-DE Grammont, libraire- éditeur, Alger, 1881, p. 51
[9] لمزيد من التفاصيل حول هذه المعركة البحرية بين عروج وخير الدين، ينظر: مخطوط غزوات عروج وخير الدين، المصدر السابق، روقة رقم 07-08
[10] شارل اندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية تونس الجزائر المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة 1830، ج2، تعريب محمد مزالي و البشير بن سلامة، ط2، الدار التونسية للنشر ، تونس، 1983، ص.321-324
[11] عبد الواحد دانون، حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة ، المدار الإسلامي ، ليبيا، 2004، ص.7-8
[12] أحمد المقري التلمساني، نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب وذكر وزيره السان الدين ابن الخطيب، تحقيق وتعليق، مريم قاسم طويل، يوسف علي طويل، ج6، دار المعرفة الدولية، الجزائر، 2011، ص.281-282
[13] كانت محاكم التفتيش تتابع وتعاقب المورسكيين بسبب ما يأتي: -الطهارة – الصلاة –صوم رمضان –الاحتفال بيوم الجمعة – عدم شرب الخمر واكل لحم الخنزير وقراءة الكتب العربية-ختان الأطفال. محمد رزوق، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرن السادس والسابع عشر، أفريقيا الشرق، ط4، الدار البيضاء، 2014، ص. 84
[14] نبيل عبد الحي رضوان، جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداد ه في مطلع العصر الحديث، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1407هـ-1987م، ص. 33
[15] عبد الواحد دانون، المرجع السابق، ص-ص. 31-35
[16] أحمد المقري التلمساني، المصدر السابق، ص. 282
[17] محمد عبد الله عنان، دولة الاسلام في الاندلس ، العصر الرابع نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 1949
[18] عبد الجليل التميمي، رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة 1541م، المجلة التاريخية المغربية، عدد رقم 3، سنة 1975، تونس، ص. 37-38
[19] أحمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج1، أعيد طبع الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، دون تاريخ، ص. 109-115
[20] مذكرات خير الدين، ترجمة محمد دراج، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010، ص.54
[21] شكيب ارسلان، خلاصة من تاريخ الاندلس، المرجع السابق، ص. 267
[22] عزيز سامح التر، المرجع السابق، ص. 47-50
[23] شارل اندري جوليان، المرجع السابق، ص. 326
[24] مذكرات خير الدين، المصدر السابق، ص.54
[25] عبد الحميد بن أبي زيان بن اشنهو، المرجع السابق، ص. 31
[26] حسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف افريقيا، ترجمه من الفرنسية، محمد حجمي، محمد الاخضر، دار الغرب الاسلامي، ط2، لبنان، 1983، ص.38-39
[27]وكان للمهاجرين في شرشال حوالي 5000 مسكن، والذين يكون نواتهم كل من الثغريين (Tagarinos)، والمدجنين (Mudéjares)، والأندلسيين، ينظر: مرمول كاربخال، إفريقيا، ترجمة، محمد حجي، محمد زينبر، محمد الأخضر و أخرون، الرباط: الجمعية المغربية للتأليف الترجمة، مطبعة المعارف الجديدة، 1408 -1409هـ/1988-1989م،ج2، ص. 357، 362.
[28]Don Diégo de Haedo, Op.cit., p. 26
[29]Rozet et Carette, L’Algérie, éd., Firmin Didot Frères, Paris.1850.p.430-431
[30] Idem, p.432
[31] H-D. De Grammont, Histoire d’Alger Sous La Domination Turque (1515-1830),éd. Ernest, Paris, 1887, p. 23
[32] أحمد توفيق المدني، محمد بن عثمان باشا داي الجزائر 1756- 1791، سيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة في عهده، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986، ص. 24
[33] وكانت قيمة الاتاوة التي فرضت عليه مقايل رجوعه إلى الملك 12000 مثقال من الذهب 12 فرسا و6 صقور إناث سنويا، ينظر: حسن بن محمد الوزان الفاسي، المصدر السابق، ص. 9-10
[34] Laugier de Tassy, Histoire de Royaume d’Alger, édition, Henry du Sauzet Amsterdam, 1725. p. 36
[35] مذكرات خير الدين المصدر السابق، ص. 93
[36] انظر الرسالة التي نشرها عبد الجليل التميمي في المجلة التاريخية المغربية، عدد، 6، 1976، تونس، ص. 117 وما بعدها
[37] فتحي زغروت، العثمانيون ومحاولات انقاذ مسلمي الاندلس (898-1115ه)/(1492-1609م)، الاندلس الجديدة، مصر، 2011، ص.59
[38] مذكرات خير الدين، المصدر السابق، ص. 94
[39]أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص. 26
[40] غزوات عروج وخير الدين، المصدر السابق، الورقة. 18
[41]غزوات عرو وخير الدين، المصدر السابق، الورقة. 16
[42] مذكرا ت خير الدين، المصدر السابق، ص. 159-160
[43] يقدم دوهايدو صفحات مشرقة من المقاومة التي ابداها خير الدين ورياسه ضد السفن الاسبانية من أجل انقاذ اخوانهم في الدين ونقلهم الى بر الامان، ينظر:
Don Diégo de Haedo, Op.cit., pp. 39-40
[44]Sinan Chaouch, fondation de la régence d’Alger, histoire de frères Barbarousse, Arroudj et Kheir- edine, Tard. J.M.e verture de paradis, Tome I, édition, J. ANGÉ, PARIS, 1837, pp . 281-283
[45] عثر على هذه الرسالة الاستاذ عبد الجليل التميمي، بأرشيف متحف طوب كابي باستانبول تحت رقم 3154 T.K.A.ونشرها في المجلة التاريخية المغربية، العدد، 3، المرجع السابق، ص. 43-46
[46]Sinan Chaouch,Op.cit., p.283
[47] هنري شارلي، العرب والمسلمون في الاندلس بعد سقوط غرناطة، ترجمة، حسن سعيد الكرمي، دار لبنان، بيروت، 1988، ص. 124-125
[48] حتامله، محمد عبده، محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة، منشورات، المؤلف، بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، 1779، ص. 120-121

 Français (France)
Français (France)